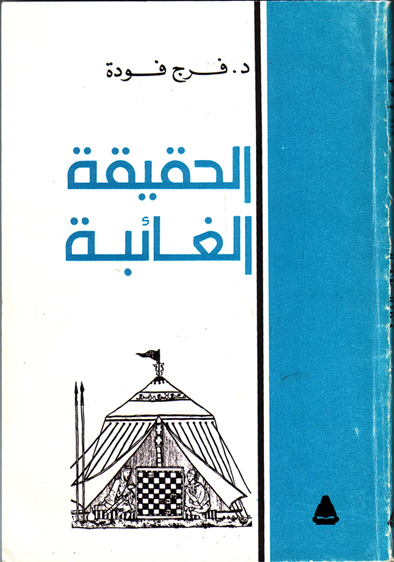الَحقيقة الغائبة لشهيد الكلمة الدكتور فرج فودة
مقدمة
Part One
هذا حديث سوف ينكره الكثيرون ، لأنهم يودون أن يسمعوا ما يحبون ، فالنفس تأنس لما تهواه ، وتتعشق ما استقرت عليه ، ويصعب عليها أن تستوعب غيره ، حتى لو تبينت أنه الحق ، أو توسمت أنه الحقيقة ، وأسوأ ما يحدث لقارئ هذا الحديث ، أن يبدأه ونفسه مسبقة بالعداء ، أو متوقعة للتجني ، وأسوأ منه موقف الرفض مع سبق الإصرار للتفكير واستعمال العقل . هذا حديث تاريخ لا يزعم صاحبه أنه متخصص فيه ، أو فارس في ميدانه ، لكنه يزعم أنه قارئ له في أناة ، محلل له في صبر موثق له في دقة ، ناقد له في منطق ، يهوى أنه يقلبه ذات اليمين وذات الشمال ، لا يستطيع أن يمد خياله متجاوزاً الحقيقة بالإضافة أو منتقصاً منها بالإهمال ، وما أكثر ما فعل ذلك من لهم تاريخ واسم ، وقلم وفكر ، ومنهج وبحث ، لا يجدون راحتهم إلا حيث يستريح القارئ ، ولا يراعون وهم يفعلون ذلك حرمة لتاريخ أو لعقل أو حتى لنقل . هذا حديث ما كان أغناني عنه ، لولا أنهم يتنادون بالخلافة ، ليس من منطلق الدعابة أو المهاترة أو الهزل ، بل من منطلق الجد والجدية والاعتقاد ، فسيتدرجون مثلى إلى الخوض فيما يعرف ويعرفون ، ويعلم وينكرون ، وينكر ويقبلون ، ليس من أجلهم ، ولا حتى من أجل أجيال الحاضر التي من واجبها أن تعرف وتتعرف ، وتعلم وتتعلم ، وتفكر وتتكلم ، بل قبل ذلك كله من أجل أجيال سوف تأتي في الغد ، وسوف تعرف لنا قدرنا وإن أنكرنا المنكرون وسوف تنصفنا وإن أداننا المدينون ، وسوف تذكر لنا أننا لم نجبن ولم نقصر ، وأننا بقدر ما أفزعنا بقدر ما دفعنا المجتمع للأمام ، وبقدر ما أقلقنا بقدر ما أستقر المجتمع في أيامهم ، وبقدر ما واجهنا بقدر ما توجهوا هم إلى المستقبل .
هذا حديث تاريخ وسياسة وفكر وليس حديث دين وإيمان وعقيدة ، وحديث مسلمين لا حديث إسلام ، وهو قبل ذلك حديث قارئ يعيش القرن العشرين وينتمي إليه عن أحداث بعضها يعود إلى الوراء ثلاثة عشر قرناً أو يزيد ، ومن هنا يبدو الحديث صعباً على من يعيشون وينتمون لواقع ما قبل ثلاثة عشر قرناً ، ويقيمون من خلال معايشتهم وتبنيهم لذلك الواقع أحداث حاضر القرن العشرين ، وهو في النهاية حديث قد يخطئ عن غير قصد ، وقد يصيب عن عمد ، و قد يؤرق عن تعمد ، وقد يفتح باباً أغلقناه كثيراً وهو حقائق التاريخ ، وقد يحيى عضواً أهملناه كثيراً وهو العقل ، وقد يستعمل أداة تجاهلناها كثيراً وهي المنطق ، وهو حديث في النهاية موجز أشد ما يكون الإيجاز ، لا يهتم بالحدث . في ذاته بقدر ما يعتني بدلالاته ويرى أنه بوفاة الرسول استكمل عهد الإسلام وبدأ عهد المسلمين ، وهو عهد قد يقترب من الإسلام كثيراً وقد يلتصق به ، وقد يبتعد عنه كثيراً وقد ينفر منه ، وهو في كل الأحوال والعهود ليس له من القداسة ما يمنع مفكراً من الاقتراب منه ، أو محللاً من تناول وقائعه ، وهو أيضاً وبالتأكيد ليس حجة على الإسلام ، وإنما حجة للمطالبين بالحكم بالإسلام أو حجة عليهم ، وسلاح في أيديهم أو في مواجهتهم ، وليس أبلغ من التاريخ حجة ، ومن الوقائع سنداً ، ومن الأحداث دليلاً ، وليس لهم من البداية أن ينكروا علينا ما رجعنا إليه من مصادر وما استندنا إليه من مراجع ، فهي ذات المراجع التي يحتجون بها على ما يرون أنه في صالحهم ، ومع دعواهم ، ولو أهملنا معاً هذه المراجع ، لما بقي من تاريخ الإسلام شئ ، ولما بقيت في أيديهم حجة ، ولما استقر في كتاباتهم دليل ، ولما وجدوا لمنطقهم سنداً أو أصلاً أو توثيقاً .
د . فرج فودة
هذا حديث قصدت فيه أن أكون واضحاً كل الوضوح ، صريحاً كل الصراحة ، زاعماً أن الوضوح والصراحة في الموضوع الذي أناقشه استثناء ، فقد صبت في المجرى روافد كثيرة ، منها رافد الخوف ، ومنها رافد المزايدة ، ومنها رافد التحسب لكل احتمال ، وخلف ذلك كله يلوح سد كبير ، يتمثل في الحكمة التي يطلقها المصريون ، والتي تدعو إلى ( سد ) كل باب يأتيك منه الريح ، فما بالك إذا أتاك إعصار التكفير ، وارتطمت بأذنك اتهامات ، أهونها أنك مشكك ، وأسئلة أيسرها – هل يصدر هذا من مسلم ؟ - وواجهتك قلوب عليها أقفالها ، وعقول استراحت لاجتهاد السلف ، ووجدت أن الرمي بالحجارة أهون من إعمال العقل بالبحث ، وأن القذف بالاتهام أيسر من إجهاد الذهن بالاجتهاد ..
هذا حديث دنيا وإن بدا لك في ظاهرة حديث دين ، وأمر سياسة وحكم و إن صوروه لك على أنه أمر عقيدة وإيمان ، وحديث شعارات تنطلي على البسطاء ، ويصدقها الأنقياء ، ويعتنقها الأتقياء ، ويتبعون في سبيلها من يدعون الورع (وهم الأذكياء) ، ومن يعلنون بلا مواربة أنهم أمراء ، ويستهدفون الحكم لا الآخرة ، والسلطة لا الجنة ، والدنيا لا الدين ، ويتعسفون في تفسير كلام الله عن غرض في النفوس ويتأولون الأحاديث على هواهم لمرض في القلوب ، ويهيمون في كل واد ، إن كان تكفيراً فأهلاً ، وإن كان تدميراً فسهلا ، ولا يثنيهم عن سعيهم لمناصب السلطة ومقعد السلطان ، أن يخوضوا في دماء إخوانهم في الدين ، أو أن يكون معبرهم فوق أشلاء صادقي الإيمان .
لعلك أدركت أيها القارئ أنني أخوض معك في موضوع قريب إلى ذهنك بقدر ما ألح عليه ، وما أكثر ما ألح ، بل ما أصرح ما ألح ، حين ارتفعت ولا تزال ترتفع ، في الانتخابات السياسية والنقابية في مصر رايات مضمونها ( يا دولة الإسلام عودي ، الإسلام هو الحل ، إسلامية إسلامية ) . وهي رايات لا تدري أهي دين أم سياسة ، لكنك تجد مخرجاً في تصور مصدريها أن الدين والسياسة وجهان لعملة واحدة ، وأن تلك الأقوال تعبير عاطفي عن شعارات الإخوان المسلمين القديمة ، بأن الإسلام دين ودولة ، مصحف وسيف . . . الخ .
وقبل أن تسألني ( وهل تنكر ذلك ) يجدر بي أن أضعك أمام وجهتي نظر ، كل منهما تقبل الاجتهاد ، بل وقبل ذلك كله ، تقتضي الإجهاد ، وأقصد بذلك إجهاد الفكر بحثاً عن حقيقة غائبة .
أما وجهة النظر الأولى ، ولا أشك أنها وراء ما ذكرت من دعاوى ، فأنها تتمثل في إن المجتمع المصري مجتمع جاهلي أو بعيد عن صحيح الدين . وبين مقولة تجهيل المجتمع ، ومقولة الابتعاد عن صحيح الدين ، تتدرج مواقف القائلين بين التطرف لأصحاب المقولة الأولى ، والاعتدال للقائلين بالثانية ، لكنهم جميعا متفقون على أن نقطة البدء بالحل تكمن في التطبيق الفوري للشريعة الإسلامية ، وأصحاب وجهة النظر هذه يطرحون خلف ظهورهم خلافهم حول رأيهم في المجتمع الحالي ، ويستقرون بدعوة تطبيق الشريعة ، مؤكدين أن هذا التطبيق ( الفوري ) سوف يتبعه صلاح ( فوري ) للمجتمع ، وحل ( فوري ) لمشاكله .
هذا عن وجهة النظر الأولى ، أما وجهة النظر الثانية ، فلعلي ألمح على وجهك قبل أن أعرضها تساؤلاً مضمونه ( وهل هناك وجهة نظر ثانية ) ، ولعلي أتلمس خلف هذا التساؤل تصوراً بأن وجهة النظر الثانية لابد وأن تتناقض مع ما توصلت إليه وجهة النظر الأولى ، وأنها تصبح والأمر كذلك مصطدمة أو متصادمة مع دعوة لتطبيق أصل من أصول العقيدة . لكني أبادر فأطمئنك بأن وجهة النظر الثانية ، لا تناقض الإسلام بل تتصالح معه ، ولا تأتي من خارجه بل تخرج من عباءته ، ولا تصدر عن مارق بل تصدر عن عاشق لكل قيم الإسلام النبيلة والعظيمة ..
إن وجهة النظر الثانية تستند إلى مجموعة من الفروض يمكن عرضها فيما يلي :
أولا : إن المجتمع المصري ليس مجتمعاً جاهلياً ، بل هو أحد أقرب المجتمعات إلى صحيح الإسلام إن لم يكن أقربها ، حقيقة لا مظهراً ، وعقيدة لا تمسكاً بالشكليات، بل أن التمسك الأصيل والشديد بالقيم الدينية يمكن أن يمثل ملمحاً مصرياً . يصدق هذا على موقف المصريين من العقائد الدينية الفرعونية قبل ظهور الأديان السماوية ، بقدر ما يصدق على موقف المصريين من الدين المسيحي قبل دخول الإسلام مصر ، بقدر ما يصدق أيضاً بدرجة أوضح من كل ما سبق على موقف المصريين من الإسلام ، والشواهد على ذلك كثيرة ، بدءاً من تردد المصريين على المساجد وحماسهم ، وتنافسهم على مركز الصدارة في عدد الحجاج من بلاد العالم الإسلامي كله ، واحتفائهم بالأعياد الدينية ، بل وتحول شهر رمضان إلى عيد ديني قومي لا يمكن تبرير الشغف به ، والاحتفاء بحلوله ، والحسرة على انتهائه إلا بأصالة وعمق الشعور الديني ، وانتهاء بما ساهمت مصر في مجال العقيدة والاجتهاد ، بدءاً بالليث بن سعد ، وفقه الشافعي في مصر ، وانتهاء بالأزهر الشريف ودوره كمنارة للفكر الإسلامي .
ثانياً : إن تطبيق الشريعة الإسلامية ليس هدفاً في حد ذاته ، بل إنه وسيلة لغاية لا ينكرها أحد من دعاة التطبيق وأقصد بها إقامة الدولة الإسلامية ، وهنا مربط الفرس ومحور النقاش ، ودعاة تطبيق الشريعة الإسلامية كما سبق وذكرنا يرفعون شعار أن الإسلام دين ودولة ، والشريعة الإسلامية في مفهومهم تمثل حلقة الربط بين مفهوم الإسلام الدين ومفهوم الإسلام الدولة ، ليس ربطاً بين مفهومين مختلفين ، بل تأكيداً على أنهما وجهان لعملة واحدة – في رأيهم – وهي صحيح الإسلام .
هنا ينتقل النقاش إلى ساحة جديدة ، هي ساحته الحقيقة ، وهي ساحة السياسة ، وهنا يطفو على سطح النقاش سؤال بسيط وبديهي ، ومضمونه أنهم ما داموا قد رفعوا شعار الدولة الإسلامية وانتشر أنصارهم بين الأحزاب السياسية يدعون لدولة دينية يحكمها الإسلام ، فلماذا لا يقدمون إلينا – نحن الرعية – برنامجاً سياسياً للحكم ، يتعرضون فيه لقضايا نظام الحكم وأسلوبه ، سياسته واقتصاده ، مشاكله بدءاً من التعليم وانتهاء بالإسكان ، وحلول هذه المشاكل من منظور إسلامي .
أليست هذه نقطة ضعف جوهرية يواجههم بها من يختلفون معهم سواء بحسن نية ، وهو ما نظن ، أو بسوء نية ، وهو ما يعتقدون وما يتعين عليهم سد ذرائعه حتى لا يتركوا لأحد مجالاً لنقد أو رفض
. هنا يبدو الأمر منطقياً لا تناقض فيه ، وهنا يصبح رفعهم شعار الدين والدولة معاً أمراً مقبولاً ، وهنا يصبح رفضهم لفصل الدين عن السياسة وأمور الحكم رفضاً له من الوجاهة حظ كبير ، وله من المنطق سند قوي ، بل وأكثر من ذلك تصبح قضية تطبيق الشريعة الإسلامية جزءاً من كل ، وهي جزء لا يتناقض مع الكل بحال بل يتناسق معه ، ففي مجتمع الكفاية والعدل ، حيث يجد الخائف مأمناً ، والجائع طعاماً ، والمشرد سكناً ، والإنسان كرامة ، والمفكر حرية ، والذمي حقاً كاملاً للمواطنة ، يصعب الاعتراض على تطبيق الحدود بحجة القسوة ، أو المطالبة بتأجيل تطبيقها بحجة المواءمة ، أو عن قبول بارتكاب المعصية اتقاء لفتنة ، أو تشبها بعمر في تعطيله لحد السرقة في عام المجاعة ، أو لجوءاً للتعزير في مجتمع يعز فيه الشهود العدول .
لعلك متفق معي – أيها القارئ – فيما توصلت إليه من أن مسألة كهذه ، يحب ألا تفوت على المشتغلين بالعمل السياسي الديني ، بل لعلك تتجاوز التعجب إلى الاعتقاد بأن هذا أمر يسير وأنه إلى تدارك ، بل ربما اعتقدت عن تفاؤل بأنه أمر سهو ، وأن السهو إلى زوال ، لكني لا أشاركك تفاؤلك ، لسبب يعلمه دعاة تطبيق الشريعة ويعانون منه ، وأقصد به عقم الاجتهاد ، بل إن شئت الدقة اجتهاد العقم ، وخوف الاختلاف ، بل إن شئت الدقة خلف الخوف ، وطمع الاستسهال ، بل إن شئت الدقة استسهال الطمع ، وعجز القدرة ، بل إن شئت الدقة قدرة العجز .
ليس فيما أقوله بلاغة باللفظ ، بل هي حقيقة تستطيع أن تلمس عشرات الأمثلة على صدقها ، ودونك أيها القارئ العزيز ما حدث في قوانين الأحوال الشخصية ، والتي شهدنا ثلاثة منها في عشر سنوات ، أثار الأول منها ثائرة المدافعين عن حقوق المرأة فكان القانون الثاني الذي أثار حفيظة المدافعين عن حقوق الرجل ، فكان الثالث الذي هدأت به ثائرة الثائرين إلى حين ، على الرغم من أن قانون الأحوال الشخصية جانب هين من جوانب أي برنامج سياسي ، بل أنه أسهل جوانب تطبيق الشريعة الإسلامية ، لأنه لا خلاف عليها أو حولها في كونها المصدر الوحيد للتشريع في هذا المجال ، وهي في النهاية قضية يبدو وجهها الديني أكثر وضوحاً من أي وجه آخر . لكن المشكلة أتت من مواجهة العلماء لعالم جديد ، ترتبت فيه للمرأة حقوق لم تترتب في عصر سابق ، وأصبح عمل المرأة على سبيل المثال واقعاً لا منـّة أو منحة ، وحقاً مكتسباً لا سبيل إلى مناقشته ، وطرحت المتغيرات الجديدة في المجتمع من الظروف ما لا سابقة له في عهد مالك أو أبي حنيفة أو الشافعي أو ابن حنبل ، فأزمة الإسكان قائمة ، بل إن هناك ما لم يعرفه الفقهاء الأربعة حين ناقشوا هذه القضية ، من حكم الشقة المستأجرة أو ( التمليك ) ، وهي كلها أمور أوقعت العلماء في حيص ( و هو الاختلاف بينهم ) ، وفي بيص ( وهو الخلاف بينهم من ناحية وبين قطاعات كبيرة في المجتمع من ناحية أخرى ) . وفي كل حال من الأحوال الثلاث – أقصد القوانين الثلاثة – وجد العلماء ضالتهم في الانتقال من مالك إلى أبي حنيفة ، فإن لم يجدوا انتقلوا إلى فتاوى فقهاء أقل حظاً من الشهرة من أمثال سهل بن معاوية ، وهم في كل الأحوال لم يتجاوزا القرن الثاني الهجري قيد أنملة ، أو إن شئنا الدقة قيد عام .
ماذا سيكون الحال إذا تطرق الأمر إلى مجال الاقتصاد ، وشغل دعاة الدولة الإسلامية أنفسهم بقضية زيادة الإنتاج في المجتمع ، وفوجئوا بحجم استثمارات القطاع العام التي تتراوح بين ثلاثين إلى خمسين مليار جنية ، يعتمد تمويلها على مدخرات المصريين في بنوك القطاع العام . والمدخرات في صورة ودائع ، والودائع تستحق فوائد ، وآخر اجتهادات القرن الثاني الهجري ، والتي لم تعاصر قطاعاً عاماً أو بنوكاً أدخلت العائد الثابت للمدخرات في دائرة الربا ، وآخر ما و صل إليه الداعون للدولة الإسلامية هو الركون إلى اجتهادات هؤلاء الفقهاء ، وكأنها تنزيل من التنزيل ، ماذا سيكون الحال ؟ ..
مأزق إن تجمدوا ، وبرنامج سياسي إذا اجتهدوا ، ولعل أول الحالين أقرب لتصوير الواقع ، فالتصوير أهون من التطوير ، والحكم بخروج المجتمع كله من دائرة الإيمان أسهل ، والحكم بعدم مشروعية الفوائد أيسر ، وتجهيل المجتمع ومؤسساته أضمن ، والنحو باللائمة على الزمان أسهل السبل ، والترحم على الشاعر العربي وارد حين قال ( نعيب زماننا والعيب فينا ) ، هذا عن هين الأمور ، وأقصد به التفصيلات ، أما أصعبها وأقصد به الأمور العامة ، والمنظمة لأسلوب اختيار الحاكم أو أسلوب الحكم أو العلاقة بين السلطات فإن تناول أي منها هو المحك الحقيقي لدعوة ( الدولة الدينية ) بعيداً عن سجع الألفاظ وشقشقات البلاغة . وأنت في طرحك للأسئلة وبحثك عن الإجابات تكتشف أنك في سباق للموانع ، ومباراة لاستعراض حجم ضخم من الخلافات التي لم تحسم ، ولم يمنع عدم حسمها ، نتيجة غياب الاجتهاد المستنير ، أن يدعوك البعض إلى خوض التجربة ، وأن يتحاشى الجميع الخوض فيها إيثاراً لراحة البال ( بالهم هم ) ، وتجنباً للخلاف ( خلافهم هم ) ، وهم في كل الأحوال في مأمن ، إن أعجزتهم الإجابة أفتوا بأنك لا تملك أدوات البحث في القضايا الدينية ، وإن أفحمهم المنطق تنادوا بأنك عميل للإمبريالية ، أو متأثر بالشيوعية ، أو ناطق بلسانهما معاً . وحتى لا تتحول القضية إلى تراشق فإنني سأحاول معك أن أستعرض بعضاً من تلك الموانع التي أشرت إليها ، ولنبدأ بالحاكم ، وبديهي أن أول ما سيتبادر إلى ذهنك هو الشروط التي يجب أن تتوافر فيه ، وقد تتصور أن الشروط سهلة ، وأنها يمكن أن تتمثل في كونه مسلماً عاقلاً رشيداً إلى آخر هذه الأوصاف العامة ، لكنك تصطدم بشرط غريب ، تذكره كثير من كتب الفقه ، وهو أن يكون ( قرشياً ) ، وقد تتعجب من أن ينادي البعض بهذا الشرط باسم الإسلام ، الذي يتساوى الناس أمامه ( كأسنان المشط ) ، والذي لا يعطي فضلاً لعربي على عجمي إلا بالتقوى . وقد يتبادر إلى ذهنك خاطر غريب ، وإن كان صحيحاً ، يتمثل في أن هذا الشرط قد وضع لكي يبرر حكم الخلفاء الأمويين أو العباسيين ، وكلهم قرشي ، بل قد يتداعى إلى ذهنك ما قرأته في كتب التاريخ القريب عن الملك فاروق في أول عهده ، حين قدمه محترفو السياسة إلى المصريين في صورة الملك الصالح ، وظهر في الصور بلحيته ومسبحته ونصف إغفاءة من عينيه ، وتسارع بعض رجال الدين ( الطموحين ) إلى المناداة به ملكاً ( وإماماً ) للمسلمين ، واجتهد الأذكياء منهم في إثبات نسبه للرسول ، وتبارى الإعلام في الإعلان عن هذا النسب وتأكيده ، تحقيقاً لشرط من شروط الإمامة ، وسداً للذرائع على المعترضين . ولعلك مثلي تماماً لا تستريح لهذا الشرط ، الذي يصنف المسلمين إلى أصحاب دم أزرق وهم القرشيون الحكام ، وأصحاب دم أحمر ينتظم الأغلبية ، لكنهم يواجهونك بحديث نبوي مضمونه أن الإمامة من قريش ، وتتبادر إلى ذهنك في الحال عشرات الأحاديث التي وضعها الوضاعون ، والتي و صلوا فيها إلى تسمية الخلفاء العباسيين وتحديد موعد خلافتهم بالسنة واليوم ، وهي كلها أحاديث وضعها من لا دين لهم هوى الحكام ، ولا ضمير لهم ولا عقيدة ، لكنك في نفس الوقت تخشى من اتهامك بالعداء للسنة ، خاصة من الذين قصروا دراستهم للأحاديث النبوية على أساس السند وليس على أساس المتن ( أي المعنى والمضمون ومدى توافقه مع النص القرآني ) .
ولا تجد مهرباً إلا بتداعيات اجتماع سقيفة بني ساعدة في المدينة ، والذي اجتمع فيه الأنصار لانتخاب سعد بن عبادة ، وسارع أبو بكر وعمر وأبو عبيده الجراح إليهم ورشحوا أبا بكر ، ودار حوار طويل بين الطرفين ، انتهى بمبايعة أبي بكر ، وأنت في استعراضك للحوار ، لا تجد ذكراً للحديث النبوي السابق ، وهو إن كان حديثاً صحيحاً لما جرؤ سعد بن عبادة سيد الخزرج على ترشيح نفسه ، ولكفى أبا بكر وعمر والجراح مؤونة المناظرة ، ولما فاتهم أن يذكروه وهو في يدهم سلاح ماض يحسم النقاش ، ويكفي أن تعلم أن سعد بن عبادة ظل رافضاً لبيعة أبي بكر إلى أن مات ، ولم يجد من يأخذ بيده إلى هذا الحديث فيبايع عن رضى وهو الصحابي الجليل ذو المواقف غير المنكورة في الإسلام ، غير أن لكل ظاهرة سيئة وجهها المفيد ، فقد انبرى أصحاب الرأي الآخر ، والذين يؤمنون بحق الاكفأ في الحكم دون اعتبار لنسبه إلى ذكر أحاديث مضادة بمنطق " وداوها بالتي كانت هي الداء " ، مضمونها أنه لا مانع من أن يحكم المسلمين عبد حبشي أسود ( كأن رأسه زبيبة ) فأعادوا للمنطق توازنه ، وأعطوا لكثير من الطوائف الإسلامية التي نشأت فيما بعد سنداً لرأيهم المعارض لخلافة العباسيين ، وإن كانت نتيجة ذلك كله ، وضع المانع الأول في مسيرة الدولة الإسلامية ، وهو الخلاف الفقهي حول نسب الحاكم وهل يكون بالضرورة قرشياً أم أنه الاكفأ بغض النظر عن نسبه ، ولا عبرة هنا بالمنطق أو بواقع الحال ، فسيف إنكار الحديث وارد على رقاب كل من الطرفين ، في قضية أتصور أنا وأنت أنها هينة سهلة ، لا تستحق عناء ولا تقتضي طول بحث ، ولا تنتقل منها أو تتجاوزها إلى أسلوب تولية الحاكم حتى تكتشف مانعاً ضخماً يدور حوله الجدل إلى اليوم ولا يقنع المتجادلون فيه بمنطق بسيط وواضح وهو أن القرآن لم يترك قاعدة في هذا الأمر ، والرسول لم يعرض لها من قريب أو بعيد وإلا لما حدث الخلاف والشقاق في اجتماع السقيفة ، ولما رفض على قبول تولية أبي بكر ومبايعته على اختلاف في الرواية بين رفضه المبايعة أياماً في أضعف الروايات ، وشهوراً حتى موت فاطمة في أغلبها ، بل إن أسلوب السقيفة لو كان هو الأصح ، لاتبعه أبو بكر نفسه وترك تولية من يليه إلى المسلمين أو أهل الحل والعقد منهم ، وهو ما لم يفعل حين أوصى لعمر بكتاب مغلق بايع عليه المسلمون قبيل وفاته دون أن يعلموا ما فيه ، وهو أيضاً مرة أخرى ما خالفه عمر في قصر الاختيار بين الستة المعروفين ، وهم على وعثمان وطلحة والزبير وابن عوف وسعد ، وهو ما اختلف عن أسلوب اختيار على ببيعة بعض الأمصار ، ومعاوية بحد السيف ، ويزيد بالوراثة .
أنت هنا أمام ستة أساليب مختلفة لاختيار الحاكم ، يرفض المتزمتون تجاوزها ، ويختلفون في تفضيل أحدها على الآخر ، ويرى المتفتحون أن دلالتها الوحيدة أنه لا قاعدة ، وأن الإسلام السمح العادل ، لا يرفض أسلوب الاختيار بالانتخاب المباشر أو غير المباشر ، وهو ما لا أظن أنه كان يوماً ، حتى يومنا هذا محل اتفاق أو قبول عام من أنصار الدولة الدينية . ولعلي لا أتحدث من فراغ ، بل أصدر عن واقع النظم الإسلامية المعاصرة في عالمنا الحديث ، فهناك بيعة أهل الحل والعقد ( المختارون ) في السعودية مع قصر الترشيح على أفراد الأسرة المالكة ، وهناك المبايعة على كتاب مغلق يكتبه الحاكم ويوصى فيه لمن يليه اشتقاقاً من أسلوب اختيار أبي بكر لعمر ، في السودان في عهد النميري، وهناك ولاية الفقيه في إيران ، وهناك اعتبار الموافقة في الإستفتاء على الشريعة الإسلامية موافقة ضمنية على الحاكم واختياراً له في الباكستان ، وهناك في كل الأحوال مانع جديد يضاف إلى ما سبق ، وهو أن مدة تولية الحاكم في كل الأحوال السابقة مستمرة مدى حياته ، ولا عبرة في ذلك بأن البيعة على أساس الالتزام بكتاب الله وسنة رسوله ، وأن الحاكم يعزل إذا خالف ذلك ، فما أكثر ما خالف ، دون أن يعزل أو حتى يعترض عليه قديماً كان أو حديثاً ، وحديث التاريخ في هذا ذو شجون بل قل ذو جنون ، سواء في تطرف الحاكم في خروجه على صحيح العقيدة أو تطرف الرعية في الخنوع لإرادته والخضوع لبطشه ، ولعل القارئ يلاحظ أنني قد تشددت في العبارات الأخيرة حتى أستلهم في ذهن دعاة الدولة الدينية رداً منطقياً بأن الشورى مانعة لبطش الحاكم ، حافظة لحق الرعية ، غير أني آسف إذا ذكرت لهم أن هذا بدوره يقود إلى مانع جديد هو الخلاف حول كنه الشورى ، وهل هي ملزمة للحاكم وهو رأي الأقلية أم أنها غير ملزمة له وهو رأي الأغلبية التي تفرق بين كون الحاكم ملزماً بأن يستشير ، وبين كونه في نفس الوقت غير ملزم باتباع رأيهم حتى إن اجتمعوا عليه جميعهم أو أغلبهم .
لقد أدرك بعض المخلصين من الدعاة أنهم يواجهون من ظروف المجتمعات الحديثة ما لم يواجهه السلف ، وأن الديموقراطية بمعناها الحديث ، وهو حكم الشعب بالشعب لا تتناقض مع جوهر الإسلام وأن اجتهادات المؤمنين بالديموقراطية ، والتي تمخضت عن أساليب الحكم النيابي ، والانتخابات المباشرة ، لا يمكن أن تصطدم بجوهر العدل في الدين الإسلامي ، وروح الحرية التي تشمل ويشملها ، ومن أمثالهم الأستاذ الكبير خالد محمد خالد والعالم الجليل محمد الغزالي ، لكنهم واجهوا تياراً كاسحاً من الرفض لما أملاه عليهم اتساع أفقهم ، وفهمهم لجوهر العقيدة الأصيل ، وانبرى زعماء التيارات الثورية والتقليدية في نقد الآراء وتفنيدها ، لا فرق في هذا بين معتدل أو متطرف ، ودونك ما نشر على لسان الأستاذ عمر التلمساني والأستاذ عمر عبد الرحمن وهو في مجمله يرفض مقولة حكم الشعب بدعوى أن الحكم لله ، وهو أمر لو أمعنت النظر فيه لما وجدت تناقضاً ، لكنهم يحاولون تأصيل منهجهم بافتراضات منها أن الأغلبية قد تقر تشريعاً يعارض شريعة الله ، وأن التسليم بحق المجالس النيابية في التشريع سلب لحق إلهي ثابت ومقدس ، وهو كونه جل شأنه المشرع الأكبر والوحيد . وأنها – أي الديموقراطية – قد تعطل النص الشرعي بالرأي الشخصي ، وهكذا أيها القارئ لا تنتهي عقبة أو مانع إلا وتظهر عقبة جديدة أو مانع جديد ، وهي كلها موانع قد يسعد بها المجتهدون المتفتحون ، لأنها تفتح أمامهم باباً واسعاً للرأي وللاجتهاد دون خروج على صحيح الدين ، ودون تصادم مع روح العصر ، لكنها في الجانب الآخر تفزع من ركنوا إلى اجتهادات السلف أيما فزع ، وتضعهم بين شقي الرحى ، إن دارت يميناً طحنت برفض العصر ، وإن دارت شمالاً طحنت برفض العقل ، وإن سكنت أبقتهم حيث هم ، يهربون من الأصل إلى الفرع ، ويخفون منطقاً أواجههم به ، بل إن شئت الدقة أتحداهم به ، وهو أن الشريعة وحدها لا تستقيم وجوداً أو تطبيقاً إلا في مجتمع إسلامي أو بمعنى أدق دولة دينية إسلامية ، وأن هذه الدولة والجزئيات ، وأنهم أعجز من أن يصيغوا مثل هذا البرنامج أو يتقدموا به ، وأنهم يهربون من الرحى برميها فوق رؤوسنا ، داعين إيانا إلى تطبيق الشريعة الإسلامية ، التي تقودنا بالحتم إلى دولة دينية إسلامية ، نتخبط فيها ذات اليمين وذات اليسار ، دون منارة من فكر أو اجتهاد مستنير ، وليحدث لنا ما يحدث ، وليحدث للإسلام ما يحدث ، وما علينا إلا أن نمد أجسادنا لكي يسيروا عليها خيلاء ، إن أعجزهم الاجتهاد الملائم للعصر رفضوا العصر ، وأن أعجزهم حكم مصر هدموا مصر .
ثالثا : إنه من المناسب أن أناقش معك أيها القارئ مقولة ذكرتها لك ضمن وجهة نظر الداعين للتطبيق الفوري للشريعة ، وهي قولهم بأن التطبيق ( الفوري ) للشريعة ، سوف يتبعه صلاح ( فوري ) لمشاكله ، وسوف أثبت لك أن صلاح المجتمع أو حل مشاكله ليس رهناً بالحاكم المسلم الصالح ، وليس أيضاً رهناً بتمسك المسلمين جميعاً بالعقيدة وصدقهم فيها وفهمهم لها ، وليس أيضاً رهناً بتطبيق الشريعة الإسلامية نصاً وروحاً ، بل هو رهن بأمور أخرى أذكرها لك في حينها ، دليلي في ذلك المنطق وحجتي في ذلك وقائع التاريخ ، وليس كالمنطق دليل ، وليس كالتاريخ حجة ، وحجة التاريخ لدى مستقاة من أزهى عصور الإسلام عقيدة وإيماناً ، وأقصد به عصر الخلفاء الراشدين .
أنت أمام ثلاثين عاماً هجرياً ( بالتحديد تسعة وعشرون عاماً وخمسة أشهر ) هي كل عمر الخلافة الراشدة ، بدأت بخلافة أبي بكر ( سنتين وثلاثة أشهر وثمانية أيام ) ثم خلافة عمر ( عشر سنين وستة أشهر وتسعة عشر يوماً ) ثم خلافة عثمان ( إحدى عشرة سنة وأحد عشر شهراً وتسعة عشر يوماً ) ثم خلافة علي ( أربع سنين وسبعة أشهر ) . وتستطيع أن تذكر بقدر كبير من اليقين أن خلافة أبي بكر قد انصرفت خلال العامين والثلاثة أشهر إلى الحرب بين جيشه وبين المرتدين في الجزيرة العربية ، وأن خلافة علي قد انصرفت خلال الأربعة أعوام والسبعة أشهر إلى الحرب بين جيشه في ناحية وجيوش الخارجين عليه والرافضين لحكمه في ناحية أخرى ، بدءاً من عائشة وطلحة والزبير في موقعة الجمل ، وانتهاء بجيش معاوية في معركة صفين ومروراً بعشرات الحروب مع الخوارج عليه من جيشه ، وأنه في العهدين كانت هموم الحرب ومشاغلها أكبر بكثير من هموم الدولة وإرساء قواعدها . أضف إلى ذلك قصر عهد الخلافتين ، حيث لم يتجاوز مجموع سنواتهما ست سنوات وعشرة أشهر ، ويبقى أمامك عهد عمر وعهد عثمان ، حيث يمكن أن تتعرف فيهما على الإسلام الدولة في أزهى عصور الإسلام إسلاماً ، وأحد العهدين عشر سنين ونصف ( عهد عمر ) ، والثاني حوالي أثنى عشر عاماً ( عهد عثمان ) ، وهي فترة كافية لكل من العهدين لكي يقدم نموذجاً للإسلام الدولة كما يجب أن تكون ، فعمر وعثمان من أقرب الصحابة إلى قلب الرسول وفهمه ، والاثنان مبشران بالجنة ، وللأول منهما وهو عمر مواقف مشهودة في نصرة الإسلام وإعلاء شانه ، وهي مواقف لا تشهد بها كتب التاريخ فقط ، بل يشهد بها القرآن نفسه ، حين تنزلت بعض آياته تأييداً لرأيه ، وهو شرف لا يدانيه شرف ، وللثاني منهما وهو عثمان مواقف إيمان وخير وجود ، ويكفيه فخراً أنه زوج ابنتي الرسول ، هذا عن الحاكم في كل من العهدين . أما عن المحكومين ، فهم صحابة الرسول وأهله وعشيرته لا تحدث واقعة إلا تمثل أمامهم للرسول فيها موقف أو حديث ولا يمرون بمكان إلا وتداعت إلى خيالهم ذكرى حدث به أو قول فيه ولا تغمض أعينهم أمام المنبر إلا وتمثلوا الرسول عليه قائماً ولا يتراصون للصلاة خلف الخليفة إلا وتذكروا الرسول أمامهم إماماً ، وهم في قراءتهم للقرآن يعلمون متى نزلت الآية ، وأين ، ولماذا إن كان هناك سبب للتنزيل ، وباختصار يعيشون في ظل النبوة ويتأسون بالرسول عن قرب وحب ، هذا عن المحكومين ، ولا يبقى إلا الشريعة الإسلامية وهي ما لا يشك أحد في تطبيقها في كل من العهدين . بل أنك لا تتزيد إن أعلنت أن هذا العهد أو ذاك ، كان أزهى عصور تطبيقها لأنها لزوم ما يلزم في ضوء ما سبق أن ذكرنا بشأن الحاكم والمحكوم ، ومع ذلك فقد كان عهد عمر شيئاً وعهد عثمان شيئاً آخر فقد ارتفع عمر بنفسه وبالمسلمين إلى أصول العقيدة وجوهرها ، فسعد المسلمون به ، وصلح حال الدولة على يديه ، وترك لمن يليه منهجاً لا يختلف أحد حوله ، ولا نتمثل صلاح الحكم وهيبة الحاكم إلا إذ استشهدنا به ، بينما قاد عثمان المسلمين إلى الاختلاف عليه ، ودفع أهل الحل والعقد إلى الإجماع على الخلاص منه ، إما عزلاً في رأي أهل الحجى ، أو قتلاً في رأي أهل الضراب ، واهتزت هيبته في نظر الرعية إلى الحد الذي دفع البعض إلى خطف السيف من يده وكسره نصفين أو حصبه على المنبر ، أو التصغير من شأنه بمناداته ( يا نعثل ) نسبة إلى مسيحي من أهل المدينة كان يسمى نعثلاً وكان عظيم اللحية كعثمان ، أو الاعتراض عليه من كبار الصحابة بما يفهم منه دون لبس أو غموض أنه خارج على القرآن والسنة ، ووصل الأمر إلى الدعوة الصريحة لقتله ، حيث يروي عن عائشة قولها : اقتلوا نعثلاً لعن الله نعثلاً ، وهي كلها أمور لا تترك لك مجالاً للشك فيما وصل إليه أمر الخليفة قبل رعيته ، وما وصل إليه أمر الرعية قبل الخليفة .
وعلى الرغم من أن عمر وعثمان قد ماتا مقتولين ، إلا أن عمر قد قـُتل على يد غلام من أصل مجوسي ، وترك قتله غصة في نفوس المسلمين ، وأثار في نفوسهم جميعاً الروع والهلع لفقد عظيم الأمة ، ورجلها الذي لا يعوض ، بينما على العكس من ذلك تماماً ، ما حدث لعثمان عند مقتله ، فقد قتل على يد المسلمين الثائرين المحاصرين لمنزله وبإجماع منهم ، وقد تتصور أن قتلة عثمان قد أشفوا غليلهم بمصرعه على أيديهم ، وانتهت عداوتهم له بموته ، لكن كتب التاريخ تحدثنا برواية غريبة ليس لها نظير سابق أو لاحق ، وإن كانت لها دلالة لا تخفى على أريب : فالطبري يذكر في كتابه تاريخ الأمم والملوك الجزء الثالث ص 439 : ( لبث عثمان بعدما قتل ليلتين لا يستطيعون دفنه ثم حمله أربعة " حكيم ابن حزام وجبير بن مطعم ونيار بن مكرم وأبو جهم بن حذيفة " فلما وضع ليصلي عليه جاء نفر من الأنصار يمنعوهم الصلاة عليه فيهم أسلم بن أوس بن بجرة الساعدي وأبو حية المازني ومنعوهم أن يدفن بالبقيع فقال أبو جهم ادفنوه فقد صلى الله عليه وملائكته فقالوا لا والله لا يدفن في مقابر المسلمين أبداً فدفنوه في حش كوكب ( مقابر اليهود ) فلما ملكت بنى أمية أدخلوا ذلك الحش في البقيع ) وفي رواية ثانية ( أقبل عمير بن ضابئ ،وعثمان موضوع على باب فنزا عليه فكسر ضلعاً من أضلاعه ) ، وفي رواية ثالثة أنهم دفنوه في حش كوكب حين رماه المسلمون بالحجارة فاحتمى حاملوه بجدار دفنوه فوقع دفنه في حش كوكب .
هذا خليفة المسلمين الثالث ، يقتله المسلمون ، لا يستطيع أهله دفنه ليلتين ويدفنوه في الثالثة ، يرفض المسلمون الصلاة عليه ، بقسم البعض ألا يدفن في مقابر المسلمين أبداً ، يحصب جثمانه بالحجارة ، يعتدي مسلم على جثمانه فيكسر ضلعاً من أضلاعه ، ثم يدفن في النهاية في مقابر اليهود .
أي غضب هذا الذي يلاحق الحاكم حتى وهو جسد مسجى ، وينتقم منه وهو جثة هامدة ، ولا يراعي تاريخه في السبق في الإسلام والذود عنه ، ولا عمره الذي بلغ السادسة و الثمانين ، ويتجاهل كونه مبشراً بالجنة وزوجاً لابنتي الرسول ، ويرفض حتى الصلاة عليه أو دفنه في مقابر المسلمين شأنه شأن أفقرهم أو أعصاهم .
هو غضب لا شك عظيم ، وخطب لا ريب جليل ، وحادث لا تجد أبلغ منه تعبيراً عن رأي المسلمين في حاكمهم ، وأمر لا يؤثر في الإسلام من قريب أو بعيد ، فعثمان رضي الله عنه ليس ركناً من أركان الإسلام ، وإنما هو بشر يخطئ ويصيب ، وحاكم ليس له من الحصانة أو القدسية ما يرفعه عن غيره من المسلمين ، لكنك لا تملك إلا أن تتساءل معي وأن تجيب
. * ألم يكن عثمان وقت اختياره واحداً من خيار المسلمين ، مبشراً بالجنة وأحد ستة هم أهل الحل والعقد ، وأحد اثنين لم يختلف المسلمون على أن الخلافة لن تخرج عنهما وهما عثمان وعلي ؟ والإجابة ( بلــــى ) * ألم يكن المسلمون في أعلى درجات تمسكهم بالعقيدة ، وأقرب ما يكونون إلى مصدرها الأول وهو القرآن ومصدرها الثاني وهو السنة ، بل كان أغلبهم أصحاباً للرسول وناقلين عنه ما وصلنا من حديث وأحداث ؟ والإجابة ( بلــــى )
* ألم تكن الشريعة الإسلامية مطبقة في عهد عثمان رضي الله عنه ؟ والإجابة ( بلــــى ) * هل ترتب على ما سبق ( حاكم صالح ومسلمون عدول وشريعة إسلامية مطبقة ) أن صلح حال الرعية ؟ ، و حسن حال الحكم ؟ وتحقق العدل ؟ وساد الأمن و الأمان ؟ والإجابة ( لا ) .
وهنا نصل سوياً إلى مجموعة من النتائج نستعرضها معاً عسى أن تحل لنا معضلة التفسير وأن تجيب معنا على السؤال الحائر و موجزه لفظ ( لماذا ) .
النتيجة الأولى :
أن العدل لا يتحقق بصلاح الحاكم ، ولا يسود لا بصلاح الرعية ، ولا يتأتى بتطبيق الشريعة ، وإنما يتحقق بوجود ما يمكن أن نسميه ( نظام حكم ) ، وأقصد به الضوابط التي تحاسب الحاكم إن أخطأ ، وتمنعه إن تجاوز ، وتعزله إن خرج على صالح الجماعة أو أساء لمصالحها ، وقد تكون هذه الضوابط داخلية ، تنبع من ضمير الحاكم ووجدانه ، كما حدث في عهد عمر ، وهذا نادر الحدوث ، لكن ذلك ليس قاعدة ولا يجوز الركون إليه ، والأصح أن تكون مقننة ومنظمة . فقد واجه قادة المسلمين عثمان بخروجه على قواعد العدل بل وأحياناً بخروجه عل صحيح جوهر الإسلام ، فلم يغير من سياسته شيئاً ، وبحثوا فيما لديهم من سوابق حكم فلم تسعفهم سابقة ، ومن قواعد لتسيير أمور الدولة فلم يجدوا قاعدة ، وأشتد عليهم الأمر فحاصروه وطلبوا منه أن يعتزل ، ولأن قاعدة ما في الأمر لم تكن موجودة ، فقد أجابهم بقوله الشهير والله لا أنزع ثوباً سربلنيه الله ( أي ألبسنيه الله ) ، وحين اقترب الأمر من نهايته ، وأصبح قاب قوسين أو أدنى من ملاقاة حتفه على يد رعيته ، أرسلوا إليه عرضاً فيه من المنطق الكثير ومن الصواب ما لا يختلف عليه . فقد خيروه بين ثلاث : - إما الإقادة منه ( أي أن يعاقب على أخطائه شأنه شأن أي مسلم يخطئ ) ويستمر بعدها خليفة بعد إدراكه أنه لا خطأ دون عقاب. - وإما أن يتبرأ من الإمارة ( أي أن يعتزل الخلافة بإرادته ) . - وإما أن يرسلوا الأجناد وأهل المدينة لكي يتبرأوا من طاعته ( أي أن يعتزل الخلافة بإرادة الرعية ) . فكان رده كما ورد في رسالته الأخيرة كما انتسخها بن سهيل ( وهم يخيرونني إحدى ثلاث إما يقيدونني بكل رجل أصبته خطأ صواباً غير متروك منه شئ ، وإما أعتزل الأمر فيؤمرون آخر غيري وإما يرسلون إلى من أطاعهم من الأجناد وأهل المدينة فيتبرأون من الذي جعل الله سبحانه لي عليهم من السمع والطاعة فقلت لهم أما إقادتي من نفسي فقد كان من قبلي خلفاء تخطئ وتصيب فلم يستقدمن أحد منهم وقد علمت إنما يريدون نفسي وأما أن أتبرأ من الإمارة فإن يكلبوني أحب إلى من أن أتبرأ من عمل الله عز وجل وخلافته وإما قولكم يرسلون إلى الأجناد وأهل المدينة فيتبرأون من طاعتي فلست عليكم بوكيل ولم أكن استكرهتهم من قبل على السمع والطاعة ولكن أتوها طائعين ) .
هنا يوضح عثمان بصراحة أن مراجعة الخليفة على الخطأ لم تكن واردة فيمن سبقه من الخلفاء ( أبو بكر وعمر ) أو على الأقل ليس لها قاعدة ، وهنا أيضاً يعلن بلا مواربة أنه مُصر على تمسكه بالحكم حتى النهاية وأن اعتزاله غير وارد ، وهنا أيضاً يواجه الدعوة إلى سحب البيعة بمنطق غريب مضمونه ، وهل كنت أكرهتكم حين بايعتم ؟ وكأن البيعة أبدية ولا مجال لسحبها أو النكوص عنها .
لا قاعدة إذن ولا نظام للرقابة ، والأمر كله موكول لضمير الحاكم إن عدل وزهد كان عمر ، وإن لم يعدل ويمسك بالحكم كان عثمان . لقد أعلن عثمان أن نظام الحكم الإسلامي ( من وجهة نظره ) يستند إلى القواعد الآتية : -
خلافة مؤبدة
- لا مراجعة للحاكم ولا حساب أو عقاب أن أخطأ .
- لا يجوز للرعية أن تنزع البيعة منه أو تعزله ، ومجرد مبايعتها له مرة واحدة ، تعتبر مبايعة أبدية لا يجوز لأصحابها سحبها وإن رجعوا عنها أو طالبوا المبايع بالاعتزال .
ولأن أحدا لا يقر ولا يتصور أن تكون هذه هي مبادئ الحكم في الإسلام ، قتله المسلمون ، لكن السؤال يظل حائراً ، ومضمونه ، هل هناك قاعدة بديلة ؟ أو نظام حكم واضح المعالم في الإسلام ؟ هل هناك قاعدة في القرآن والسنة تحدد كيف يبايع المسلمون حاكمهم ، وتضع ميقاتاً لتجديد البيعة ، وتحدد أسلوباً لعزل الحاكم بواسطة الرعية ، وتثبت للرعية حقها في سحب البيعة كما تثبت لها حقها في إعلانها ، وتعطي المحكومين الحق في حساب الحاكم وعقابه على أخطائه ، وتنظم ممارستهم لهذا الحق ؟
أعتقد أن السؤال كان حائراً ولا يزال ، بل إن السؤال نفسه قد اختفى بعد عهد الخلفاء الراشدين ، وحرص المزايدون والمتزيدون في عصرنا على إخفائه ، تجنباً للحرج ، وتلافياً للخلاف ، ونأياً بأنفسهم عن الاجتهاد وهو أمر بالنسبة لهم عسير ، ربما عن قعود ، وربما عن جمود ، وربما عن عجز .
النتيجة الثانية : إن تطبيق الشريعة الإسلامية وحده ليس هو جوهر الإسلام ، فقد طبقت وحدث ما حدث ، وأخطر من تطبيقها بكثير وضع قواعد الحكم العادل المتسق مع روح الإسلام ، فقد رأينا أن الشريعة كانت مطبقة ، وأن الحاكم كان صالحاً ، وإن الرعية كانت مؤمنة ، وحدث ما حدث ، لغياب ما غاب ، وأظنه لا يزال غائباً .
ولعل ما حدث في السودان خير دليل على مغبة البدء بالوجه العقابي للإسلام ، وهو ما حدث حين أعلن الحاكم عن تطبيق الشريعة الإسلامية وبدأ في إقامة الحدود في مجتمع مهدد بالمجاعة ، الأمر الذي ترتب عليه أن أصبح أنصار تطبيق الشريعة الإسلامية بعد تلك التجربة أقل بكثير من أنصارها قبل التطبيق ، فالبدء يكون بالأصل وليس بالفرع ، وبالجوهر وليس بالمظهر ، وبالعدل قبل العقاب ، وبالأمن قبل القصاص وبالأمان قبل الخوف ، وبالشبع قبل القطع .
النتيجة الثالثة : إنك إن انتقلت من عهد عثمان إلى عهدنا الحاضر ، لا تجد شيئاً قد اختلف أو استجد سواء بالنسبة لحل مشاكل المجتمع ، أو بالنسبة لمواجهة السلطة إن انحرفت ، من خلال منظور إسلامي ، ودونك ربطهم بين تطبيق الشريعة وحل مشاكل المجتمع ، واسألني وأسأل نفسك .
* كيف ترتفع الأجور وتنخفض الأسعار إذا طبقت الشريعة الإسلامية ؟
* كيف تحل مشكلة الإسكان المعقدة بمجرد تطبيق الشريعة الإسلامية ؟
* كيف تحل مشكلة الديون الخارجية بمجرد تطبيق الشريعة الإسلامية ؟
* كيف يتحول القطاع العام إلى قطاع منتج بما يتناسب وحجم استثماراته في ظل تطبيق الشريعة الإسلامية ؟
هذه مجرد عينات من الأسئلة ، على الداعين للتطبيق الفوري ( للشريعة ) والمدعين أنها سوف يترتب عليها حل ( فوري ) لمشاكل المجتمع أن يجيبوا عليها ، وهم إن حالوا الإجابة وجدوا أنفسهم أمام المأزق الذي يدور هذا الحوار حوله ، وهو وضع برنامج سياسي متكامل ، بل إن تفرغهم للإبداع ( النقلى ) من اجتهادات القرن الثاني الهجري يمكن أن يقودهم إلى تعقيد المشاكل بدلاً من حلها ، فالنظرة الضيقة إلى مفهوم الربا إن طبقت في عالم اليوم ، سوف تقود إلى ارتباك هائل في سوق المال وسوف تلجئ إلى تحايل نرى ملامحه في تجربة البنوك الإسلامية ، وربما أدت إلى الخراب بدلاً من التنمية ، والكساد بديلاً عن الرواج . وقبل أن تفغر فاك مندهشاً أو ترفع يدك معترضاً دعني أذكر لك أن الشريعة لا تقود إلى ذلك ، بل إنه اجتهاد القرن الثاني الهجري هو الذي يقود إذا طبق في عالم تغيرت معالمه تغيرت معالمه ، وتبدلت أحواله ، وعرف أنماطاً من التعامل لم يعرفها السلف ، وطرأت فيه من المتغيرات ما لا يقصر الاستدانة على الحاجة ، أو الادخار على مفهوم إقراض الغير ، وعرف التضخم الذي يترتب عليه خفض القوة الشرائية للنقود ، إلى غير ذلك مما لا يسعه حصر ولم يشمله اجتهاد بعد ، اللهم إلا اجتهاد في مناخ غير المناخ ، ولعصر غير العصر .
هذا عن الربا ، فماذا عن الأجور والأسعار والإسكان ، هل هناك علاقة بين هذه الظواهر أو المشاكل وبين تطبيق الشريعة ، المؤكد أنهلا علاقة ولا ارتباط ، لكن الارتباط قائم ومؤكد إن كان الحديث عن برنامج سياسي ينتظم مفردات المجتمع بما فيه الشريعة في منظومة لا تتناقض مع الإسلام ولا تتصادم مع متغيرات الواقع .
النتيجة الرابعة : إننا يجب أن نفرق بين الهروب والمواجهة ، وبين النكوص والإقدام ، وبين المظهرية والجوهر ، فالمجتمع لن يتغير والمسلمون لن يتقدموا بمجرد إطالة اللحية و حلق الشارب ، والإسلام لن يتحدى العصر بإمكانيات التقدم بمجرد أن يلبس شبابنا الزي الباكستاني ، ومصر لن يتألق وجهها الإسلامي الحضاري بمجرد أن يتنادى الشباب بغير أسمائهم فيدعو الواحد منهم الآخر باسم ( خزعل ) ويرد عليه الآخر التحية بأحسن منها فيدعوه ( عنبسة ) . واللحاق بركب التقدم العلمي لن يحدث بمجرد استخدام السواك بديلاً عن فرشاة الأسنان أو تكحيل العينين أو استعمال اليد في الطعام أو الاهتمام بالقضايا التافهة مثل نظرية ( حبس الظل ) في شأن التماثيل أو الصور أو إضاعة الوقت في الخلاف حول طريقة دخول المرحاض وهل تكون بالقدم اليمنى أم اليسرى ، وميقات ظهور المهدى المنتظر ، ومكان ظهور المسيخ الدجال ، فكل هذه قشور ، والغريب أنها تشغل أذهان الشباب وبعض الدعاة بأكثر مما يشغلهم جوهر الدين وحقيقته . وهو جوهر لا يتناقض مع التقدم بحال ، وهي حقيقة لا تتوقف أمام هذه الأمور الصغيرة ، ولعلي أعترف لك أيها القارئ أنني حزين أشد الحزن ، ومكلوم حقيقة لا مجازاً ، وأنا أشهد شبابنا وقد امتلأ رأسه بهذه الأمور التافهة ، وأشهد قادته من أصحاب الطموح ، ومدعى إحياء الإسلام ، وهم يرسخون فيه هذه الأسس ، بل ويتجاوزون ذلك إلى دعوته لترك العلوم ( الوضعية ) أو الأعمال ( العلمانية ) والتفرغ للعبادة .
هل هذا هو وجه الإسلام الحقيقي ، وهل هذا هو ما سنواجه به القرن الحادي والعشرين ، وهل هؤلاء الذين يسيئون قيادة أنفسهم وأتباعهم هم الصالحون لقيادة المجتمع ، وهل أقبل منهم أو تقبل منهم دعوتهم للدولة الدينية وهم لا يتمسكون من الدين إلا بالقشور ، ولا يعرفون من العقيدة إلا مظهرها الذي لا أصل له في كتاب الله ، ولا سند له إلا التأسي بالرسول في مسايرته لعصر غير عصرنا ، ولمجتمع يختلف جملة وتفصيلاً عن المجتمع الذي نعيشه ، وليتهم تأسوا به وهو يدعو للرحمة ، ويستنكر قتل المسلم للمسلم ، ويدعو لطلب العلم ولو في الصين ، ويستنكر اعتزال العمل للعبادة ، ويعدل في قسمته بين الدين والدنيا ، ويعلن حكمته الخالدة للأجيال التالية له ، ومضمونها أنهم أعلم بشئون دنياهم .
هؤلاء قوم كرهوا المجتمع فحق للمجتمع أن يبادلهم كرهاً بكره ، ولفظوه فحق له أن يلفظهم ، وأدانوه بالجاهلية فحق له أن يدينهم بالتعصب وانغلاق الذهن ، وخرجوا عليه فحق له أن يعاملهم بما اختاروه لأنفسهم ، معاملة الخارجين على الشريعة والقانون ، ووضعوا أنفسهم في موضع الأوصياء على الجميع ، وهم أولى الناس بأن يعاملوا معاملة المحجور عليهم ، وهم من قبل ومن بعد ، أساءوا للإسلام ذاته حين ادعوا عليه ما ليس فيه وأظهروا منه ما ينفر القلوب ، وأعلنوا باسمه ما يسئ إليه ، وأدانوه بالتعصب وهو دين السماحة ، واتهموه بالجمود وهو دين التطور ، ووصموه بالانغلاق وهو دين التفتح على العلم و العالم ، وعكسوا من أمراضهم النفسية عليه ما يرفضه كدين ، وما نرفضه كمسلمين .
هو الهروب لأنه أسهل من المواجهة ، وهو النكوص لأنه أهون من الإقدام ، وهي المظهرية لأنها أيسر من إدراك الجوهر ، وهم في مزايدتهم على المظاهر يغالون في المطالبة بالشريعة ، وهي مطالبة تتسق مع ما درجوا عليه واتسق تفكيرهم معه ، فتطبيق الشريعة في مجتمعنا الحالي ، على ما تركه السلف دون اجتهاد ومراجعة ، إنما تمثل مظهراً لا غناء فيه ، وظاهراً من الأمر لا جوهر له ، ومجرد إطار شكلي لا مضمون داخله ، أما الجوهر والإطار والمضمون فهو ما أشرت إليه من قواعد تنظم المجتمع على أساس لا تتناقض مع جوهر الدين في شئ ، ولا تصطدم مع معطيات العصر في إطارها العام ، وهو مطلب بالنسبة لهم عسير ، فهم مطالبون أولاً أن يروا العصر على حقيقته قبل أن ينظروا له ، وأن يعيشوه قبل أن يبرمجوه ، وأن يتفاعلوا معه قبل أن يخططوا مستقبله ، وهم في النهاية سحابة صيف لا أشك أنها إلى زوال ، وغيم داكن لا أحسب إلا أنه إلى انقشاع .
رابعا : إن أصحاب وجهة النظر الأولى ، وأقصد بهم الداعين إلى التطبيق الفوري للشريعة الإسلامية ، يضمرون عداء لا حد له للديموقراطية ، إما عن قصد نتيجة عدم إيمانهم بها كما أسلفت ، وإما عن حسن نية من الكثيرين الذين يدفعهم حماسهم للشريعة إلى المطالبة بإقرارها بعرضها على مجلس الشعب ، دون أن تناقش على نطاق شعبي واسع ، مع تلويحهم بسيف الخروج عن الدين لأعضاء المجلس ، إن هم رفضوا أو تأنوا أو ترددوا ويتجاوز البعض فيحالون القفز فوق المجلس ، متوجهين مباشرة إلى رئيس الجمهورية ، ومطالبين له بوضعها – هكذا – موضع التنفيذ الفوري الناجز .
ولأن الأمر كما أوضحت ليس أمر شريعة بل أمر اختيار بين الدولة الدينية والدولة المدنية ، وهو اختيار كما شرحت من قبل ، بين بديل واضح ومطبق وهو الدولة المدنية ، وبديل آخر لم يجهد أصحابه أذهانهم في بلورته وتوضيحه وهو الدولة الدينية ، فأنه من الصعب والأمر كذلك أن يقضى بشأن هذا الأمر في جلسة أو اثنتين ، أو في أسبوع أو اثنين ، بل إنني أتصور سبيلاً آخر لطرح هذا الأمر ومناقشته ، وهو سبيل أرى أنه الأوفق والأصح ، ليس فقط من وجهة نظري ، بل إنه لزوم ما يلزم بالنسبة لأمر هذا شأنه ، وتلك طبيعته ، ولعلي قبل أن أعرض تصوري في هذا الشأن ، أتسمع رأي المعارضين لقولي جملة وتفصيلاً ، وكأني بهم يقولون ، ها هو يلتوي بالكلم ، وينكر علينا حقاً يرضاه للآخرين ويطلبه لنفسه ، ويتصور الديموقراطية وفقاً على آرائه ونظرائه ، ولا يلتزم بالدستور الذي أقر أن تكون مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للقوانين ، ولا يلزم نفسه بإرادة الأمة التي أنشأت هذا التعديل ، وتمثلت في استفتاء شعبي أعطى التأييد الكامل له ، وهي كلها آراء جديرة بالبحث والمناقشة ، وتستحق بالفعل كثيراً من التوقف والتأمل .
أما عن الدستور فلا أحسب أنه قد جاء بجديد ، فأغلب القوانين القائمة مستمدة من مبادئ الشريعة الإسلامية ، مما يجعل منها المصدر الرئيسي للتشريع في مصر ، مع ملاحظة أرى أن إبداءها واجب ، وتتلخص في أن الدستور ليس كتاباً مقدساً ، وأنه يحق لأي مواطن أن يختلف مع بنوده أو أن يعترض عليها ، وله أيضاً أن يطالب بتعديلها ، على أن يسلك في هذا السبيل ما نظمه الدستور نفسه من سبل لتعديل مواده أو إلغائها أو الإضافة إليها ، بل أن أصحاب وجهة النظر الأولى يعترضون على الكثير من نصوص الدستور ، مثل النص على تعدد الأحزاب الأمر الذي يختلف عن اعتقادهم في قصرها على حزبين هما حزب الله وحزب الشيطان ، بل ويتجاوز أغلبهم تلك الجزئية إلى الاعتراض على ما يتعلق بنظام الحكم في الدستور جملة وتفصيلاً .
ما بالهم إذن يلقون الحجة وهي مردودة إليهم ، ويطلقون الرأي وهو مأخوذ عليهم ، ويستندون للدستور وهو غير مقبول منهم ..
وقريب من ذلك احتكامهم إلى الإستفتاء دليلاً على التأييد الشعبي ورفضهم الاعتراف بشرعية جميع الاستفتاءات التي حدثت منذ اختلفت معهم الثورة وحتى الآن ، عدا استفتاء واحد صادف هوى في نفوسهم ، ومس من قلوبهم الشغاف ، وحلق بهم في أحلام وردية وامتشقوه سلاحاً يخرسون به الألسنة ، ويذودون به عن أوهامهم حيناً وأحلامهم أحياناً .
هو الهوى حين يتسلط ، والغرض حين يستبد ، والمنطق حين يهرب ، والعقل حين تغشاه العاطفة ، والحجة حين يشوبها الضعف والكلام حين يحتوى خبيئاً ، معناه ليست لنا عقول .
ليس الدستور إذن هو السند ، و ليس الاستفتاء هو الحجة ، وإنما سبيلهم الوحيد كما أتصور ، أن يفعلوا ما فعله الآخرون ، وهو أن يتقدموا إلى الشعب ببرنامجهم السياسي ، وأن يشكلوا حزبهم أو أحزابهم ، فإن حازوا الأغلبية في انتخابات حرة فقد ألزمونا بالحجة الدامغة ، وأخرسونا بالفعل السديد ، و قد اخترت لفظ ( أخرسونا ) عن قصد لاعتقادي أنه سوف يكون واقعاً لا مراء فيه ، ففاقد الديموقراطية لا يعطيها ، لكنه إن توصل للحكم بإرادة الشعب كان له ما أراد .
هنا قد يحتج القارئ بأن القوانين الحالية لا تتيح لهم تشكيل أحزاب على أساس العقيدة الدينية ، وهو نص قانوني له وجاهته، لكون الأحزاب السياسية منبراً لكل المصريين مهما اختلفت عقائدهم ، لكني أحسب أن المناخ الرديء قد تجاوز ذلك وأن الإخوان المسلمين على سبيل المثال يملكون حزباً ، ومكتب إرشاد ، وصحفاً ومجلات حزبية وغير حزبية تدافع عنهم وتتبنى آراءهم بل ووصل الأمر إلى تواجد ممثلين لهم في المجلس النيابي بعد تحالف الوفد والإخوان المسلمين ، ذلك التحالف الذي يشبهه بعض الظرفاء بزواج المتعة الذي تعترف به بعض طوائف الشيعة وتنكره طوائف السنة .
هم موجودون إذن ، وهم توصلوا بالشرعية إلى تواجد شرعي ، وإنكار تواجدهم إخفاء للرؤوس في الرمال ، والسماح لهم ولغيرهم من التيارات السياسية الدينية بتشكيل أحزابهم له من المزايا ما لا يستهان به ، فسوف يلزمون بوضع برامج سياسية ، وسوف يدور الحوار معهم على أرض الواقع السياسي ، وسوف يكون حوار دنيا لا حوار دين وسوف يكون هدفهم كراسي الحكم لا قصور الجنة ، وسوف يحجم أئمة المساجد عن المزايدة على مقولاتهم لدخولهم آنذاك في دائرة العمل السياسي الصريح . وسوف تتحول الأحزاب السياسية إلى معارضتهم بدلاً من المزايدة عليهم ، وسوف يختلفون فيما بينهم بأكثر من اختلافهم مع الآخرين ، وسوف يواجهون بعضهم البعض بأكثر مما يواجهون الآخرين ، وسوف يتحاورون في ساحة ليست ساحتهم ، ويتكلمون لغة تصعب عليهم مفرادتها ناهيك عن قواعدها ، وفي كل هذا رحمة من الله أي رحمة ، ولطف بالوطن أي لطف ، ولا حجة هنا للقائلين بأن ذلك سوف يدعو إلى إنشاء أحزاب دينية قبطية ، وأنه سوف يمزق الوطن طائفياً ، فدرس التاريخ ينبئنا بأن ذلك غير وارد ، وإن ورد فلا تأثير له ، وغير بعيد عن الأذهان حزب أخنوخ فانوس ، الذي تكون وقضى دون أن يزيد عدد أفراده على الآحاد ، وغير بعيد تجربة الوفد حين استوعب الأغلبية الساحقة من أقباط مصر ، الذين تحتويهم دائماً راية العلمانية ، وتستهويهم شعاراتها ، وهو أمر ما زالت أسبابه قائمة ، وحديث ذلك يطول ، وهو في مجمله حديث يهون من أسباب التخوف ولا يدعمها ، ويؤكد ما أدعو إليه ولا ينفيه .
هذه هي وجهة النظر الثانية أيها القارئ ، أفضت فيها لكثرة ما أفاض أصحاب وجهة النظر الأولى في عرض آرائهم وتزيينها ، وأحسب بعد ذلك أنك إلى اختيار ، وأن التفكير الهادئ سوف يقودك إلى قرار ، بل إنني أحسب أنك توصلت بعد ما سبق إلى مجرد التردد فسوف أحمد الله ، ولعلك أدركت معي أنهم قد اختاروا الطريق السهل ، وأن اتباعهم إلى ما لا تعلم وما لا يعلمون أمر جلل ، وأن يجتهدوا قبل أن يجهدوا الآخرين بحلم لا غناء فيه ، وأن يفكروا قبل أن يكفروا ، وأن يواجهوا مشاكل المجتمع بالحل لا بالهجرة ، وأن يقتصدوا في دعوى الجاهلية حتى لا تقترن بالجهل ، وأن يعلموا أن الإسلام أعز من أن يهينوه بتصور المصادمة مع العصر ، وأن الوطن أعز من أن يهدموا وحدته بدعاوى التعصب ، وأن المستقبل يصنعه القلم لا السواك ، والعمل لا الاعتزال ، والعقل لا الدروشة ، والمنطق لا الرصاص ، والأهم من ذلك كله أن يدركوا حقيقة غائبة عنهم . وهي أنهم ليسوا وحدهم .. جماعة المسلمين .
قراءة جديدة في أوراق الراشدين
للقارئ أن يحزن ومن حقه أن يتعجب ، وهو يستعرض معنا ما عرضناه في الفصل الأول حول مصرع عثمان ، أما الحزن فأسبابه مفهومة ، وأما التعجب فأبوابه كثيرة ، إن سددت منها باباً وحسبت أنك استرحت ، انفتحت عليك أبواب ، وأثـقلتك هموم ، وحسبك أنك إن أدنت لا تدري من تدين ، فأنت إن أدنت الثائرين لا تملك أن تبرئ عثمان ، وأنت إن أدنت عثمان لا تملك أن تبرئ الثائرين ، وأنت إن أدنت الثائرين لا تملك إلا أن تتعاطف معهم في نوازعهم ، وأنت إن أدنت عثمان لا تملك إلا أن تتعاطف معه في مصرعه ، ولعلك بحكم العاطفة الدينية أقرب إلى إنصاف عثمان ، وإلى تلمس الأعذار له ، لكنك تصطدم في سبيلك هذا بأقوال كبار الصحابة وأفعالهم ودعوة بعضهم الصريحة إلى حمل السيف والخروج عليه ، فهذا عبد الرحمن بن عوف يقول لعلي: إن شئت أخذت سيفك وأخذ سيفي ، فقد خالف ما أعطاني ثم يقول لبعض في المرض الذي مات فيه : عالجوه قبل أن يطغي ملكه وهذا طلحة في المرض يؤلب الثائرين حتى لا يجد علي مفراً من أن يفتح بيت المال ، ويوزع من أمواله عليهم حتى يتفرقوا ، ويقره عثمان على ما فعل ، ولن تمر شهور حتى يقتل عثمان ، وحتى يخرج طلحة نفسه مطالباً بالثأر له في جيش عائشة ، وحتى يصاب بسهم رماه به مروان بن الحكم ، صفى عثمان وساعده الأيمن ، وخليفة المسلمين بعد ذلك بثلاثين عاماً ، ورفيق طلحة في الجيش الثائر من أجل الثأر ، وساعتها سوف يدرك طلحة أنها النهاية ، فيردد في لحظات الصدق مع النفس ومع الله ، هذا سهم رماني به الله ، اللهم خذ لعثمان منى حتى ترضى ، وهو قول بالغ الدلالة على صحوة الضمير ، وتيقن الخطأ ، ولم يكن طلحة في هذا مبتدعاً ، وإنما كان مسايراً لفعل أصحابه ، وهم أنفسهم صحابة الرسول ، غاية ما في الأمر أنه كان أكثر تطرفاً ، فأهلك وهلك ، أما علي والزبير وابن مسعود وعمار وغيرهم ، فقد تراوحوا في معارضتهم بين العنف واللين ، وانتهوا ما انتهى إليه طلحة ، حين هلك بعضهم معه ، وتأخر البعض إلى حين .
حدث ما حدث ، وقتل المسلمون بسيوف المسلمين ، وهلك الصحابة بسيوف الصحابة ، وبقيت دلالات الحوداث تؤرق أذهاننا حتى اليوم ، واختلف الفقهاء حتى يومنا هذا مع ما لم يتمن أحد أن يناقش ، ناهيك عن أن يحدث ، وهو ( شرعة قتال أهل القبلة ) ، أي مشروعية قتال المسلمين للمسلمين ، ويحلو للبعض أن ينسب نشأة هذه الظاهرة إلى أوائل عهد علي ، لكنا نعود بها إلى عهد أبي بكر ، حين نتوقف أمام حروب الردة متأملين مفرقين بين قتال أبي بكر للمرتدين عن الإسلام ، وبين قتاله للممتنعين عن دفع الزكاة له أو لبيت المال ، ولنا في التفرقة بين الفريقين منطق بسيط ، يسلم بارتداد الفريق الأول ، ويتحرز في وصف الفريق الثاني بالردة ، فقد كانوا ينطقون بالشهادتين ، ويؤدون جميعا دون إنكار ، ويؤدون الزكاة نفسها لكن للمحتاج وليس للخليفة أو لبيت المال ، وكانت حجتهم في ذلك الآية الكريمة ( خذ من أموالهم ) ، منصرفة إلى الرسول ، موجهة إليه ، ولا يجوز أن تنصرف لغيره ، لأنها لم توجه إلى غيره ، حتى لو كان هذا الغير خليفة الرسول ، ولعلنا ونحن نتأمل ونفرق ، وربما نتعاطف ، نستحضر في أذهاننا موقف عمر من أبي بكر ، وهو يسائله عن حجته في قتل من ينطق بالشهادتين ، فيجيبه أبو بكر بما يعنى أن للشهادة ( حقها ) ، يقصد بهذا الحق أداء الزكاة لبيت المال ، وهو اجتهاد مجهد وجهيد ، ولعل عمر كان يستحضر في ذهنه وهو يحاور أبا بكر حديث الرسول عن أن المسلم لا يقتل إلا لثلاث ، إن زنى بعد إحصان ، أو أرتد بعد إيمان ، أو قصاصاً لقتل النفس بغير حق ، ولعله كان يرى أن نفى الإيمان عن ناطق الشهادتين ، مؤدى الصلاة ، صائم رمضان ، حاج البيت أن استطاع لذلك سبيلاً ، مؤدى الزكاة إلى المحتاج دون وساطة ، أمر أن لم يتسع له الإنكار ، ونظنه يتسع له ، فلا بد أن يضيق به باب القبول أي ضيق ، ولعلنا إلى مثل ذلك الضيق أقرب ، بل لعلنا منكرون كل الإنكار ، لسبب يتصل بنا أكثر مما يتصل بعمر أو بأبي بكر . فنحن نفعل ما فعله أولئك القوم تماماً ، وندفع الزكاة للمحتاج كما كانوا يدفعونها تماماً ، ولا ندفعها مثلاً لوزارة الخزانة أو لرئيس الجمهورية ، وإن جاز لأبي بكر قتالهم وقتلهم ، فإنه يجوز للبعض أن يخرجوا علينا مقاتلين وقاتلين ، لا يشفع لنا عندهم أن نرفع عقيرتنا بالنطق بالشهادتين ، ولا أن نقسم على أننا ملتزمون بأركان الدين ملزمون لأنفسنا بها ، ولولا أننا لم نجد في ديننا عصمة لغير النبي ، ولولا أيضاً أننا نرى أن اجتهاد أبي بكر من يليه ، وإلا لسلك جميع جمع الخلفاء سبيله في تولية من يليه ، بالنص على اسمه في كتاب مغلق يبايعون عليه مغلقاً ، وهو ما لم يأخذ به أحد بعده ، لولا هذا كله ، ولولا إيماننا بأن الإسلام حق ، والقرآن حق ، ونبوة الأنبياء حق ، وبشرية غيرهم حق ، ما تناولنا ما أوردناه . و ما استطردنا فذكرنا أن أبا بكر كان على حق ، إذا ناقشنا الأمر من باب آخر هو باب السياسة . فلولا ما فعل ما أصبح للإسلام دولة ثابتة الأركان ، متينة البينان ، تفتح البلدان ، وتنشر العقيدة وتثبت دعائمها ، ولقد اجتهد أبو بكر في السياسة فأصاب دون شك ، واجتهد في الدين فأصاب أجرين في رأيه ، وأجراً واحداً في رأينا ، وربما أثبت لمن يرونه أصاب أجراً واحداً أن السياسة قد تتناقض مع قواعد الدين وأصوله ، تلك المحفوظة لنا تماماً كما وجدها ، وكما نجدها قرآناً وسنة . وما كان اجتهادنا إلا اجتهاداً وما كان لأحد أن يزعم أن اجتهاد أبي بكر أصل من أصول العقيدة أو ركيزة من ركائز الإيمان ، وما كان لنا أن نؤيد ما قد يراه من أن قرار أبي بكر كان سياسياً وليس دينيا ، وبمعنى آخر كان علمانياً يفصل بين السياسة والدين ، فنحن لا نود أن نرد على تعسف في الاجتهاد بتعسف في الإستنتاج ، ولعل فيما ذكرناه ونذكره الكفاية لاستنزال اللعنات علينا ممن يرون في أسماء الصحابة قدساً من الأقداس ، وفي أفعالهم طوطماً لا يمس ، وحسبنا أن نذكرهم بحديث الرسول الكريم ، عن أن عمار بن ياسر سوف تقتله الفئة الباغية ، وهو حديث ثابت وصحيح ، لأن الجميع تذكره حين قتل عمار ، تذكره جيش علي فتهلل ، وتذكره جيش معاوية فتزلزل ، ولم يهدئ روعه إلا رد معاوية المحنك " قتله من أخرجه " . غير أنا نرى الأمر بعد هذه السنوات عظيماً وجليلاً وذا خطر ، ونقرأه بعد كل هذه السنوات فنتزلزل ، فإحدى الفئتين باغية لا شك ، ولو سلمنا بظاهر الحديث لحكمنا عل جيش معاوية بالبغى ، ولأصبح معاوية باغياً وعمرو بن العاص باغياً ، ومروان بن الحكم باغياً ، وعبيد الله بن عمر باغياً ، وغيرهم وغيرهم . ولو سلمنا بتفسير معاوية لأصبح البغاة فريقاً من كبار الصالحين لا نجرؤ على ذكر أسمائهم مقترنة بالبغى ، وإذا كنا قد توقفنا عند مقابلة اجتهاد أبي بكر باجتهاد مقابل ، فإن بعضاً من كبار الصالحين مثل واصل بن عطاء ، فقيه المعتزلة وإمامهم ، وعمرو بن عبيد ، الزاهد الورع ، الذي وصفه الخليفة المنصور بقوله الشهير ( كلكم يطلب صيد . غير عمرو بن عبيد ) ، كانا أجرأ منا حين أطلقا لعقولهم العنان ، وهما من هما ، تديناً وفقهاً وعلماً ، فأنكرا فعل الفريقين في أصحاب الجمل ، وأصحاب صفين ، وذكرا أنه " لا تجوز قبول شهادة علي وطلحة والزبير على باقة بقل ( كل نبات اخضرت له الأرض ) " ، وأوضح من قول واصل وعمرو ، قول عبد الله بن عباس لعبد الله بن الزبير ( لو كان جيش الإمام على حق فقد كفر الزبير بقتاله ، ولو كان جيش عائشة على حق فقد كفر الزبير بتخليه عنه ) . وهي أقوال لا نفحصها ولا نمحصها ، وإنما نذكرها متأملين ، مقارنين عصراً بعصر ، ومناخاً بمناخ ، وفكراً بفكر ، وحسبنا أننا لا نتجاوز الاجتهاد في تفسير الوقائع ، بينما اجتهد عمر بن الخطاب فيما هو أجـّل وأعظم ، مخالفاً ما نعرفه ونلتزم به من أنه لا اجتهاد في النص ، أو لا اجتهاد مع وجود نص ، ولم يكن اجتهاده قاصراً على التفسير أو التعديل ، بل امتد إلى التعطيل والمخالفة ، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة اجتهاده ، ولعلنا لا نعرف نظيراً لعمر كرجل دين ورجل دولة على مدى التاريخ الإسلامي كله ، فهو القاسي على نفسه في الحق ، ومن هنا قبلت الرعية قسوته ، ثقة منها أنه على حق ، وهو الزاهد في الدنيا زهداً لم يعرفه حاكم قبله أو بعده ومن هنا قبل الجميع أن يحاسبهم ، وأن يتحرى عن كسبهم ، وأن يأخذ منهم ما يفيض عن حاجتهم ، وأن يعنف عليهم أشد العنف ، إن رأي فيهم أهون الميل للهوى ، أو الهوى للميل ، وهو الذي يخطئ فيتعلم من الخطأ ولا تأخذه العزة بالإثم . فها هو يولى عمار بن ياسر على الكوفة ، ثم لا يلبث أن يتبين أن صلاح الدين لا يعنى بالضرورة صلاح الدنيا ، وأن للحكم ميدانه وللسياسة فرسانها ، وليس بالضرورة أن يكونوا رجال الدين وفرسانه ، فيعزل عمار ، ويولى أمثال المغيرة بن شعبة ويزيد بن أبي سفيان ومعاوية بن أبي سفيان ، ويرفض أن يولى أباذر معلناً أمامه أن به ضعفاً ، وأن الضعيف لا يولى مهما ارتفع في سلم العقيدة درجات ، فهذه ساحة وتلك ساحة ، إن اجتمعتا – ونادراً ما تجتمعان – فهو الكمال ، وإن افترقتا – وغالباً ما تفترقان – فلكل ساحة رجالها ، ولكل ميدان فرسانه ، فرجال السياسة أجدر بالحكم ، ورجال الدين أحفظ للعقيدة ، غير أن أعظم ما تركه عمر لنا ، هو ذاته أكثر ما تجنبه اللاحقون ، وما ارتعدوا عند ذكره ، ناهيك عن الإقدام عليه ، ونقصد به الاجتهاد ، ذلك الذي بدأنا حديث عمر بذكره وما تميز عمر فيه عن الجميع ، حين اجتهد -كما ذكرنا – مع وجود النص القرآني ، وبالمخالفة له ، وقدم في تبرير ذلك حجة رائعة ، ما أجدر المنغلقين في زماننا أن يقفوا أمامها بالتأمل طويلاً ، وما أجدرنا بأن نذكرها لهم تفصيلاً ، عسى أن تتسع لها قلوبهم ، ويتعلموا منها أن العقل قد يسبق النقل ، وأن التفكير لا بد وأن يسبق التكفير ، ولعلنا نسائلهم مداعبين قبل أن نعرض عليهم ما نعرض ، ما حكمكم إذا ذكرنا لكم دون تخصيص أو تفصيل أن حاكماً مسلماً ، لدولة مسلمة ، قد أفتى بمخالفة نص قرآني مع علمه به ، وطبق قاعدة مختلفة معه ومخالفة له ، وأفتى بجواز مخالفة النص ذاكراً أن واقع الحياة قد تجاوزه ، وأن المنطق لم يعد يستقيم معه ، ولعلنا متصورون ، بل ومتأكدون من الإجابة ، ولعلنا أيضاً هاتفون بهم حنانيكم ، تمهلوا قليلاً ، وتحسبوا كثيراً ، فنحن نتحدث عن عمر بن الخطاب ، وهاكم النموذج كما يسرده عالم جليل ، في كتاب من أهم وأرقى ما كتب في السنوات الأخيرة . أما العالم فهو الدكتور عبد المنعم النمر وأما الكتاب فعنوانه ( الاجتهاد ) وأما القاعدة التي نتحدث عنها فهي خاصة بسهم المؤلفة قلوبهم وهاكم ما كتبه الدكتور النمر: ( سهم المؤلفة قلوبهم وهو سهم قد نص عليه القرآن ما كتبه القرآن الكريم في آية توزيع الزكاة " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم " التوبة / 60 وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعطيهم – وهم كفار – أو ليسوا على إسلام صحيح صادق بل متأرجحين ، ليتألف بالعطاء قلوبهم – وطالما استعبد الإنسان إحسان – فيكفوا عن المسلمين شرهم ، وليكسب ودهم أو لسانهم ، وربما حبهم وإسلامهم ، يروى سعيد بن المسيب عن صفوان بن أمية قال : " أعطاني رسول الله وإنه لأبغض الناس إليّ ، فما زال يعطيني حتى أنه لأحب الخلق إلى ". وسار أبو بكر رضى الله عنه في خلافته على ما سار عليه الرسول ، حتى جاءه عيينة بن حصن ، والأقرع بن حابس ، فسألا أبا بكر : يا خليفة رسول الله إن عندنا أرضاً سبخه ليس فيها كلأ ، ولا منفعة ، فإن رأيت أن تعطيناها ؟ فأقطعهما أبو بكر إياها ، على أنهما من المؤلفة قلوبهم ، وكتب لهما كتاباً بذلك ، وأشهد عليه ، ولم يكن عمر حاضراً ، فذهب إلى عمر ليشهد ، فعارض عمر ذلك بشدة ، ومحا الكتابة . . فتذمرا وقالا مقالة سيئة ، قال لهما : " إن رسول الله كان يتألفكما ، والإسلام يومئذ قليل ، وإن الله قد أغنى الإسلام . اذهبا فاجهدا جهدكم لا يرعى الله عليكما إن رعيتما " .
والشاهد هنا ، أن عمر أوقف حكماً كان مستقراً في أيام الرسول ، وجزء من خلافة أبي بكر ، بناء على اجتهاد له ، في سبب إعطاء هؤلاء حيث اعتبر أن السبب الآن غير قائم ، فلا داعي للإعطاء ، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ، كما عرفنا فعمر رضى الله عنه ، لم يقف جامداًً عند حدود النص وظاهره ولا حدود الفعل ، بل غاص إلى سببه وعلته ، وحكم اجتهاداً منه في فهم الحكم ، على ضوء ظروف الإسلام ، حين صار قوياً في غير حاجة إلى تأليف قلوب هؤلاء ..
كلام منطقي ، وواضح ، وصريح ، يترتب عليه سؤال منطقي ، وواضح ، وصريح أيضاً ، مضمونه : هل يجوز لنا أن نتأسى بعمر فنعطل نصاً ، أو نجتهد مع وجوده ، ويصل بنا الاجتهاد إلى مخالفته ، إذا انعدمت علته أو تغيرت أسبابه ؟
سؤال صعب ، وإجابته خطيرة ، وتداعيات إجابته أخطر ، ليس على الإسلام ، بل على قلوب عليها أقفالها ، وعقول تعرف الضبة وتنكر المفتاح ، غير أنا نلمح في أذهانهم طوق نجاة ، قد يتشبثون به ، وهو قولهم بأن ذلك قد يجوز ، إن تشابهت الحالة أو تماثلت مع ما سبق دون أن ينصرف ذلك إلى قواعد الدين وتعاليمه الواضحة ، مثل الحدود الثابتة بيقين في نصوص القرآن ، ولعلنا بهذا القول نتفاءل كثيراًَ ، ونتوقع منهم ما لا نعرفه عنهم قياساً على تجربة سابقة لنا معهم ، لكن ما ضرنا إن تفاءلنا ، وما خسراننا إن أحسنا الظن ، وما أجدرنا بأن نسحب منهم طوق النجاة ، وأن نحيلهم في ردنا عليهم إلى مثال آخر لاجتهاد عمر ، عطل فيه حداً من الحدود الثابتة ، وهو حد السرقة ، إذا كان السارق محتاجاً ، ثم أوقف تنفيذه في عام المجاعة ، وجدير بنا قبل عرض هذا الاجتهاد ، أن نرد على بعض من ادعوا التفقه ، وأزعجهم اجتهاد عمر ، فأفتوا بما يخالف الحقيقة ، ظناً منهم أن أحداً لا يقرأ ، أو أن الغاية تبرر الوسيلة . ومثال ذلك ما ذكره الأستاذ الحمزة دعبس في حواره مع وزير مغربي ، وهو حوار منشور في جريدة النور ، التي يرأس الأستاذ الحمزة تحريرها ، حين سأل الحمزة الوزير ، محاولاً إحراجه ، عن سبب عدم تطبيق الحدود الشرعية في المغرب ، فكان رد الوزير أن تعطيل الحد اجتهاد ، وأن لذلك سابقة تتمثل في تعطيل عمر لحد السرقة في عام المجاعة ، فرد عليه الأستاذ الحمزة على الفور ، بلغة الواثق من علمه ، " إن عمر لم يطبق حد السرقة ، لأن المبلغ المسروق كان أقل من النصاب " ، والحقيقة أن الواقعة التي عطل فيها عمر الحد ، والتي وردت في " الموطأ " للإمام مالك ، كانت تتعلق بسرقة ناقة ، وهي ما يفوق النصاب كثيراً ، بل ما يتناوله البسطاء في أحاديثهم عندما يتندرون فيقولون : إن سرقت فاسرق جملاً ، دلالة على ضخامة حجم السرقة وجسامته .
والمثال الثاني ما يتردد كثيراً على ألسنة بعض الفقهاء ، وفي مقالات بعض الكتاب ممن يسمون أنفسهم بالإسلاميين من أن عمر لم يعطل الحد ، بل أقام شروطه ، لأن من هذه الشروط توفير الحد الأدنى للمعيشة والمعاش ، وردنا على ذلك يسير ، ورأينا فيه أنه مغالطة واضحة ، لأن جميع ما توافر أمام عمر وقت أن أجتهد ، لم يكن يزيد عن أمرين : * أولهما : نص قرآني صريح واضح قاطع بقطع اليد في السرقة دون ذكر لأية شروط . * وثانيهما : سنة قولية وفعلية نقلتها لنا كتب الأحاديث الصحاح وراجعناها جميعاً فلم نجد إلا اختلافاً حول تحديد النصاب أي الحد الأدنى لقيمة ما يسرق ، فتقطع اليد في مقابله ، ولعلنا نضيف إلى علمهم تصحيحاً ، وإلى معلوماتهم تصحيفاً ، فنذكر لهم أن ما اختلط في أذهانهم ، هو الشروط التي ذكرها الفقهاء بعد عمر بحوالي قرن أو قرنين ، وهي شروط عديدة تمثل اجتهاداً منهم لمسايرة ما واجهوه من ظروف الحياة وهي متغيرة ، بنصوص الشريعة وهي ثابتة ، وكل ذلك أتى بعد عمر بكثير ولم يكن عمر في اجتهاده مقتفياً أثر الشافعي أو أبى حنيفة ، وإنما كان العكس هو الصحيح ، وكان اجتهاد عمر في هذه الواقعة هو الذي فتح باب الاجتهاد لهم ، وهو الذي قنن لهم شرطاً فأضافوا شروطاً ، ولنقرأ معاً ما أورده الدكتور النمر في كتابه ( الاجتهاد ) بشأن هذا الاجتهاد من عمر : ( عدم إقامة الحد على السارق : وهذا اجتهاداً جديد في إقامة الحد ، اجتهد عمر في ألا يقيمه بعد ثبوت السرقة على السارقين .. ووجوب الحد عليهم ، في الحضر لا في السفر ، ولا في الغزو .
فقد روى مالك في الموطأ ، أن رقيقا لحاطب بن أبي بلتعة سرقوا ناقة لرجل من مزينة ، فانتحروها ، فأمر عمر بقطع أيديهم ، ثم أوقف القطع ، وفكر في أن يعرف السبب الذي من أجله سرق هؤلاء فلعلهم جياع ، وجاء حاطب فقال له عمر ، إنكم تستعملونهم ، وتجيعونهم والله لأغرمنك غرامة توجعك ، وفرض عليه ضعف ثمنها ، وأعفى السارقين من القطع لحاجتهم ..
ولم يقف عمر بهذا عند ظاهر النص جامداً ، بل غاص إلى ما وراءه ، ووجد أنه لا يقام حين يكون السارق في حاجة تلجئه إلى السرقة ، كما قال لحاطب : " لولا أنكم تستعملونهم و تجيعونهم ، حتى لو وجدوا ما حرم الله لأكلوه ، لقطعتهم " .
وعمر بهذا وضع أساساً لعدم تطبيق الحد على المحتاجين الذين تحدث عنهم ، وهي وجهة نظر جديدة في تطبيق الآية : " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا ، نكالاً من الله . . " المائدة / 38 راعى فيها عمر علة القطع وظروفه ، ودار مع العلة ، وإن أدى ذلك إلى تخصيص النص أو ترك ظاهره – كما قال المرحوم الدكتور محمد يوسف موسى ، وهذه النظرة هي التي حملته على إيقاف حد السرقة أيضاً عام المجاعة ، كما حملته على إيقاف الحدود في السفر مثل ما فعل حذيفة أيضا فأوقف الحد على شارب الخمر ، وقال : " تحدون أميركم وقد دنوتم من عدوكم فيطعمون فيكم ؟ " . وقد أصدر عمر أمره إلى قواده ألا يجلدوا أحداً حتى يطلعوا من الدرب راجعين ، وكره أن تحمل المحدود حمية الشيطان على اللحوق بالكفار ، وهو لم يوقف الحد وإنما أجله لظروف ، حتى تزول هذه الظروف ، وهذه كلها اجتهادات لأحكام جديدة ، لم تكن قبل ذلك .. وفيها ظاهرة مخالفة لما كان في أيام الرسول وأبي بكر ) .
وهكذا يتضح لنا أن عمر قد اجتهد فألغى سهم المؤلفة قلوبهم مخالفة للنص القرآني ، وأوقف حد السرقة على المحتاج ، ثم عطله في عام المجاعة ، وعطل التعزير بالجلد في شرب الخمر في الحروب ، ونضيف إلى ذلك أنه خالف السنة في تقسيم الغنائم فلم يوزع الأرض الخصبة على الفاتحين ، وقتل الجماعة بالواحد مخالفاً قاعدة المساواة في القصاص ، ولا نملك ونحن نستعرض ما فعل ، في ضوء الملابسات المحيطة بكل حادثة ، إلا أن نكتشف حقيقتين هامتين : أولاهما أنه استخدم عقله في التحليل والتعليل ، ولم يقف عند ظاهر النص . وثانيهما أنه طبق روح الإسلام وجوهره مدركاً أن العدل غاية النص ، وأن مخالفة النص من أجل العدل ، أصح في ميزان الإسلام الصحيح من مجافاة العدل بالتزام النص ، وهذه الروح العظيمة في التطبيق ، تخالف أشد المخالفة روح القسوة فيمن نراهم ونسمع عنهم ، وتتـناقض مع منهجهم المتزمت ، وتوقفهم أمام ظاهر النص لا جوهره ، ونكاد نجزم أنهم لو عاشوا في زمن عمر ، لاتهموه بالمخالفة لمعلوم من الدين بالضرورة ، ولقاعدة شرعية لا لبس فيها ولا غموض ، ولحد من حدود الله لا شبهة في وجوب إقامته ولرفعوا عقيرتهم في مواجهته بالآيات التي لا يملون تكرارها ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) ، ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ) ، دون توقف أمام أسباب التنزيل ، أو حكمة النص أو العقوبة ، ولعلهم يدركون أن التأسي بعمر وارد ، وأن الباب الذي فتحه باجتهاده يتسع لكثير مما نراه ونقبله ، ويرونه فينكرونه ، ويسمح لنا بأن نوجه إليهم سؤالاً محدداً وواضحاً : هل تعطيل إقامة الحد جائز ، وهل مخالفة النص القرآني جائزة ، وهل مخالفة السنة الثابتة ، قولية كانت أم فعلية جائزة ؟ ولعلهم أمام ثلاث إجابات لا رابع لها : - أولها : أن الحكم بالجواز على إطلاقه لا يجوز ونحن نوافقهم على ذلك . - وثانيها : أن الحكم بإنكار الجواز على إطلاقه لا يجوز و نحن نسلم معهم بذلك ، وحجتنا عليه اجتهاد عمر . - وثالثها : أن الحكم بالجواز جائز في بعض الحالات ، وللضرورة ، ولأسباب منطقية وواضحة ، تتسق مع روح النص وعلته .. وفي هذا مساحة واسعة لنقاش طويل ، وأخذ ورد ، وحجة وحجة ، واجتهاد واجتهاد ، دون رمى لقفاز التكفير في الوجوه ، ودون ادعاء باطل بأنهم المسلمون ، وأننا الكافرون الظالمون الفاسقون ، وأن ما في مخيلتهم وحدهم هو الإسلام ، وأن ما في حياتنا كله هو الجاهلية بعينها ، غاية ما في الأمر أنها جاهلية معاصرة إلى غير ذلك مما يرونه حقاً ونراه باطلاً ، ويرونه علماً بالفقه ونراه جهلاً بالفقه وبالتاريخ ، ويرونه إيماناً ونراه تعصباً مقيتاً .
ولعلنا لا نتجاوز سيرة عمر ، دون أن نتوقف أمام قرار خطير وجليل ، ربما مر على البعض دون أن يعيروه التفاتاً ، بينما هو في رأينا مفتاح لتفسير ما بدأنا به الحديث ، وهو الفتنة الكبرى التي حدثت في عهد عثمان ، وانتهت بمصرعه ، واستمرت طوال عهد علي وانتهت بمصرعه أيضاً .
لقد ألزم عمر كبار الصحابة بالبقاء في المدينة ، وحظر عليهم مغادرتها إلا بإذنه ، وفسر ذلك لهم في رفق بأنه يحب أن يستأنس بهم ، ويهتدي بمشورتهم ، بينما حقيقة الأمر أنه خشى أن يفتتن الناس بهم ، وأن يفتتنوا هم أنفسهم بالناس ، وبما يفتن الناس ، وأجرى عليهم أرزاقاً محددة ومحدودة ، ألزمهم بها ، وألزم نفسه بها قبلهم ، فقبلوها منه ، مثلما قبلوا مجمل سيرته ، التي لا تأتي إلا منه ، ولعلهم ضاقوا بذلك أشد الضيق ، وكرهوه غاية الكره ، فهم في النهاية بشر يكرهون أن يمنعوا ما هو متاح للآخرين ، لكن ضيقهم من عمر ، كان يصطدم بسيرة عمر مع نفسه ، ومع أهله وخاصته ، فيستحيل الضيق رضا ، والتبرم صمتاً ، والكراهية صبراً جميلاً . ولعلنا في تخيلنا للكراهية أو التبرم أو الضيق لم نتجاوز الحقيقة ، ولم نحلق في الخيال ، دليلنا على ذلك أن أول ما فعله عثمان غداة ولايته ، أن أطلق الصحابة يذهبون حيث شاءوا وزاد على ذلك بأن أجزل لهم العطايا ، وذلك أمر يتفق مع طبيعة عثمان وما جبل عليه من لين ورقة وكرم وتسامح ، ولم تكن عطايا عثمان هينة أو محدودة ، فقد أعطى الزبير ستمائة ألف وأعطى طلحة مائة ألف . ولعله كان يتألف قلوبهم ، لعلمه أن اجتهاداته قد تختلف مع اجتهاداتهم ، وأنه مقدم على أمور لن تكون منهم محل قبول ، ومن صالحه أن يذهبوا في الآفاق ، وأن يكون قبولهم لعطاياه مانعاً لهم من الثورة أو حتى الغضب ، حين يعلمون أنه وهب ابنه الحارث مثلها ، أو أنه اقطع القطائع الكثيرة في الأمصار لبنى أمية ، غير أنهم لم يأبهوا لشيء من هذا في أول الأمر ، فقد خرجوا إلى الأمصار ، وإذا بالدنيا تقبل عليهم إقبالاً لم يخطر لهم على بال أو خيال ، وأقبلوا هم أيضاً على الدنيا . وحين تقبل الدنيا دون حدود ، فلابد أن تـُدبـِر العقيدة ولو بقدر محدود ، أما كيف أقبلت هذه ، وكيف أدبرت تلك ، فتعال معي وتأمل ، وتدبر معي : ثروات خمسة من كبار الصحابة أسماؤهم لوامع بل إن شئت الدقة أسماؤهم اللوامع ، فهم جميعاً مبشرون بالجنة وهم من الستة الذين حصر فيهم عمر الخلافة ، وأحدهم هو الخليفة المختار ، وهم عثمان بن عفان ، والزبير بن العوام ، وسعد بن أبي وقاص ، وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف ، ننقلها إليك من كتاب موثوق به هو ( الطبقات الكبرى لابن سعد )
. يقول ابن سعد بسنده : ( كان لعثمان ابن عفان عند خازنه يوم قتل ثلاثون ألف ألف ( الألف ألف هي المليون ) درهم و خمسمائة ألف درهم وخمسون ومائة ألف دينار ( الدرهم عملة فارس والدينار عملة الروم ) فانتهبت وذهبت ، وترك ألف بعير بالربذة وترك صدقات كان تصدق بها ببر أديس وخيبر ووادي القرى قيمة مائتى ألف دينار ) .
- - ( كانت قيمة ما ترك الزبير واحد وخمسين أو اثنين وخمسين ألف ألف . وكان للزبير بمصر خطط وبالإسكندرية خطط وبالكوفة خطط وبالبصرة دور وكانت له غلات تقدم عليه من أعراض المدينة )
- - ( عن عائشة بنت سعد ابن أبي وقاص : مات أبي رحمه الله في قصره بالعتيق
- على عشرة أميال من المدينة ، وترك يوم مات مائتى ألف وخمسين ألف درهم )
- - ( كانت قيمة ما ترك طلحة بن عبيد الله من العقار والأموال وما ترك من الناض
- ثلاثين ألف درهم ، ترك من العين ألفى ألف ومائتى ألف دينار ، والباقي عروض )
- - (
- ترك عبد الرحمن بن عوف ألف بعير وثلاثة آلاف شاة بالبقيع ومائة فرس
- ترعى بالبقيع ، وكان يزرع بالجرف على عشرين ناضحاً ، وكان فيما ترك ذهب قطع بالفؤوس حتى مجلت أيدي الرجال منه وترك أربع نسوة فأخرجت امرأة من ثمنها بثمانين ألفاً )
و قد ذكر المسعودى تقديرات مقاربة لما سبق من ثروات مع اختلاف في التفاصيل ، واستند طه حسين في كتابه الفتنة الكبرى لتقديرات ابن سعد ، وذكر ابن كثير أن ثروة الزبير قد بلغت سبعة وخمسين مليونا وأن أموال طلحة بلغت ألف درهم كل يوم .
ولعل القارئ قد تململ كثيرا ، وهو يستعرض ضخامة ما تركه كبار الصحابة من ثروات ، ولعله انزعج كما انزعجنا لحديث الملايين ولعله أيضاً يتلمس مهرباً بتصور أن الدراهم والدنانير لم تكن ذات قيمة كبيرة في عصرها ، لكنى أستأذنه أن يراجع نفسه . فابن عوف توفى بعد عمر بن الخطاب بثمانى سنوات ، والزبير وطلحة توفيا بعد عمر بثلاث عشرة سنة ، وأقصى ما يفعله التضخم ( بلغة عصرنا الحديث ) في تلك الفترة القصيرة ، أن يهبط بقيمة النقد إلى النصف مثلاً ، ويحكى المسعودى عن عمر أنه : ( حج فانفق في ذهابه ومجيئه إلى المدينة ستة عشر ديناراً فقال لولده عبد الله : لقد أسرفنا في نفقتنا في سفرنا هذا ) ، وإذا كانت الستة عشر ديناراً قد كفت عمراً وولده ، أو كفت عمراً وحده ، شهراً كاملاً ، فلنا أن نتخيل ما تفعله عشرات الملايين ، وما يملكه صاحب الذهب الذي يقصر جهد الرجال عن قطعة ( بالفؤوس ) . ولنا أن نسوق مثالاً أوضح من المثال السابق ، عن سادس الستة الذين رشحهم عمر ، ونقصد به علياً ، الذي توفى بعد طلحة والزبير بأربعة أعوام ونصف ، وبعد ابن عوف بحوالي عشر أعوام ، وهاكم ما تركه في رواية المسعودى : ( لم يترك صفراء ولا بيضاء ، إلا سبعمائة درهم بقيت من عطائه ، أرد أن يشتري بها خادماً لأهله ، وقال بعضهم : ترك لأهله مائتين وخمسين درهما ومصحفه وسيفه ) . نحن هنا أمام نموذج ونماذج ، ومثال وأمثلة ، وتركة وتركات ، وأمام مؤشر خطير لما حدث للمسلمين ، وأمام نذير خطير لما سيحدث لهم ، فالدين والدنيا لا يجتمعان معاً إلا بشق الأنفس ، وجمع المال على هذا النحو لا يستقيم مع نقاء الإيمان وصفاء السريرة إلا بجهد مجهد وجهيد ، وقول الرسول عن ابن عوف أنه يدخل الجنة حبواً يطرق الأذهان في عنف ، فغنى عبد الرحمن وثروته يثقلان خطوه إلى الجنة ، ولا لوم ولا تثريب على المسلم إن أثرى كما يشاء ، وأدى حق الله في ماله كما يحب ، لكن ميزان كبار الصحابة ليس كميزان غيرهم ، فهم أثقل من غيرهم بالزهد ، وأجدر من غيرهم بالخصاصة ، وقد عهدناهم حين هاجروا من مكة قبل ذلك بسنوات لا يملكون غير ملابسهم ، ويبيتون على الطوى سجداً خاشعين ، وكانوا في الميزان أغنى الأغنياء ، لكن الزمن قد دار إلى غير عودة ، وما ضر المقبل على الثروة أن يقبل على الحكم ، فهما وجهان لعملة واحدة هي الدنيا المقبلة ، وسوف يأتي على خليفة بعد عثمان ، وسوف يكون الخليفة الحق في الزمان الخطأ ، وسوف يحدث له ما حدث ، لأنه لابد أن يحدث ، غاية ما في الأمر أنه كانت هناك جذوة من العقيدة ما زالت مشتعلة ، أبقت حكمه قرابة الخمس سنوات ، ولم يكن له أن يتساءل مستنكراً : أعصى و يطاع معاوية ؟ فالتساؤل على مرارته مجاب عليه : نعم يا أبا الحسن ، تعصى لأنك على دين ، ويطاع معاوية لأنه على دنيا ، فكما تكونوا يول عليكم ، وقد كان القوم أقرب إلى معاوية منك ، ولم يكن لهم أن يصبروا عليك وأنت تحاول إدارة العجلة إلى الخلف ، إلى الزمن السعيد والصحيح ، فليس لها أن تدور إلا حيث تريد لها الرعية أن تدور ، وإذا كان أصحابك قد أقبلوا على الدنيا هذا الإقبال ، أتنكر أنت على الرعية أن تقبل هي الأخرى آخذة منها بنصيب ، ساعية إلى من ييسر لها ما ترضاه ، ويتألف قلوبها بما أنست إليه ، وتألفت معه ، وأقبلت عليه ، وأدبرت أنت عنه . هون عليك يا أبا الحسن ، فسوف يأتي بعدك بسبعين عاماً من لا يستوعب درسك فيحاول ما حاولت ، ويقضى بأسرع مما قضيت ، سوف يأتي عمر بن عبد العزيز ، ولن يستمر أكثر من سنتين وثلاثة أشهر ، وسوف يموت دون الأربعين ، مسموماً في أرجح الأقوال مخلياً مكانه ليزيد بن عبد الملك ، شاعر المغاني والقيان ، عاشق سلامة وجبابة ، وأول شهداء العشق والغرام في تاريخ الخلفاء ، كما سنروى للقارئ بعد قليل . وسوف يأتي بعد عمر بن عبد العزيز بقرن ونصف ، خليفة عباسي اسمه المهتدى بالله يحاول أن يحتذي حذوه فيأمر بالمعروف ، وينهى عن المنكر ، ويزهد في الدنيا ، ويقرب العلماء ، ويرفع من منازل الفقهاء ، ويتهجد في الليل ، ويطيل الصلاة ، ويلبس جبة من شعر وسوف يكون مصيره كما ذكر المسعودى : ( فـثـقلت وطأته على العامة والخاصة بحمله إياهم على الطريقة الواضحة فاستطالوا خلافته وسئموا أيامه وعملوا الحيلة حتى قتلوه ، ولما قبضوا عليه قالوا له أتريد أن تحمل الناس على سيرة عظيمة لم يعرفوها ؟ فقال : أريد أن أحملهم على سيرة الرسول وأهل بيته والخلفاء الراشدين ، فقيل له : إن الرسول كان مع قوم قد زهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ، وأنت إنما رجالك تركي وخزرى ومغربي وغير ذلك من أنواع الأعاجم لا يعلمون ما يجب عليهم في أمر أخرتهم وإنما غرضهم ما استعجلوه من هذه الدنيا ، فكيف تحملهم على ما ذكرت من الواضحة ؟ ) . وقد قتل المهتدى بعد أقل من أحد عشر شهراً من خلافته ، واختلف في قتله ، فذكر البعض أنه قتل بالخناجر ، وشرب القتلة من دمه حتى رووا منه ، ( ومنهم من رأى أنه عصرت مذاكيره حتى مات ، ومنه من رأى أنه جعل بين لوحين عظيمين وشد بالحبال إلى أن مات ، وقتل خنقاً ؟ كبس عليه بالبسط و الوسائد حتى مات ) ، لا تحزن يا أبا الحسن ولا تغضب ، فزمانك لا شك أعظم من زمن من يليك ، وحسبك أن عهدك كان فيصلاً أو معبراً إلى زمان جديد ، لا ترتبط فيه الخلافة بالإسلام إلا بالاسم ، ولا نتلمس فيها هذه الصلة بين الإسلام والخلافة ، إلا كالبرق الخاطف ، يومض عامين في عهد عمر بن عبد العزيز ، وأحد عشر شهراً في عهد المهتدى وخلا ذلك دنيا وسلطان ، وملك وطغيان ، وأفانين من الخروج على العقيدة لن تخطر لك على بال ، وربما لم تخطر للقارئ على بال ما نقلوه إليه كان ابتساراً للحقيقة ، وإهداراً للحقائق ، وانتقاصاً من الحق ، وإذا كان الشيء يذكر يا أبا الحسن ، فدعنا نقص على القراء ما راعك وما سيروعهم ، وما أفزعك وما سيفزعهم ، وسوف ننقله إليهم موثقاً بالرسائل ، تلك التي تداولتها أنت وابن عمك وأقرب الناس إليك ، عبد الله بن عباس ، حبر الأمة وبحرها ، وأحد أكثر من نقلت عنهم أحاديث الرسول ، وواليك على البصرة ، أعظم الأمصار وأجلها خطراً ، ولعلك يا أبا الحسن كنت تتوقع أن تسمع عن عبد الله بن عباس أي شئ إلا ما سمعت ، حين أتتك من صاحب بيت المال في البصرة ( أبو الأسود الدؤلى ) رسالة ينبئك فيها أن ( عاملك و ابن عمك قد أكل ما تحت يده بغير علمك ) . ولعلك يا أبا الحسن لم تصدق ، ولعله لم يكن أمامك إلا أن ترسل لعبد الله بن عباس مستفسراً ، متمنياً أم يحصحص الحق فيسفر عن بياض صفحته ، وهو خطابك إليه مختصراً : " أما بعد ، فقد بلغني عنك أمر ، إن كنت فعلته فقد أسخطت ربك ، وأخربت أمانتك ، وعصيت إمامك ، وخنت المسلمين : بلغني أنك جردت الأرض وأكلت ما تحت يديك ، فارفع إلى حسابك واعلم أن حساب الله أشد من حساب الناس " . ويأتيك يا أبا الحسن " أما بعد ، فإن الذي بلغك باطل ، وأنا لما تحت يدي أضبط وأحفظ ، فلا تصدق على الأظناء ، رحمك الله ، والسلام " . رد كأنه إحدى رسائل التلكس في أيامنا الحاضرة ، وهو رد لا يغنى من جوع ، ولا يسمن من شبع ، فعلي قد طلب حساب بيت المال ، فلم يظفر من ابن عباس إلا بنفي التهمة وبالسلام ، وما عليه إلا أن يعاود الكرة ، موضحاً ما يطلبه ، مؤكداً عليه ، محاولا استثارة النخوة الدينية لديه ، ولنقرأ خطاب علي : " أما بعد ، فإنه لا يسعني تركك حتى تعلمني ما أخذت من الجزية ، ومن أين أخذته ، وفيما وضعت ما أنفقت منه ، فاتق الله فيما ائتمنتك عليه واسترعيتك حفظه ، فإن المتاع بما أنت رازئ منه قليل ، وتبعة ذلك شديدة ، والسلام " . لم يعد الأمر اتهاماً ينفيه ابن عباس ، بل طلباً واضحاً ومحدداً ، ومطلوب من ابن عباس أن يجيبه ، وهو أن يكتب له ( كشف حساب ) يوضح في جانب منه موارده من الجزية ، وفي الجانب الآخر أوجه الإنفاق . والحقيقة أن ابن عباس قد أجاب ، وهو في إجابته لم يذكر شيئاً عن موارده وإنفاقه ، وإنما تقدم بالخصومة بينه وبين علي خطوة واسعة ، ورد عليه اتهاماً باتهام ، فعلي يتهمه باغتصاب المال ، وهو يتهم علياً بسفك دماء الأمة من أجل الملك والإمارة ، وهكذا جريمة بجريمة ، بل أن جريمة علي ( هكذا قال وهكذا أفتى ) أعظم عند الله من جريمته التي لم ينفيها أو يعتذر عنها ، ولنقرأ معاً رسالة عبد الله بن عباس إلى علي ( أما بعد ، فقد فهمت تعظميك على مرزئة ما بلغك أني رزأته أهل هذه البلاد ، والله لأن ألقى الله بما في بطن هذه الأرض من عقيانها ولجينها وبطلاع ما على ظهرها ، أحب إلى من أن ألقاه وقد سفكت دماء الأمة لأنال بذلك الملك والإمارة . فابعث إلى عملك من أحببت " . استقالة أسبابها غير مقنعة ، ضرب علي عند قراءتها كفاً بكف ، مردداً : " وابن عباس لم يشاركنا في سفك هذه الدماء ؟ " ولو رمى ابن عباس باستقالته تلك واكتفى ، لآخذناه على ما جاء فيها ، ولبررناها بغضبه من اتهام ظالم وجسيم ، أطلق منه نوازع الغضب وانفعالات الثورة ، فكتب ما كتب تحت وطأة الغيظ وفي ظل انفعال من يتهم وهو برئ ، لكنه فعل بعد كتابة هذا الخطاب ما لم يخطر لعلي على بال ، وما لا يخطر للقارئ على بال ، وما لا سبيل إلى نجاته من وزره أمام الله ، وأمام علي ، وأمامنا جميعاً .. لقد جمع ما تبقى من أموال في بيت المال ، و قدره نحو ستة ملايين درهم ، ودعا إليه من كان في البصرة من أخواله من بنى هلال ، وطلب إليهم أن يجيروه حتى يبلغ مأمنه ففعلوا ، وحاول أهل البصرة مقاومتهم وناوشوا بنى هلال قليلاً ، ثم أقنعوا أنفسهم بترك المال عوضاً عن سفك الدماء ، ومضى ابن عباس بالمال ، آمناً ، محروساً ، قريراً ، هانئاً ، حتى بلغ البيت الحرام في مكة ، فاستأمن به ، وأوسع على نفسه ، واشترى ثلاثة جوار مولدات حور بثلاثة آلاف دينار .. صدمة هائلة ، لا لعلي فقط ، بل لنا جميعاً ، نحن الذين عشنا عمرنا نقرأ عن فقه العباد له ، وزهد العباد له ، وورع العباد له ، ( يقصدون عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب ) ، فإذا بنا نحارفهما ، ونمسك ألسنتنا غصباً أمام أشهر العباد له ، ونخشى أن نصف فعله بما يستحق فلا ننجو من الألسنة الحداد ومما هو أكثر ، لكنا يجب أن لا نكون أرفق ببعض الصحابة من أنفسهم ، ولا أقل من أن نصفهم بما وصف بعضهم به بعضاً ، وحسبنا أن علياً أوجز رأيه في ابن عباس بأنه ( يأكل حراماً ويشرب حراماً ) وليس لنا إلا أن نقول مع علي : صدقت إن صدق ما قلت وحدث ما فعل ، بل أننا نتساءل ومعنا كل الحق ، هل الاستيلاء على أموال المسلمين بالباطل حلال على مسلم لكونه عاصر الرسول أو الخلفاء أو الصحابة ، حرام علينا لأننا جئنا في عصر بعد العصر ، وعاصرنا زماناً غير الزمان ؟ ، هي حرام عليهم بقدر ما هي حرام علينا ، بل هي حرام عليهم أكثر ، لأنهم يعرفون من الدين أكثر ، ومتفقهون فيه أكثر ، ولأنهم الأئمة والمنارة ، فإذا فسد الأئمة فمن أين يأتي الصلاح ؟ ، وإذا أظلمت المنارة فبمن نسترشد ؟ ولعلي قبل أن أستطرد في الحديث ، وللحديث بقية ، أتذكر أن أحد أعضاء تنظيم الجهاد ، ممن اغتالوا الرئيس السادات في المنصة ، كان مشهوراً عنه أنه يكحل عينيه ، وعندما سئل ، قال تأسياً بابن عباس ، ولعله لو قرأ ما قرأناه عنه ما تأسى به وما أكتحل مثله ، واقرأوا معي رسالة علي لابن عباس ، بعد أن استقر في مكة ، هانئاً بين جواريه ، قانعاً بأموال المسلمين ( أما بعد ، فأني كنت أشركتك في أمانتي ، ولم يكن في أهل بيتي رجل أوثق منك في نفسي لمواساتي ومؤازرتي وأداء الأمانة إليّ . فلما رأيت الزمان على ابن عمك قد كلب ، والعدو عليه قد حرب ، وأمانة الناس قد خربت ، وهذه الأمة قد فتنت ، قلبت له ظهر المجن ، ففارقته مع القوم المفارقين ، وخذلته أسوأ خذلان الخاذلين ، وخنته مع الخائنين ، فلا ابن عمك آسيت ، ولا الأمانة أديت ، كأنك لم تكن لله تريد بجهادك ، أو كأنك لم تكن على بينة من ربك ، وكأنك إنما كنت تكيد أمة محمد عن دنياهم أو تطلب غرتهم عن فيئهم ، فلما أمكنتك الغرة أسرعت العدوة ، وغلطت الوثبة ، وانتهزت الفرصة ، واختطفت ما قدرت عليه من أموالهم اختطاف الذئب الأزل دامية المعزي الهزيلة وظالعها الكبير ، فحملت أموالهم إلى الحجاز رحيب الصدر ، تحملها غير متأثم من أخذها ، كأنك لا أباً لغيرك ، إنما حزت لأهلك تراثك عن أبيك وأمك ، سبحان الله ! أفما تؤمن بالمعاد ولا تخاف سوء الحساب ؟ أما تعلم أنك تأكل حراماً وتشرب حراماً ؟ أو ما يعظم عليك وعندك أنك تستثمن الإماء وتنكح النساء بأموال اليتامى والأرامل والمجاهدين الذين أفاء الله عليهم البلاد ؟ فاتق الله ، وأد أموال القوم فإنك والله إلا تفعل ذلك ثم أمكنني الله منك لأعذرن إلى الله فيك حتى آخذ الحق وأرده ، وأقمع الظالم ، وأنصف المظلوم ، والسلام ) . خطاب يقطر دماً ، ولو استقبله ابن عباس بقلب فيه ذرة من إيمان لخشع وتاب ، ورجع عن فعله وأناب ، لكنه يرد مستخفاً في سطرين لا أكثر فيقول ( أما بعد ، بلغني كتابك تعظم على إصابة المال الذي أصبته من مال البصرة ، ولعمري إن حقي في بيت المال لأعظم مما أخذت منه والسلام ) . هذه المرة يأتي الرد سافراً ، نعم أخذت ، لكنه حقي ، بل إن حقي فيه أكثر ، أي حق ؟ وبأي حق ؟ وهل لعبد الله بن عباس في بيت مال المسلمين حق أكثر مما لرجل من المسلمين ؟ هذا ما تساءل به علي في رده على هذا الخطاب ، وهو رد بليغ وحزين لا أريد أن أشغل به القارئ فأزيده حزناً فوق حزن ، لكني أنتقل به فجأة إلى رد ( برقى ) آخر من ردود ابن عباس ، حسم به النقاش ، وأنهى به الجولة ، وختم به حديث الدين والعقيدة ، مهدداً بسطوة الدنيا وسيفها ، وسلطانها وزيفها ، قائلاً لابن عمه علي : " لئن لم تدعني من أساطيرك لأحملن هذا المال إلى معاوية يقاتلك به " . وهكذا أصبحت الموعظة الحسنة أساطير لدى عبد الله بن عباس ، وأصبحنا نحن في حيص بيص كما يقولون ، نضرب كفا بكف ، ونتساءل في مرارة ، هل نأتمن على ديننا من لم يؤتمن على دنيانا ؟ . لا بأس أن نترك علياً لأحزانه ، وهو يرى ( كما يقول ) أن أمانة الناس قد خربت ، والأمة قد فتنت ، وابن عمه قد انقلب عليه ، وفضل رغد العيش من مال المسلمين في مكة ، على نضال العقيدة من أجل الإسلام في الكوفة ولن يمر وقت طويل حتى يقتل علي ، ، وحتى نرى عبد الله بن عباس ، ضيفاً على معاوية في مقر خلافته في دمشق ، مستقبلاً بالتوقير والملاطفة والعطايا ، غير أن العلة لم تكن فقط في نكوص رموز العقيدة عن حمل أعبائها ، بل كانت هناك علل أخرى قد تسللت إلى بنيان الدولة الإسلامية الوليدة فأجهزت عليه وهنا نترك حديث العقيدة ورموزها إلى حديث الدنيا وسياستها ، ونشير إلى أن أي حكم في التاريخ لا بد له مهابة ، وأن هيبة الحكم محصلة للتفاعل بين الحاكم والمحكوم ، وهي في النهاية ضرورة ليس لصلاح الحكم ، فهذا أمر آخر ، بل لتوطيد دعائمه ، واستمراره واستقراره ، ولا شك في أن أبا بكر بحروب الردة قد حفظ هذه الهيبة بل ورسخها في نفوس المحكومين ، ولا شك في أن عمر بعنفه وعدله معاً قد وصل بهذه الهيبة إلى أقصى الدرجات . ولا شك أيضاً في أن عثمان قد هبط بها رويداً رويداً حتى تلاشت أو كادت ، فهو مرة يصدر قراراً خاطئاً ، ثم لا يلبث أن يقف على المنبر لكي يعتذر ويبكي ( حتى يبكي الجميع ) ، ثم لا يلبث أن يعود عن اعتذاره إلى عنف لا يملك مقوماته ، وهو في تأرجحه بين العنف واللين ، وتراوحه بين القرار وعكسه ، يفقد الحكم هيبته لدى الرعية شيئاً فشيئاً ، حتى يصل الأمر إلى خطف السيف من يده وكسره نصفين ، وإلى قذفه بالحجارة وهو على المنبر حتى يغشى عليه ، وإلى محاصرته ومنع المياه عنه ، بل أن يرسل إليه الأشترالنخعى خطاباً يفتتحه بالعبارة التالية : " من مالك بن الحارث إلى الخليفة المبتلى الخاطئ الحائد عن سنة نبيه النابذ لحكم القرآن وراء ظهره " ولعلى أجزم بأنه لم يكن هناك سبيل لعودة هذه الهيبة إلا برجل دنيا وسياسة وحكم من شاكلة معاوية ، رجل لا يتحرج أن يقتل حُجر بن عدى ، على إيمانه وعدله وزهده ، حين يعبر حجر الخيط الرفيع بين معارضة الحكم ومحاربته ، وبين الاعتراض على الحاكم ، والثورة عليه ، لأن القضية في نظره حكم أو لا حكم ، وسلطة أو لا سلطة ، وهيبة أو لا هيبة . ولعل هذا المنطق هو ما حفظ جيش ( معاوية ) من الانقسام ، بينما سلك ( علي ) طريق الدين ، فحاور المنشقين ، وكلما أتوا بحجة أتى بحجة ، وإذا ذكروا آية أفحمهم بآية ، وإذا استشهدوا بحديث رد عليهم بحديث ، وكلما طال النقاش زادت الفرقة واتسع الانقسام ، ولم يعد هناك بد من أن يرفع عليهم السيف و أن يرفعوا عليه السيف ، و في النهاية صرعته سيوفهم ، لأنه هكذا ينتهي التطرف بالمتحاورين معه ، وهكذا يحسم الحوار ( الديني – الديني ) دائماً ، يحسمه الأكثر تطرفا لصالحه ، عادة يحسم معه أشياء كثيرة ، منها مبدأ الحوار ذاته ، وحياة المحاور ذاتها ، وإذا كنا نرى في أيامنا من المتطرفين عجباً ، فلأنهم رأوا منا عجباً ، تحسسوا هيبة الدولة فلم يجدوا هيبة ولا دولة ، عجموا عود النظام في الهين من الأمر فوجدوه مرناً مثل ( اللادن ) ، زادوا فوجدوه قد ازداد ليناً ، تمادوا فإذا به ينثني معهم أينما انثنوا ، عاجلوه بالجليل من الأمر فعاجلهم بضبط النفس ، انتظروا اللوم من قيادات الفكر السياسي ورموز المعارضة فلم يجدوا إلا من يشيد أو يستزيد ، ومن يصف مجرميهم بالشهداء ، أو ينعت فأسديهم بالشرفاء ، ولو طبقت عليهم الشريعة التي ينادون بها لعوملوا معاملة المفسدين في الأرض ، ولقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف ، ولصلبوا في ميادين القاهرة والإسكندرية . ما علينا ولنعد إلى صفحات التاريخ ، فقد توقفنا عند عثمان وعلي وذكرنا أن الخلافة الإسلامية قد انتهت علاقتها بالإسلام بعدهما ، ولم تكن لها بالإسلام صلة إلا في ومضات خاطفة تمثلت في عهد عمر بن عبد العزيز أو المهتدى ، ولعلها بدأت هذا المسار كما أشرنا في بداية عهد عثمان ، وإذا كنا ننزع صفة الإسلام عن الخلافة فيما ذلك من عهود فإن لنا في ذلك حجة سوف نسردها في موقعها من السرد ، والصحيح في رأينا أنها كانت خلافة عربية ، إن جاز التعميم وهو جائز ، والأدق أن نقول أنها قرشية إن شئنا الدقة في اللفظ وهو دقيق ، فقد حكمت قبيلة قريش المسلمين أكثر من تسعمائة سنة ) ، بينما حكم الإسلام ربع قرن أو أقل ، فالخلفاء الراشدون قرشيون ، والأمويون قرشيون والعباسيون قرشيون ، وقد استمرت الدولة العباسية بصورة رسمية ثم بصورة شكلية بعد سقوط بغداد حتى سقوك دولة المماليك في أيدي العثمانيين عام 918 هــ ، وأكاد أجزم بان قبيلة قريش بذلك تمثل أطول أسرة حاكمة في تاريخ الإنسانية كلها ، بل إن التاريخ لا يحدثنا عن أسرة واحدة حكمت نصف هذه الفترة ، ولو كان الأمر أمر رضا من المسلمين ، أو اختيار منهم لهان علينا وما توقفنا عنده ، لكننا نتوقف عنده طويلاً ، ونتأمله كثيراً لكونه ارتبط بأعز ما نملك وهو العقيدة ، وتستر بأقدس رداء وهو الدين ، واستند إلى أحاديث نبوية ننكرها على من ادعوها ، لأنها لا تمت لروح الإسلام بصلة . وحسبك ذلك الحديث الذي استند إليه العباسيون حتى استمر حكمهم قرابة سبعمائة وستة وثمانين عاماً ، ومضمونه أن الخلافة إذا انتقلت إلى أيدي أولاد العباس ، ظلت في أيديهم حتى يسلموها إلى المهدى أو عيسى بن مريم ، وهو حديث كاذب ، ومختلقة كذوب ، وأنا وأنت أيها القارئ لا نختلف الآن على كذب الحديث ولا تكذيب قائلة ، حجتنا في ذلك أنه ببساطة لم يتحقق ، لكن هذه الحجة لم تكن متاحة لأجدادنا ، وما كان لهم إلا أن يخضعوا صاغرين للحديث ، وإلا اتهمهم فقهاء العصر ، شأنهم شأن بعض الفقهاء الذين يظهرون في كل عصر ، بنقص في دينهم ، والتواء في عقيدتهم ، وحسبنا أن مراجع الحديث ومنها الصحيحان وابن حنبل والدرامى وأبو داود تجمع على حديث يأتي حديث لو اجتمع عليه أهل الأرض لعارضناه ، فالإسلام السمح ، الذي أتى ليساوى بين العربي والأعجمي ، لا يميز أسرة من الأسر عن غيرها بدم أزرق ، لمجرد أنها قريش ، وها هو عمر يعلن قبيل وفاته ( لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لوليته ) ، وما كان سالم قرشياً ، وما كان عمر بالذي يجهل حديثاً له هذا القدر من الأهمية ، وها هو سعد بن عبادة ( الخزرجى ) ينافس أبا بكر على الخلافة ، ويرفض بيعته حتى وفاته ، ولو علم سعد بالحديث ما نافس ولا أنكر ولا رفض ولا أصر ، لكنه هكذا كان الأمر . وهكذا خضع أجدادنا لحكم الخلفاء ، الفضلاء منهم ( و ما أندرهم ) والسفهاء منهم ( وما أكثرهم ) ، خوفاً من اتهامهم بالخروج على الطاعة ، أو المخالفة للجماعة ، ويا حسرة على إسلام عظيم أتي ليساوي بين الناس ، فأحاله البعض بالكذب ، إلى دين يرسخ التفرقة العنصرية ، ويرفع البعض فوق البعض بالنسب ، ولعل المنادين بالخلافة في عصرنا الحديث ، يدلوننا على سبيل نتحقق به من أنسابنا ، فربما كنا قرشيين دون أن ندري ، فنزايد في السياسة مع المزايدين ، ونطمع في الحكم مع الطامعين ونكره المنطق مع الكارهين . وأخيراً ونحن نتجاوز عهد الراشدين إلى غيرهم ، يجدر بنا أن نستخلص نتيجتين
النتيجة الأولى : أن من يتصورون أنه من الممكن إعادة طبع نسخة كربونية من عصر الراشدين ، في عصرنا الحديث ، إنما يركبون شططاً من الأمر ، وقد يصلون بأنفسهم وبنا نتائج مؤسفة ، فليس كل ما كان مقبولاً في عهد الصحابة مقبولاً وصحيحاً في عصر غير العصر ، ومع قوم غير القوم ، وحتى في أفعال الرسول نفسه ، هناك مساحة واسعة لتأسيه بعصره ، ومعايشته لتقاليد قومه ، كالزي والعلاج ، وهي مساحة لسنا مطالبين بالأخذ بها أو اعتبارها سنة واجبة الإتباع والنفاذ ، فالرسول لم يأت بزي جديد ، وإنما ارتدى زي الجاهلية ، وزي الأعاجم عندما أهدي إليه ، وعليه فليس الزي النبوي وارد اكسنة للتأسي والمتابعة ، وما يقال عن الزي يقال عن الطب ، ويقال عن كثير من المفاهيم التي سادت في عصرنا الحديث ، وتقبلها الناس قبولاً حسناً ، وهي أقرب ما تكون إلى الروح العامة للإسلام إذا ما فهمناها بمنطق مخالف للمنطق ( الكربوني ) سالف الذكر ، الذي لو اتبعناه لوصل بنا نتائج أقل ما توصف به أنها مؤسفة ، بل وربما جاز وصفها بما أكثر .. ولنأخذ مثالاً .. التعذيب .. لن يختلف اثنان على القول بأن التعذيب بالإيذاء البدني أو النفسي للحصول على اعتراف أو قبل تنفيذ حكم أو خلال تنفيذ حكم أمر ينكره الدين ، ويتنافى مع جوهره في العدل والرحمة . هذا هو التفسير العصري ، أي الذي يأخذ روح العصر فيطابقها على روح الدين وجوهره أو يفعل العكس وهو في الحالتين مقنع ومقبول وصحيح ، فماذا عن التفسير الكربوني ؟ إليكم واقعتين شهيرتين : الأولى : في حادثة الإفك المعروفة ، ، حين اتهم البعض عائشة فدعا الرسول عليا لاستشارته ( فقال يا رسول الله إن النساء لكثير وأنك لقادر على أن تستحلف وسل الجارية فإنها تصدقك فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ( بريرة ) يسألها فالت فقام إليها ( علي ) فضربها ضرباً شديداً وهو يقول اصدقي رسول الله فتقول والله ما أعلم إلا خيرا .. ) هنا إيذاء بدني من علي للجارية بقصد الحصول منها على اعتراف ولم ينكر الرسول شيئاً مما فعله علي ، والتفسير ( الكربوني ) هنا يصل بنا إلى أنه من ( السنة ) أن يعذب المتهم للحصول على اعترافه ويصبح ما يثار حول تعذيب أعضاء الجماعات الإسلامية في السجون أمراً مشروعاً ، وشرعياً ، بل ومحمودا لأنه تأس بالسلف الصالح .. بينما وجهة النظر المقابلة ، المتسعة الأفق الملتصقة بروح العقيدة ، تستـنكر التعذيب ، وترى أن هذا حتى لو كان أمراً مقبولاً في عصر الرسول ، لا ينسحب على غيره من العصور ، وإذا كانت الحضارة قد أضافت فيما أضافت ، مفهوماً واسعاً لحقوق الإنسان ، يرفض فيما يرفض أن يعذب متهم للحصول على اعتراف ، فإننا نقبل هذا المفهوم من منطلق إسلامي ، ولا نرفضه لمجرد التأسي بعصر أياً كان هذا العصر ، لسببين بسيطين واضحين : أولهما أننا في عصر غير العصر وثانيهما أن الإسلام لا يتنافى مع روح العصر ، أي عصر ، في كل ما هو إنساني وسمح وعادل . الواقعة الثانية : بعد وفاة الإمام على بن أبي طالب بطعنات من عبد الرحمن بن ملجم ( دعا عبد الله بن جعفر بابن ملجم ، فقطع يديه ورجليه وسمل عينيه فجعل يقول : " إنك يا ابن جعفر لتكحل عيني بملمول مض " أي بمكحال حار محرق " ثم أمر بلسانه أن يخرج ليقطع ، فجزع من ذلك ، فقل له ابن جعفر : قطعنا يديك ورجليك ، وسملنا عينيك ، فلم تجزع ، فكيف تجزع من قطع لسانك ، قال : إني ما جزعت من ذلك خوفاً من الموت ، لكني جزعت أن أكون حياً في الدنيا ساعة لا أذكر الله فيها . ثم قطع لسانه ، فمات ) ، والرواية يذكرها ابن سعد مضيفاً إليها حرقة بعد موته ويذكرها ابن كثير دون ترجيح ويقتصر الطبري وابن الأثير على الحرق بعد القتل . والرواية لا تعبر في رأينا عن روح الإسلام أو تعاليمه ، حتى لو اقتصرت على حرق الجثمان بعد القصاص فقد نهى الرسول عن المثلة ولو بالكلب العقور ، ونهى ( علي ) قبل وفاته في رواية لابن الأثير عن المثلة بقاتله ، لكنها تعبر من وجهة نظرنا عن روح عصر ، سادته القسوة ، وتحجر القلب وكان مقبولاً فيه أن يحدث ما فعله عبد الله بن جعفر بابن ملجم ، دون استنكار ، بل ويكمل المشاهدون المشهد بحرق الجثمان ، بينما أضافت الحضارة إلى سلوكنا كثيرا من الإحساس بعذاب الآخرين ، وصعوبة تقبل التمثيل بهم أو تعذيبهم ، بل إنه من الصعب أن نتصور صمود مجموعة من المشاهدين لمثل ما فعله عبد الله بن جعفر ، بكلب ضال أو بقط شارد .. غير أن لكل حقيقة وجهين ، وما أيسر أن يجد أنصار ( الكربون ) تبريراً لفعل عبد الله بن جعفر ، وللإقتداء به ، بإلصاق تهمة الإفساد في الأرض بابن ملجم ، والتأسي بالحسن والحسين ، حيث لم يذكر عنهما أنهما أنكرا التمثيل بالجثمان بحرقه بعد القصاص . ولعلنا نتساءل ونحن نتأمل صمود عبد الرحمن بن ملجم ، وصبره على قطع أطرافه وسمل عينيه بالحديد المحمى ثم جزعه عند قطع لسانه ( حتى لا تمر عليه لحظة لا يذكر فيها الله ) .. هل هناك مثال أبلغ من هذا المثال ، على ما يمكن أن يؤدي إليه التطرف عندما يتسلط على الوجدان فلا يميز المتطرف بين الكفر والإيمان ، ويصل به الأمر إلى قتل على ابن أبي طالب ، والتلهي عن المثلة به بقراءة القرآن ، والجزع فقط عند قطع اللسان ، حتى لا يحرم لحظة من ذكر الرحمن ؟ . لا جديد إذن تحت الشمس ، وقد لا نجد في زماننا نظيراً لعلي ، لكننا نجد كثيراً من أمثال عبد الرحمن .. ونعود إلى هواة الكربون .. أليس الأجدر بهم ، رحمة بنا ، وبالإسلام ، أن نلتزم بالقرآن ، وبالسنة في شئون العبادة ، وأن نترك في نفس الوقت ، مساحة من أذهاننا للتعرف على العصر والالتقاء معه ، وقبول ما يأتي به من قيم تتناسق مع جوهره ، ولا تتناقض مع الإيمان والعقيدة ، وأن نقبل ما نقبل ، ونترك ما نترك ، بقلب مؤمن وفكر مفتوح ، فلا نرفض حقوق الإنسان لأنها أتت من الأعاجم ، ولا نرفض الديموقراطية لأنها بدعة ، ولا نرفض عصرنا على إطلاقه ، ولا نقبل عصر الراشدين على إطلاقه ، ونستخدم العقل في النقل ، والكربون في طبع مستحدثات الحضارة ، تلك التي لا علاقة لها بالفكر أو العقيدة ، وإنما علاقتها وطيدة بالتقدم ، ذلك الذي أزعم أنه ليس ركنا من أركان الإسلام ، بل هو الإسلام . النتيجة الثانية : أن قواعد الدين ثابتة ، وظروف الحياة متغيرة ، وفي المقابلة بين الثابت والمتغير ، لا بد وأن يحدث جزء من المخالفة ، ونقصد بالمخالفة أن يتغير الثابت أو يثبت المتغير ، ولأن تثبيت واقع الحياة المتغير مستحيل ، فقد كان الأمر ينتهي دائما بتغير الثوابت الدينية ، وقد حدث هذا دائماً ومنذ بدء الخلافة الراشدة وحتى انتهت ، وتغيير الثوابت هو ما نسميه بالاجتهاد ، وقد اتفقنا على أنه ليس مطلقاً ، لكنه قائم ومتاح ، وما أوردناه من أمثلة لاجتهادات عمر يصلح دليلاً على ما نقول ، غير أنه في بعض الأحيان تفرض تعقيدات الحياة نوعاً من المخالفات ، الحادة ليس فيه شئ من تناغم الاجتهاد في ربطة بين الأسباب والنتائج ، فتصبح المخالفة صريحة وواضحة لا يمكن تبريرها بالاجتهاد لافتقاد أسبابه ، وإنما تبرر فقط بأن عدم المخالفة مستحيل أو في احسن الأحوال غير ممكن ، وقد حدث ذلك في عهد الراشدين كما يحدث في كل عهد ، ومثاله ما حدث عقب مقتل عمر ابن الخطاب ، حين انطلق ابنه عبيد الله ابن عمر ، و قتل ثلاثة ظن فيهم التآمر على مقتل والده ، ولم يثبت ذلك في حق أحد منهم ، وكان أحدهم الهرمزان ، الذي أسلم وصح إسلامه ، وقد واجه عثمان هذا الموقف في بدء ولايته وكان رأي الدين فيه واضحاً ، أعلنه علي وأصر عليه ، وهو أن يقتل عبيد الله بدم من قتل ، لكن عثمان لم يملك إلا المخالفة لأسباب ( إنسانية ) ، فقد تساءل الناس في شفقة ، أيقتل عمر بالأمس ، ويقتل ابنه اليوم ؟ ألا يكفي آل عمر قتل عمر ؟ ، أيفجعون فيه ثم في ولده قبل أن تجف دموعهم عليه ؟ .. منطق .. وإنسانية .. وظروف متغيرة .. لكن حكم الدين ثابت وواضح ولا لبس فيه .. حكم الدين هو القصاص ، ولا بد من قتل عبيد الله .. ويقال أن عمرو بن العاصي أفتى بفتوى بالغة الذكاء والمهارة عندما تولى عثمان ، وسأل عمرو أن يخرجه من المأزق الصعب ، فسأله عمرو : هل قتل الهرمزان في ولاية عمر ؟ فأجابه عثمان : لا كان عمر قد قتل ، فسأله ثانية : وهل قتل في ولايتك ؟ فأجابه عثمان : لا ، لم أكن قد توليت بعد ، فقال عمرو : إذن يتولاه الله .. والشاهد هنا أن عثمان حاول التخلص من المأزق بدفع دية الهرمزان من ماله ، ولم يتحمل عبيد الله وزر القتل أو حتى دية القتلى ، وهو ما رفضه علي ، الذي ظل يتوعد عبيد الله كلما لقيه بأنه إذا تولى فسوف يقتله بدم الهرمزان ، وما أن تولى علي حتى هرب عبيد الله إلى جيش معاوية ، وحارب عليا إلى أن قتل في معركة صفين .. ويشاء القدر أن يقع على نفس المأزق ، بل ربما بصورة أعقد ، فقد ولى ولم يقدر على قتله عثمان لأنهم كانوا مسيطرين على المدينة ، ثم انتقل من حرب إلى حرب وهم على رأس جيشه فلم يتمكن منهم ، وعندما أعلن معاوية أن مطلبه الوحيد أن يدفع علي إليه قتله عثمان ، فوجئ علي بجيشه يهتف في صوت واحد ، كلنا قتلة عثمان ، فزاد الموقف تعقيدا ، وأصبح مستحيلاً على الإمام علي أن يثأر من القتلة أو حتى يحاسبهم .. هي الحياة وليست الجنة ، والبشر وليس الملائكة ، وخلا عصر النبوة لا يوجد عصر للنقاء المطلق ، أو انعدام المخالفة المطلق وكلما تغير العصر أو تقدم ، تعددت المتغيرات ، وزادت المخالفات ، وإذا كانت الاجتهادات واسعة ، والمخالفات واردة ، قبل أن يمر ربع قرن على وفاة الرسول ، وفي عهد معاصريه فكيف بنا بعد أربعة عشر قرناً من وفاة الرسول ، ألا نتوقع أن يزداد حجم ( المخالفات الاضطرارية ) ، وأن نتوسع في ( الاجتهادات الضرورية ) ، وأن نقبل بحد أدنى من تطبيقات الدين ، أقل بكثير مما قبله سلف أصلح ، في عصر أكثر تخلفاً ، وأقل تعقيداً انغلاقاً ، وأكثر اتفاقاً .. الحقيقة أن القارئ الحرية كل الحرية في أن يرفض ما أقول وأن يستنكر ما أتوصل إليه ، وما أراه رغم كل ما أتوقعه من استنكار واعتراض ، حقاً وعدلاً ، وأمراً واقعاً لا مهرب منه ، وسوف يرى القارئ فيما سنذكره عن خلفاء بن أمية وبنى العباس ، ما يؤكد له صحة ما نقول ، وحقيقة ما ندعى ..
قراءة جديدة في أوراق الأمويين
للقارئ الآن وهو ينتقل معنا من عصر الراشدين إلى ما يليه ، أن يهيئ ذهنه للدعابة ، ووجدانه للأسى ، فحديث ما يلي الراشدين كله أسى مغلف بالدعابة ، أو دعابة مغلفة بالأسى ، أما المجون فأبوابه شتى ، وأما الاستبداد فحدث ولا حرج. ليسمح لنا القارئ في البداية أن نقص عليه ثلاث قصص موجزة ، يفصل بينها زمن يسير ، واختلاف كثير، وهي إن تنافرت تضافرت ، مؤكدة معنى واضحاً ، وموضحة مساراً مؤكداً ، ومثبتة ما لا يصعب إثباته ، وما لا يسهل الهروب منه. القصة الأولى: عام 20 هـ وقف عمر خطيباً على منبر الرسول في المدينة ، وتحدث عن دور الرعية في صلاح الحاكم وإصلاحه فقاطعه أعرابي قائلاً : والله لو وجدنا فيك اعوجاجاً لقومناه بسيوفنا ، فانبسطت أسارير عمر ، وتوجه إلى الله حامداً شاكراً ، وذكر كلمته المأثورة المشهورة : الحمد لله الذي جعل في رعية عمر ، من يقومه بحد السيف إذا أخطأ … القصة الثانية: عام 45هـ قال ابن عون : كان الرجل يقول لمعاوية : والله لتستقيمن بنا يا معاوية ، أو لنقومنك فيقول : بماذا ؟ فيقول : بالخشب فيقول : إذن نستقيم . ( تاريخ الخلفاء للسيوطي ص195) القصة الثالثة: عام 75هـ خطب عبد الملك بن مروان ، على منبر الرسول في المدينة ، بعد قتل عبد الله بن الزبير قائلاً ( والله لا يأمرني أحد بتقوى الله بعد مقامي هذا إلا ضربت عنقه ) . ثم نزل ثلاث قصص موجزة ، لكنها بليغة في تعبيرها عن تطور أسلوب الحكم ، واختلافه في عهود ثلاثة ، أولها عهد عمر بن الخطاب ، درة عهود الخلافة الراشدة ، وثانيها عهد معاوية ابن أبي سفيان مؤسس الخلافة الأموية ، وثالثها عهد عبد الملك ابن مروان ، أبرز الخلفاء الأمويين بعد معاوية ، وأشهر رموز البيت المرواني ، الذي خلف البيت السفياني بعد وفاة معاوية بن يزيد ، ثالث الخلفاء الأمويين. أما القصة الأولى : فهي نموذج لصدق الحاكم مع الرعية ، وصدق الرعية مع الحاكم ، ونحن لا نشك ونحن نقرأها في أن الأعرابي كان صادقاً كل الصدق في قوله ، وأنه كان يعني تماماً ما يقول ، وأنه كان على استعداد بالفعل لرفع السيف في وجه عمر وتقويمه به إن لزم الأمر ونحن لا نشك أيضاً في أن عمر كان يدرك تماماً أن الأعرابي صادق في مقولته، وأنه لهذا سعد ، ومن أجل هذا حمد الله ، وكان في سعادته وحمده صادقاً كل الصدق ، مع الله ، ومع نفسه ، ومع الأعرابي ، وباختصار فنحن أمام حوار تؤدي فيه الكلمات دورها الطبيعي ، حيث تعبر عن دخائل النفوس ، في دقة ، ووضوح ، واستقامة. وأما القصة الثانية : فهي نموذج رائع لخداع الكلمات حين يصبح للعبارة ظاهر وباطن، وللكلمة مظهر ومخبر ، فالرجل في تهديده أقرب للمداعبة ، وأميل إلى الرجاء ، ومعاوية في رده عليه يحسم الموقف بتساؤله ( بماذا ) ؟ وهو تساؤل يعكس ثقة عالية في النفس ، وهي ثقة تهوى فوق رأس الرجل ثقيلة وقاطعة ، شأنها شأن السيف الحاسم البتار ، وما أسرع ما ينسحب الرجل سريعاً محولاً الأمر كله إلى الدعابة ، وهنا يدرك معاوية أن الرجل قد ثاب إلى رشده ، فيعيد السيف إلى غمده الحريري ، وينسحب هو الآخر في مهارة وخفة ، مرضياً غرور الرجل ، ما دام الخشب هو السلاح ، وما دام القصد هو المزاح ، والقارئ للحوار لا يشك في أن الرجل قال شيئاً وقصد شيئا آخر ، وأن معاوية قال شيئاً وقصد شيئا آخر، وأن كلا الرجلين فهم قصد الآخر ، فكـَّر في الوقت المناسب ، وفـَّر في الوقت المناسب وأن الرجل في كـّرِه نحو معاوية ، وفي فـّره منه لم يكن أبداً كجلمود صخر وإنما كان مثل كرة القش ، ظاهرها متماسك وباطنها هش . وننتقل إلى القصة الثالثة : وهي أقرب من القصة الأولى في وضوحها وصراحتها واستقامة ألفاظها ، غير أنها هذه المرة تعلن عكس ما أعلنه عمر ، وتهدد بالقتل في حسم وصراحة ، ليس لمن يخالف الأمير ويعترض عليه ، وليس لمن يرفع في وجه السيف أو حتى الخشب، بل لمن يدعوه إلى( تقوى الله ) وقد خلد عبد الملك نفسه بذلك ، فوصفه الزهري بأنه أول من نهى عن الأمر بالمعروف. هذه قصص ثلاث توضح كيف تطور الأمر من خلافة الراشدين إلى خلافة معاوية ، الرجل المحنك المجرب ، الناعم المظهر ، الحاسم الجوهر ، المؤسس للملك ، بكل ما يستوجبه التأسيس من سياسة وحنكة ، ومظهر ومخبر ، ثم كيف أصبح الأمر عندما استقر الملك ، ولم يعد هناك داع للخفاء ، أو مقتضى للخداع أو المداهنة ، وبمعنى آخر فإن القصص الثلاث تنتقل بنا بين حالات ثلاث ، أولها العدل الحاسم ، وثانيها الحسم الباسم ، وثالثها القهر الغاشم . وكل ذلك خلال نصف قرن لا أكثر ، وقد رأينا أن نوردها في بدء حديثنا عن خلافة الأمويين لدلالتها ، حتى يخلد القارئ معنا إلى قدر من الرياضة الذهنية والابتسام ، بعيداً عن صرامة السرد ومرارة الحقائق . ولعل القارئ قد تعجب من اجتراء عبد الملك ، لكنا نسأله من الآن فصاعداً أن يوطن نفسه على العجب ، وأن يهيئ وجدانه للاندهاش ، وأن يحمد لعبد الملك صدقه مع نفسه ومع الناس ، فسوف يأتي بعد ذلك خلفاء عباسيون يخرجون على الناس بوجه مؤمن خاشع ، وتسيل دموعهم لمواعظ الزهاد ، ثم ينسلون إلى مخادعهم فيخلعون ثياب الورع ، وتلعب برؤوسهم بنت الحان ، فينادمون الندمان ، ويتسرون بالقيان ، ويقولون الشعر في الغلمان ، وهم في مجونهم لا يتحرجون حين تناديهم جارية لعوب بأمير المؤمنين ، أو يخاطبهم مخنث ( معتدل القامة والقد ) بخليفة المسلمين ، مادمنا نتحدث عن وضوح عبد الملك ، وصدقه مع نفسه ، فلا بأس من قصة طريفة يذكرها السيوطي في كتابه ( تاريخ الخلفاء ص 217 ) : ( قال ابن أبي عائشة : أفضى الأمر إلى عبد الملك ، والمصحف في حجره فأطبقه وقال : هذا آخر العهد بك ) . ونحن لا نجد تناقضاً بين أفعال وأقوال عبد الملك بعد ولايته ، وبين ما تـُحدثنا به نفس المراجع عن فقهه وعلمه ومن أمثلة ذلك : ( قال نافع : لقد رأيت المدينة وما بها شاب أشد تشميراً ولا أفقه ولا أنسك ولا أقرأ لكتاب الله من عبد الملك ابن مروان ، وقال أبو الزناد : فقهاء المدينة سعيد بن الملك بن مروان ، وعروة بن الزبير وقبيصة بن ذؤيب ، وقال عبادة بن نسى : قيل لابن عمر: أنكم معشر أشياخ قريش يوشك أن تنقرضوا ، فمن نسأل بعدكم ؟ فقال : أن لمروان ابنا فيها فسألوه ) . نقول لا تناقض على الإطلاق لأن ذلك كله كان قبل ولايته ، فلما ولي أدرك أن عهد النسك والعبادة قد ولى ، وأطبق المصحف وأطلق شيطان الحكم والإمارة وصدق في قوله للمصحف أن هذا هو آخر العهد به ، ودليلنا على ذلك أن ساعده الأيمن كان الحجاج ، وإذا ذكر الحجاج هربت الملائكة وأقبلت الشياطين ، وقد عرف عبد الملك للحجاج مواهبه وأدرك أنه بالحجاج قد وطد دعائم الحكم وأرسى قواعد الخلافة ، فكانت وصيته الأخيرة لولده وولى عهده الوليد أن يحفظ للحجاج صنيعه وأن يلزمه وزيراً ومشيراً ، وقد كان . ربما كان البعض، وما يضيرنا من سيرة رجل أعلن طلاقه للمصحف ، وأدار ظهره لكتاب الله ، وحكم بهواه ، ولنا أن نذكرهم أنه فعل ما فعل ، وسفك ما سفك وقتل من قتل ، تحت عباءة إمارة المؤمنين ، وخلافة المسلمين ، وأن المسلمين جميعاً كانوا يرددون خلف أئمتهم كل جمعة دعاء حاراً أن يعز الله به الدين، وأن يوطد له دعائم الحكم والتمكين ، وأن يديمه حامياً للإسلام وإماماً المسلمين وأن فقهاء عصره كانوا يرددون حديثاً تذكره لنا كتب التاريخ ، مضمونه أن من حكم المسلمين ثلاثة أيام ، رفعت عنه الذنوب ولعلنا نظلم عبد الملك كثيراً إذا قيمناه من زاوية العقيدة ، فلم يكن عبد الملك فلتة بين من سبقه أو من لحقه ، وكان في ميزان السياسة والحكم حاكماً قديراً ، ورجل دولة عظيماً بكل المقاييس ، فقد أخمد فتنة عبد الله بن الزبير، وغزا أرمينية ، وغزا المغرب ، وغزا المدن ، وحصن الحصون ، وضرب الدنانير لأول مرة ، ونقل لغة الدواوين من الفارسية إلى العربية ، وقد لخص أسلوبه في الحكم في وصيته لابنه الوليد وهو يحتضر: يا وليد اتق الله فيما أخلفك فيه ( لاحظ مفهوم الحكم بالحق الإلهي في هذه العبارة ) ، وانظر الحجاج فأكرمه فأنه هو الذي وطأ لكم المنابر ، وهو سيفك يا وليد ويدك على من ناوأك ، فلا تسمعن فيه قول أحد ، وأنت أحوج إليه منه إليك ، وادع الناس إذا مت إلى البيعة ، فمن قال برأسه هكذا فقل بسيفك هكذا – ثم أخذته غفوة فبكى الوليد فأفاق وقال – ما هذا ؟ أتحن حنين الأمة ؟ إذا مت فشمر وائتزر ، والبس جلد النمر، وضع سيفك على عاتقك فمن أبدى ذات نفسه فاضرب عنقه ، ومن سكت مات بدائه.) وقد حفظ الوليد الوصية وقام بها خير قيام فكان رجل دولة وحكم من طراز فريد ، وكان فاتحاً عظيما للثغور ، فقد فتح الهند والأندلس ، وكان أبعد ما يكون عن حديث الدين والعقيدة فلم يذكر عنه فيهما لا قليل ولا كثير، إلا بضعة أقوال عن أنه كان يلحن كثيراً في قراءاته للقرآن ، وفي خطبه على المنابر ، وقد حكم عبد الملك عشرين عاماً وحكم الوليد عشرة أعوام ، أي أن عبد الملك والوليد حكما ثلاثين عاماً من اثنتين وتسعين عاماً هي عمر الدولة الأموية . تلك الدولة التي لا يجوز أن نتحدث عنها دون أن نتوقف أمام ثلاثة خلفاء هم اليزيدان ( يزيد بن معاوية ويزيد بن عبد الملك ) والوليد بن يزيد . أما يزيد بن معاوية ، فقتله للحسين معروف ، وقد أفاض فيه الرواة بما لا حاجة فيه لمزيد، غير أن هناك حادثة يعبرها الرواة في عجالة ، بينما نراها أكثر خطراً من قتل الحسين ، لأنها تمس العقيدة في الصميم ، وتضع نقاطاً على الحروف إن لم تكن النقاط قد وضعت على الحروف بعد ، وتستحق أن يذكرها الرواة ، وإن يتدارسها القارئ في أناة ، وأن يتذكر أنها حدثت بعد نصف قرن من وفاة الرسول ، فقط .. نصف قرن .. لقد هاجم جيش يزيد المدينة ، حين خلع أهلها بيعته وقاتل أهلها قليلاً ثم انهزموا فيما سمى بموقعة ( الحرة ) فأصدر قائد الجيش أوامره باستباحة المدينة ثلاثة أيام قيل أنه قتل فيها أربعة آلاف وخمسمائة ، وأنه قد فضت فيها بكارة ألف بكر ، وقد كان ذلك كله بأمر يزيد إلى قائد جيشه ( مسلم بن عقبة ) : ادع القوم ثلاثا فأن أجابوك وإلا فقاتلهم ، فإذا ظهرت عليها فأبحها ثلاثاً ، فكل ما فيها من مال أو دابة أو سلاح أو طعام فهو للجند ، فإذا مضت الثلاث فاكفف عن الناس ) ولم يكتف مسلم باستباحة المدينة بل طلب من أهلها أن يبايعوا يزيد على أنهم ( عبيد ) له ، يفعل فيهم وفي أموالهم وفي أولادهم ما يشاء ، وهنا يبدأ مسلسل المفاجآت في الإثارة ، فالبعض ما زال في ذهنه ( وهم ) أنه في دولة الإسلام ، وأنه قادر على إلزام مسلم ويزيد بالحجة ، بما لا سبيل إلى مقاومته أو حتى مناقشته ، وهو لا يقبل شروط مسلم ، ويرد عليه كأنه يلقمه حجراً : ( أبايع على كتاب الله وسنة رسوله ) . ولا يعيد مسلم القول ، بل يهوى بالسيف على رأس العابد الصادق في رأينا ، والرومانسي الحالم في رأى مسلم ، ويتكرر نفس المشهد مرات ومرات ، هذا يكرر ما سبق ، فيقتل ، وهذا يبايع على سيرة عمر فيقتل ، ويستقر الأمر في النهاية لمسلم ، وما كان له إلا أن يستقر ، فالسيف هنا أصدق أنباء من الكتب ، وهو سيف لا ينطق بلسان ولا يخشع لبيان ويصل الخبر إلى يزيد ، فيقول قولاً أسألك أن تتمالك نفسك وأنت تقرؤه ، وهو لا يقوله مرسلاً أو منثوراً ، بل ينظمه شعراً ، اقرأه ثم تخيل وتأمل وانذهل : ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل حين حكت بقباء بركها واستمر القتل في عبد الأشل
والذي يعنينا هو البيت الأول الذي يقول فيه ( ليت أجدادي في موقعة بدر شهدوا اليوم كيف جزع الخزرج من وقع الرماح والنبل ) أما من هم أجداده ، فواضح أنهم أعداء الخزرج في موقعة بدر ، والخزرج أكبر قبائل الأنصار ، وكانوا بالطبع في بدر ضمن جيوش المسلمين ، وهنا يزداد المعنى وضوحاً ، فيزيد خليفة المسلمين ، وأمير المؤمنين ، يتمنى لو كان أجداده من بني أمية ، ممن هزمهم الرسول والمهاجرون والأنصار في بدر ، يتمنى لو كانوا على قيد الحياة ، حتى يروا كيف انتقم لهم من الأنصار في المدينة ، ثم نجد من ينعت الخلافة بالإسلامية . ولا يتوقف أمام هذه الحادثة لكي يقطع الشك باليقين وليتحسر على الإسلام في يد حكام المسلمين ، وليترحم على شهداء الأنصار انتقاماً منهم لمناصرتهم للرسول والإسلام ، وعلى يد من ، على يد ( أمير المؤمنين ) وحامي حمى الإسلام والعقيدة ، ويروي ابن كثير في ( البداية والنهاية ) الأبيات السابقة في موضعين أحدهما موقعة الحرة وثانيهما عندما وصل رأس الحسين إلى يزيد . ولو صدقت الثانية لكانت أنكى وأمر ، لأن الانتقام هنا مباشر من الرسول في آل بيته ، ويضيف ابن كثير بيتاً يذكره متشككاً دون أن يقطع الشك باليقين ، داعياً باللعنة على يزيد إن كان قد قاله والبيت يقول
: لعبت هاشم بالملك فلا ملك جاء ولا وحي نزل
ولعلى استبعد أن يقول يزيد هذا ، فللفكر درجات ، وللمروق حدود ، وللتفلت مدى ، وكل ذلك لم يشفع لفقهاء عصر يزيد ولكـُتاب تاريخ الخلافة الإسلامية أن يذكروا أن يزيد مغفور له ، وأن ذلك ثابت بالأحاديث النبوية ، فابن كثير يذكر ( البداية والنهاية – المجلد الرابع الجزء الثامن ص 232.)
: ( كان يزيد أول من غزا مدينة القسطنطينية في سنة وأربعين .. وقد ثبت في الحديث أن رسول الله قال : " أول جيش يغزوا مدينة قيصر مغفور له " ) ... ولا تعليق وننتقل إلى يزيد بن عبد الملك ، التاسع في الترتيب بين خلفاء بني أمية ، وأحد أربعة تولوا الخلافة من أبناء عبد الملك بن مروان هم على الترتيب ، الوليد وسليمان ويزيد وهشام ، ونحن نخص منهم يزيد بالحديث ، لأنه أتى في أعقاب عمر بن عبد العزيز ، الذي قيل عنه أنه ملأ الدنيا عدلاً طوال عامين ، فإذا بيزيد يأتي بعده لكي يملأها مغاني وشراباً ومجوناً وخلاعة ، طوال أربعة أعوام ، ويذكر السيوطي ( تاريخ الخلفاء ص 246. ) : أنه ما أن ولي ( حتى أتى بأربعين شيخاً فشهدوا له ما على الخليفة حساب ولا عذاب ) . وهنا يدرك القارئ أن العلة لم تقتصر على الخلفاء ، وإنما امتدت أيضاً إلى العلماء والفقهاء ، وأنه ما دام هؤلاء يفتون أنه لا حساب على يزيد ولا عذاب ولا عقاب ، فليفعل يزيد ما يشاء ، وليتفوق على خلفاء الدولة الإسلامية كلها في بابين لا يطاوله فيهما أحد وهما العشق والغناء ، فقد بدأ خلافته بعشق ( سلامة ) وانتهت خلافته ، بل وحياته بسبب عشقه لجارية أخرى اسمها ( حبابة ) .
وقبل أن نتحدث عن بعض من ذلك ، نذكر له أيضاً رغبة تفرد بها بين الخلفاء ، وذكرت له ، ونقلت عنه ، وهي رغبته في أن ( يطير ) .. وقصة ذلك أنه كان يوماً في مجلسه ، فغنته حبابة ثم غنته سلامه ( فطرب طرباً شديداً ثم قال : أريد أن أطير ، فقالت له حبابة : يا مولاي ، فعلى من تدع الأمة وتدعنا ) .. طبعاً ، ماذا يفعل المسلمون لو طار الخليفة ، من يملأ أنحاء الدولة الإسلامية طرباً وغناء ، وعشقاً واشتهاء ، ويذكر المسعودي ( أن أبا حمزه الخارجي قال : اقعد يزيد حبابة عن يمينه وسلامه عن يساره ، وقال أريد أن أطير ، فطار إلى لعنة الله وأليم عذابه .
ويروي ابن كثير قصة وفاة يزيد على النحو التالي ( البداية والنهاية لابن كثير – مجلد 5 جزء 9 ص 242 ويذكر المسعودي نفس الرواية في مروج الذهب ج 3 ص 207) : ( وقد كان يزيد هذا يحب حظية من حظاياه يقال لها حبّابة – بتشديد الباء الأولى وكانت جميلة جداً ، وكان قد اشتراها في زمن أخيه بأربعة آلاف دينار ، من عثمان بن سهل بن حنيف ، فقال له أخوه سليمان : لقد هممت أن أحجر على يديك ، فباعها ، فلما بقى أفضت إليه الخلافة قالت امرأته سعدة يوماً : يا أمير المؤمنين ، هل بقى في نفسك من أمر الدنيا شيء ؟ قال نعم ، حبابة ، فبعثت امرأته فاشترتها له ولبستها وصنعتها وأجلستها من وراء الستارة ، وقالت له أيضاً : يا أمير المؤمنين ، هل بقى في نفسك من أمر الدنيا شيء ؟ ، قال : أو ما أخبرتك ؟ فقالت هذه حبابة – وأبرزتها وأخلته بها وتركته وإياها – فحظيت الجارية عنده وكذلك زوجته أيضاً ، فقال يوماً أشتهي أن أخلو بحبابة في قصر مدة من الدهر ، لا يكون عندنا أحد ، ففعل ذلك ، وجمع إليه في قصره ذلك حبابة ، وليس عنده فيه أحد ، وقد فرش له بأنواع الفرش والبسط الهائلة ، والنعمة الكثيرة السابغة ، فبينما هو معها في ذلك القصر ، على أسر حال وأنعم بال ، وبين أيديهما عنب يأكلان منه ، إذ رماها بحبة عنب وهي تضحك ، فشرقت بها وماتت ، فمكث أياماً يقبلها ويرشفها وهي ميتة حتى أنتنت وجيفت فأمر بدفنها ، فلما دفنها أقام أياماً عندها على قبرها هائماً ثم رجع فما خرج من منزله حتى خرج بنعشه )
والقصة كما يذكرها ابن كثير ، نموذج فريد لصحيح العشق ، وأصيل الغرام ، ولا بأس أن تذوب لها قلوب الصبية ، وتنفطر لها قلوب الصبايا ، وتسيل من أجلها قلوب المحبين ، لكنها – في تقديرنا – شاذة أشد ما يكون الشذوذ ، بعيدة أكثر ما يكون البعد ، عندما يتعلق الأمر بأمير المؤمنين ، وإمام المسلمين ، وخادم الحرمين ، وحامي حمى الإيمان ، والملتزم بأحكام القرآن ، وبسنة نبي الرحمن . ولعلنا نتساءل ومعنا كل الحق ، ما بال المطالبين بعودة الخلافة يستنكرون الحانات ، ويفسقون المغنيات ويكفرون الراقصات ، بينما هذا من ذاك بل هذا بعض ذاك ، ولقد عاصر يزيد أئمة كباراً ، وفقهاء عظاماً من أمثال الحسن البصري وعمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وغيرهم ، وكانوا أقرب ما يكونون إلى التقية ، وكانوا يوصلون بالعطايا ويتحفون بالهدايا ، ويؤدون أحياناً دوراً مرسوماً بدقة ، محدداً بحنكة ، يظهر فيه الخليفة مسبل العينين ، يسألهم فيجيبون ، ويطلب منهم الموعظة فيعظون ، وربما خوفوه من النار ، وعذاب الجبار، ووحدة القبر ، وموقف الحشر، وهو منصت خاشع ، تسيل دموعه مدراراً ، بينما هم مدركون لحدود الحديث ، ومدى الموعظة ، لا يتجاوزون إلى التعريض بالخلافة ، أو التهديد بتأليب الرعية ، أو الحكم بالكفر ، ذلك كله خارج السيناريو المرسوم والمعلوم ، والذي ينتهي دائماً بصراخ الخليفة ونحيبه ، حتى يخشى عليه أو يغشى عليه ، أيهما أقرب إلى قدراته ، وأنسب لملكاته ، وما أسرع ما ينتقل الأمر إلى الرعية بسرعة البرق، فيتداولونه في خشوع وإيمان ، وينقله إلينا كتاب الديوان ، فنشربه كما شربته رعية يزيد وغير يزيد ، ونشرب معه المزيد ، مما تسطره أقلام المحترفين ، وتردده على مسامعنا ألسنة المكفرين والجهاديين ، ما علينا ، ففي الجعبة مزيد . غير أنا نتوقع أن يعترض علينا معترض ، رافعاً في وجهنا ما يراه حجة ، منكراً علينا ما أنكرناه على يزيد ، مؤكداً لنا أن يزيد لم يرتكب منكراً ، ولم يقترف إثماً ، فالتسري بالجواري والتمتع بما ملكت الأيمان أمر لا ينكره الشرع ، ولا يشترط فيه القران ، ولا ينهى عنه القرآن ، وهو رخصة ترخص بها يزيد ، وترخص بها كبار الصحابة قبل يزيد ، والله يحب أن تؤتي رخصة كما تؤتي عزائمه .
وقد كان يزيد ككثيرين في عصرنا ، يتعشقون الرخص ، ويسبقون بها العزائم ، وهنا نقول له قف ، وحاذر فأنك تركب صعباً ، فنحن وأن وافقناك على أن التسري بالجواري والتمتع بها ملكت الأيمان ، لا يتناقض مع روح عصر يزيد ، ولا يخالف أحكام القرآن ، إلا أنك يجب أن تدرك أن للإسلام روحاً ، وللدين جوهراً ، وللرخص حدوداً . وليس منطقياً أن تكون إباحة التسري سبيلاً إلى التهتك ، أو التمتع بما ملكت الأيمان وسيلة لهجر الإيمان ، أو الحلال سبيلاً إلى التحلل ، وإذا كنا نناشد الرعية غض البصر ، ونتوعدهم بالعذاب إذا زنى النظر، فلا أقل من أن ننهى الخليفة عن التفرغ للخلوة على أسر حال وأهنأ بال ، لاثماً راشفاً متمنياً أن يطير، لا لشيء إلا لأن الله أعطاه جناحين ، من مال وسلطان ، فتوسع فيما ملكت الأيمان . ولعل يزيد لم يكن في ذلك فلتة ، فقد روي عن الخليفة المتوكل – العباسي أنه : ( كان منهمكاً في اللذات والشراب ، وكان له أربعة آلاف سرية ، ووطىء الجميع ) ( تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 349 – 350 ) . وقد تثير هذه القدرات الخارقة لعاب منتجي أفلام ( البورنو ) في عصرنا الحديث ، لكنها ممجوجة مكروهة إن كان الحديث عن الحكام، في الإسلام أو حتى في غير الإسلام ، ولعل هذا كاف حتى يلزم المعترض علينا حده ، ويثوب إلى رشده ، ويتركنا ننتقل من حديث يزيد إلى حديث ولده ، الوليد بن يزيد الذي أوصى له يزيد بالخلافة بعد أخيه هشام ، ووفى هشام بعهده لأخيه ، رغم ما كان يسمعه ويأتيه ، من أخبار فسق الوليد ومجونه ، وهي أخبار تأكدت بعد ولايته ، حين فاق الوليد أباه بل فاق ما عداه ، وفعل ما لم يفعله أحد في الأولين والآخرين ، حيث يروي عنه أنه قد اشتهر بالمجون وبالشراب وباللواط وصدق أو لا تصدق ، برشق المصحف بالسهام ، وكان إلى جانب ذلك شاعراً مطبوعاً ، سهل العبارة ، يحسن اختيار الألفاظ ورويه .
وقد شاء الله أن يروقه هذه الموهبة حتى يخلد لنا آثاره شعراً يتناقله الرواة ، ويتبعونه بالعياذ بالله ، وبلا حول ولا قوة إلا بالله ، وربما بشهادة أن لا إله إلا الله ، ومن حسن حظ الوليد ، وسوء حظ القارئ أن كثيراً من شعره وبعضاً من قصصه ، لا نستطيع روايته لوقاحة ألفاظه ، وشذوذ أفعاله ، لكن لا بأس أن نبدأ حديث الوليد بالمدافعين عنه : فقد ( قال الذهبي : لم يصح عن الوليد كفر ولا زندقة ، بل اشتهر بالخمر والتلوط ، فخرجوا عليه لذلك ، وذكر الوليد مرة عند المهتدي فقال رجل : كان زنديقاً ، فقال المهتدي : مه ، خلافة الله عنده أجل من أن يجعلها في زنديق ) هذا حديث المدافعين عن الوليد ، المنكرين أن يتهم بالكفر، أو أن يوصف بالزندقة ، وهم في دفاعهم يسوقون حججاً هشة ، فمن قائل أنه لم يتجاوز التلوط أو شرب الخمر، وكأن ذلك هين ويسير، ومن قائل أن الله أرحم من أن يجعل خلافته في زنديق ، بينما نرى أن الله قد رحمنا بخلافة الزنادقة ، من أمثال الوليد ، حتى يعطي أمثالنا حجة نفحم بها المزايدين ، المدعين أن الدولة لا تنفصل عن الدين ، وأنهما معاً حبل الإسلام المتين ، بينما حقيقة الأمر أن الإسلام في أعلى عليين ، وأنه لا يضار إلا بالمسلمين ، وعلى رأسهم الحكام باسم الإسلام ، وإنه لا ضمان للمحكومين إن جار الحكام وأفسدوا ، فبيعتهم مؤبدة ، والشورى – إن وجدت – غير مُلزِمة ، أو إن شئنا الدقة مقيدة . وأقرأ معي ما فعل الوليد حين (قرأ ذات يوم – "
واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد ، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد
" – فدعا بالمصحف فنصبه غرضاً للنشاب " السهام " وأقبل يرميه وهو يقول:
أتوعد كل جبار عنيد فها أنا ذاك جبار عنيد
إذا ما جئت ربك يوم الحشر فقل يارب خرقني الوليد
وذكر محمد بن يزيد المبرد " النحوي " أن الوليد ألحد في شعر له ذكر فيه النبي وأن الوحي لم يأته عن ربه ، ومن ذلك الشعر:
تلعب بالخلافة هاشمي بلا وحي أتاه ولا كتاب
فقل لله يمنعني طعامي وقل لله يمنعني شرابي
ولعل القارئ بعد قراءة ما سبق لا يذهل كما ذهلنا ، ولا ينزعج كما حدث لنا ، ونحن نذكر له أن الوليد حاول نصب قبة فوق الكعبة ليشرب فيها عام حج هو ورفاقه وأن حاشيته نجحت في إقناعه أن لا يفعل بعد لأى ، وأنه في ( تلوطه ) راود أخاه عن نفسه ، فالواضح من سيرته أنه أطلق لغرائزه العنان ، حتى غلبت شهوة الغناء والشراب على الخاصة والعامة في أيامه كما يذكر المسعودي ، وتألق نجوم الغناء في عصره ، فكان منهم ابن سريج ومعبد والغريض وابن عائشة وابن محرز وطويس ودحمان ، ولعله أدرك أنه تجاوز الحد ، فلم يعد يعنيه أن يضيف إلى ذنوبه ذنباً ، أو إلى سيرته مثلباً ، شأنه في ذلك شأن ضعاف الإيمان ، حين يقنطون من رحمة الله ، فيضاعفون من معاصيهم ، ونحن في هذا لا نلتمس له عذراً ، وإنما نعبر عن رأيه هو في نفسه ، حين أطلقه شعراً فقال :
اسقني يا يزيد بالقرقارة قد طربنا وحنت الزمارة
اسقني اسقني، فإن ذنوبي قد أحاطت فما لها كفارة
وبالفعل ، فقد أحاطت به الذنوب ، وتألب عليه الصالحون ، وانتهى الأمر بخروج ابن عمه يزيد بن الوليد عليه ، وقتله ، بعد خلافة قصيرة استمرت عاماً وثلاثة أشهر وشاء القدر أن تكون خلافة يزيد أقصر، فلا تستمر إلا خمسة شهور يموت بعدها ليتولاها بعده شقيقه إبراهيم لمدة سبعين يوماً فقط ثم يعزل على يد مروان بن محمد ، انتقاماً لمصرع الوليد بن يزيد ، ثم ينتهي عصر الدولة الأموية بمصرع مروان على يدي العباسيين ، بعد خلافة استمرت حوالي خمس سنوات . ونتوقف قليلا قبل أن ننتقل إلى خلافة العباسيين ، مستخلصين نتيجتين نوجزهما فيما يلي :
النتيجة الأولى: أننا نشهد في الدولة الأموية عهداً مختلفاً كل الاختلاف عن عهد الراشدين ، أضاف إلى فتوحات الإسلام الكثير، حتى امتدت الدولة الإسلامية من الهند شرقاً إلى الأندلس غرباً ، وأضاف إلى سلطة الدولة وهيبتها وتماسكها الكثير، حيث لم يخرج فيها أحد من الأمويين على آخر، إلا في نهاية الدولة حين خرج يزيد على الوليد ، ثم خرج مروان على يزيد فكان ذلك نذيراً بالنهاية ، بينما حفل تاريخ العباسيين بكثير من الخروج والانقسام داخل الأسرة الحاكمة حتى قتل الإبن أباه ، والأب ابنه ، وشاع خلع الخلفاء وسمل أعينهم ، وقتلهم بسحق مذاكيرهم ، وغير ذلك من الأحداث على مدى الخمسمائة عام الأخيرة في حكم العباسيين . وعلى حين يبدو أبو جعفر المنصور ، والمأمون ، رجال دولة متفردين في تاريخ الدولة العباسية ، لا يناظرهم أحد ، ولا يطاولهم مطاول ، نرى أن الدولة الأموية على قصر عمرها قد حفلت برجال الدولة العظام ، وعلى رأسهم معاوية ، ورجل الدولة الأول في تاريخ الدولة الإسلامية كلها . وقد يتساءل البعض ، وأين عمر؟ ونرد عليه بأن عمر قد تفرد بأنه الوحيد في تاريخ الخلافة الإسلامية الذي يمكن أن يطلق عليه وصف ( رجل الدين والدولة معاً ) ، بينما لا تجتمع الصفتان بعد ذلك لأحد ، فهناك رجال الدين مثل علي بن أبي طالب ، ( رابع الراشدين ) ، وعمر بن عبد العزيز، ( الأموي ) ، والمهتدي ( العباسي ) . وهناك رجال الدولة مثل ( معاوية ) ، ( عبد الملك بن مروان ) ، ( الوليد بن عبد الملك ) ، ( هشام بن عبد الملك ) ، وهم أربعة خلفاء حكموا سبعين عاماً ، بينما حكم الفترة الباقية ( اثنتين وعشرين عاماً ) عشرة خلفاء بالتمام والكمال . وحينما نذكر أسماء الخلفاء الأربعة السابقين مقترنا بلقب ( رجل الدولة ) ، نضع في اعتبارنا هيبة الحكم ، وفتح الثغور، وعمارة البلدان ، وفي تقديرنا أن هؤلاء الخلفاء ، قد ارتبط ارتباطاً وثيقاً بفصلهم بين الدين والدولة عند قيامهم بأمانة الحكم ، ولعل موقف معاوية من ( علي ) مثال أوضح على ذلك ، ولعل موقف عبد الملك بن مروان من المصحف عندما بلغته نبأ ولايته مثال أوضح ، وقد أدرك كل منهم أنه لا يولى بصفته الأصلح دنياً ، أو الأكثر إيماناً ، وإنما يولى بوسائل دنيوية محضة ، وعليه إن أراد أن يستمر، أن يضع نصب عينه أن الولاية من جنس التولية ، فكلاهما دنيا وسطوة وحكم ، وقد أجاد الخلفاء الأربعة اختيار معاونيهم ، فكان منهم عمرو بن العاص ، والمغيرة بن شعبة ، وزياد بن أبيه ، ومسلم بن عقبة ، والحجاج بن يوسف الثقفي ، وهم بموازين السلطة والسطوة رجال ، وبمقاييس عصرهم قادة ، وهم أهل الدهاء لا النقاء ، والسيف لا المصحف ، وقد أرتأوا جميعاً أن أسهل السبل لإسكات المعارض قطع رأسه ، وأن الخوف إذا تمكن من النفوس توطن فيها ، فمكنوه ووطنوه وتعهدوه بالرعاية حتى صار مارداً ، وحذوا حذو مؤسس دولتهم معاوية ، رجل الغاية لا الوسيلة ، رجل الحكمة الشهيرة ( إن لله جنوداً من عسل ) ، حيث يروى عنه أنه كان يضع السم لمعارضيه في العسل، وأنه هكذا كانت نهاية الحسن ، والأشتر النخعي وغيرهم ، ورغم أن أحداً لا يقر معاوية ، أو غيره على فعالهم أو على الأقل لا يدعو للتأسي بهم ، إلا أنه من الواجب أن نتعلم مما فعلوا درساً بليغاً ...إن على الحاكم ـ أي حاكم ـ أن يتعرف جيداً على ساحته ، وأن يتمسك جيداً بأسلحته ، وأن ينأى بنفسه وبحكمه عن استعارة سلاح الآخرين ، أو الانتقال إلى ساحتهم ، أو الرقص على أنغامهم ، ولو حاول معاوية أو عبد الملك ، ولو حاول مساعدهم مثل زياد أو الحجاج ، أن يحتكموا إلى القرآن ، أو يناظروا مخالفيهم حول صحيح الإيمان ، أو يفسروا قراراتهم بتعاليم الإسلام ، أو يتباهوا على المخالفين لهم والخارجين عليهم بالصلاح والتقوى ونظافة اليد ونقاء السريرة ، لانتهي حكمهم قبل أن يبدأ ، ولأخلى معاوية مكانه لحجر بن عدى ، ولتنازل عبد الملك عن منصبه للحسن البصري ، لكنهم احتكموا للسيف ، وهو دستور عصرهم ، فدانت لهم الدولة ، وسهل عليهم الحكم ، وربما سعدت الرعية بالاستقرار والأمن والأمان . ولعل عصرنا لا يخلو من سيف متحضر هو الدستور، لا يسيل دماً وإنما يحفظ استقراراً ، ولا يطيح برؤوس وإنما يلزمها جادة الصواب ، وليس لحاكم في عصرنا ، أو لنظام حكم في عالمنا المعاصر إلا أن يستوعب درس السابقين ، بأسلوب العصر لا بأسلوبهم ، وليس له أن يحاور الخارجين في ساحتهم ، أو بسلاحهم أو أن يرقص على أنغامهم ، وإنما عليه أن يلزمهم بالمحاورة في ساحته ، فليس أمامه ولا أمامهم ساحة غير ساحة الدستور، وليس هناك من سلاح إلا القانون ، وليس هناك من أنغام إلا الديمقراطية والشرعية ، ليحمدوا الله أن يجدوا فينا يزيداً ، ولم يتطرف منا وليد ، ولم يتول وزارة الداخلية في بلادنا حجاج ، ولم يتملك منا عبد الملك ، ولم يدع أحد من حكامنا أنه لا حساب عليه ولا عقاب ، غاية ما في الأمر أنه يوكل إلينا حساب السياسة في أمور السياسة ، ويحتكم أمامنا إلى الدستور ومؤسسات الدولة في أمور الحكم ، ويترك ونترك حساب الآخرة إلى الله وليس إلى الجماعات الإسلامية أو أئمة المساجد المسيسين.
النتيجة الثانية : أن الشعر والأدب وفن العمارة والغناء بل وأكثر من ذلك مذاهب الفقه واجتهادات الفقهاء ، قد بدأت في الظهور والتألق مع نهاية الدولة الأموية ، ومع انحسار القيود ( الشكلية ) للدولة الدينية ووصلت للغاية في العصر العباسي الأول . يكاد القارئ يلاحظ علاقة طردية بين دنيوية الدولة وتألق الفكر والأدب والعلوم والفنون والفقه ، فحينما تزداد هذه يتألق أولئك ، وعلى العكس من ذلك يضمحل كل شيء مع ازدياد سطوة الدين في الدولة الدينية إلا العبادة وقصص الزهاد وأقوال الصالحين . ولا أحسب أن ما أذكره هنا استنتاج بقدر ما هو حقيقة بسيطة وواضحة ، وقد مضى عهد الراشدين ، وخلدت لنا كتب التاريخ سكناته وأحداثه ، فلم تسمع فيه قصيدة لافتة ، أو فنا يطرب أو يهز الوجدان أو يبقى للأجيال ، ذلك لأن الفن حرية ، والحرية لا تتجزأ ، والفنان لا يتألق إلا إذا أحس بفكره طليقاً ، وبوجدانه منطلقاً ، وبوجدان الآخرين مرحباً ، وبأذهانهم سعيدة بإبداعاته ، مستعدة أن تغفر له شطحاته ، مقبلة على الحياة لا على الموت ، متفتحة للنغم لا للوعيد . ولا أحسب أن ذلك كله جزء من طبيعة الدولة الدينية ، بل هو متنافر معها كل التنافر، متناقض مع قواعدها ، أشد التناقض ، ولعل إحدى مشاكل الداعين للدولة الدينية أنهم يدركون أنها تحجر على كل إبداع أو تفتح أو إجهاد للذهن أو اجتهاد للعقل ، وأن كل ما يعيشه الناس ويتقبلونه تقبلاً حسناً ، لا يمكن قبوله بمقاييس الدولة الدينية بحال ، فالأغاني مرفوضة ، والموسيقى مكروهة عدا الضرب على الدفوف ، والمغنيات فاجرات نامصات متنمصات، والمتغنون بغير الذكر ومدح الرسول فاسقون يلهون المسلمين عن ذكر الله ويدعونهم إلى الفاحشة ، وممارسة المرأة للرياضة فتنة وإثارة للفتن ، واختلاطها بالرجال جهر بالفسق ، والتمثيل مرفوض لأنه كذب ، ولأن هزله جد وجده هزل ورسم الصور للأحياء حرام ، وإقامة التماثيل شرك ، والديمقراطية مرفوضة لأنها حكم البشر وليس حكم الله ، ومعاملة أهل الذمة على قدم المساواة إن لم تكن منكراً فهي مكروهة ، ولا ولاية للذمي ، وباختصار عليهم أن يهدموا كل شيء ، ويظلموا كل شيء ، ويمنعوا كل شيء ، وأن تقام دولتهم على أنقاض كل شيء ، وبديهي أن الحديث في هذا الإطار عن حرية الفكر لغو ، وأن ادعاء حرية العقيدة هراء ، وأن تصور نهضة الأدب أو الفن نوع من أحلام اليقظة لا يستقيم مع الواقع ، ولا يستقيم الواقع معه ، ولعل هذا أحد أسباب حرصهم على الامتناع عن بلورة برنامج سياسي متكامل ، به قدر قليل من المواعظ والكلمات الطنانة ، وقدر كبير من تصور الواقع أو معايشته ، وبه قدر ولو معقول من احترام عقولنا ، ناهيك عن احترام مشاعرنا . وننتقل إلى دولة العباسيين...
قراءة جديدة في أوراق العباسيين
ليست الدولة العباسية في حاجة إلى تقديم ، فقد قدمت نفسها على يد مؤسسها ، السفاح ، أول خلفاء بني العباس ، المعلن على المنبر يوم مبايعته ( أن الله رد علينا حقنا ، وختم بنا كما افتتح بنا ، فاستعدوا فأنا السفاح المبيح ، والثائر المبير ) . وقد أثبت السفاح أنه جدير بالتسمية ، فقد بدأ حكمه بقرارين يغنيان عن التعليق وأظن أنه ليس لهما سابقة في التاريخ كله ، كما لا أظن أن أحداً بعد السفاح قد بزه فيما أتاه ، أو فاقه فيما فعل : *
أما القرار الأول ، أو القرار رقم (1) بلغة العصر الحديث فهو أمره بإخراج جثث خلفاء بني أمية من قبورهم ، وجلدهم وصلبهم ، وحرق جثثهم ، ونثر رمادهم في الريح ، وتذكر لنا كتب التاريخ ما وجدوه : فيقول ابن الأثير( الكامل في التاريخ لابن الأثير ) :
(فنبش قبر معاوية بن أبي سفيان فلم يجدوا فيه إلا خيطاً مثل الهباء، ونبش قبر يزيد بن معاوية بن أبي سفيان فوجدوا فيه حطاماً كأنه الرماد ، ونبش قبر عبد الملك بن مروان فوجدوا جمجمته ، وكان لا يوجد في القبر إلا العضو بعد العضو غير هشام بن عبد الملك فإنه وجد صحيحاً لم يبل منه إلا أرنبة أنفه فضربه بالسياط وصلبه وحرقه وذراه في الريح ، وتتبع بني أمية من أولاد الخلفاء وغيرهم فأخذهم ولم يفلت منهم إلا رضيع أو من هرب إلى الأندلس) ويروي المسعودي القصة بتفصيل أكثر
فيقول ( مروج الذهب للمسعودي ) : (حكى الهيثم بن عدي الطائي ، عن عمرو بن هانئ قال : خرجت مع عبد الله بن علي لنبش قبور بني أمية في أيام أبي العباس السفاح ، فانتهينا إلى قبر هشام ، فاستخرجناه صحيحاً ما فقدنا منه إلا خورمة أنفه ، فضربه عبد الله بن علي ثمانين سوطاً ، ثم أحرقه ، واستخرجنا سليمان من أرض دابق ، فلم نجد منه شيئاً إلا صلبه وأضلاعه ورأسه ، فأحرقناه ، وفعلنا ذلك بغيرهم من بني أمية ، وكانت قبورهم بقنسرين ، ثم انتهينا إلى دمشق ، فاستخرجنا الوليد بن عبد الملك فما وجدنا في قبره قليلاً ولا كثيراً ، واحتفرنا عن عبد الملك فلم نجد إلا شئون رأسه ، ثم احتفرنا عن يزيد بن معاوية فلم نجد إلا عظماً واحداً ، ووجدنا مع لحده خطاً أسود كأنما خط بالرماد في الطول في لحده ، ثم اتبعنا قبورهم في جميع البلدان ، فأحرقنا ما وجدنا فيها منهم ) .
ولعلي أصارح القارئ بأنني كثيراً ما توقفت أمام تلك الحادثة بالتأمل ، ساعياً لتفسيرها أو تبريرها دون جدوى ، مستبشعاً لها دون حد ، فقد يجوز قتل الكبار تحت مظلة صراع الحكم ، وقتل الصغار تحت مظلة تأمين مستقبل الحكم ، ومحو الآثار تحت مظلة إزالة بقايا الحكم ( السابق ) لكن إخراج الجثث .. وعقابها .. وصلبها .. وحرقها .. أمر جلل .. والطريف أن البعض رأى في ذلك معجزة إلهية ، فالجثة الوحيدة التي وجدت شبه كاملة .. وعذبت ( إن جاز التعبير ) وصلبت .. وحرقت ثم نثر رمادها في الريح هي جثة هشام بن عبد الملك ، وقد رأى البعض في ذلك انتقاماً إلهياً من هشام إذ خرج عليه زيد بن علي بن الحسين ، وقتل في المعركة ، ودفنه رفاقه في ساقية ماء ، وجعلوا على قبره التراب والحشيش لإخفائه ، فاستدل على مكانه قائد جيش هشام ، ( فاستخرجه وبعث برأسه إلى هشام ، فكتب إليه هشام : أن اصلبه عرياناً ، فصلبه يوسف كذلك ، وبنى تحت خشبته عموداً ثم كتب هشام إلى يوسف يأمره بإحراقه وذروه في الرياح ) ( مروج الذهب للمسعودي – ج3ص219 ) .
وإذا فسرنا ما حدث لهشام بالانتقام وبالجزاء من جنس العمل ، فماذا نفسر ما حدث لغيره ، وفي أي نص من كتاب الله وسنة رسوله وجد العباسيون ما يبرر فعلتهم ، وأين كان الفقهاء والعلماء من ذلك كله ، أين أبو حنيفة وعمره وقتها قد تجاوز الخمسين ، وأين مالك وعمره وقتها قد تجاوز الأربعين ، ولم لاذوا بالصمت ولم لاذ غيرهم بما هو أكثر من الصمت ، أقصد التأييد ، والتمجيد ، والأشعار ، ورواية الأحاديث المنسوبة للرسول والمنذرة بخلافة السفاح ومنها ما أورده ابن حنبل في مسنده مثل ( يخرج رجل من أهل بيتي عند انقطاع من الزمان وظهور من الفتن ، يقال له السفاح ، فيكون إعطاؤه المال حثياً ) . ومثل ما ذكره الطبري من ( أن رسول الله أعلم العباس عمه أن الخلافة تؤول إلى ولده ، فلم يزل ولده يتوقعون ذلك ) . أو لعلهم كانوا بقصة مأدبة السفاح ،
وهي ما أشرنا إليه بالقرار الثاني في خلافته ، وهو قرار خليق بأن في أيامنا هذه في معاهد السينما كنموذج رائع لحبكة الإخراج ، وتسلسل السيناريو وترابطه ، ليس هذا فحسب ، بل أن القرار قد سبقته ( بروفة ) ، أي تجربة حية في نفس موقع التمثيل . ولن يشك القارئ في أن كل ما حدث كان مرتباً ، وأن الأقدمين كانوا على دراية واسعة بفن التشويق ، وكانوا أيضاً على مقدرة كبيرة في تدبير المفاجأة ، ثم تبريرها بحيث تمر طبيعية ومتناسقة ومتسقة مع سياق الأحداث ، ولنبدأ بالبروفة ولنقرأها معاً كما ذكرها ابن الأثير ( الكامل في التاريخ لابن الأثير – ج4 ص 333 ) ( دخل سديف " الشاعر " على السفاح وعنده سليمان بن هشام بن عبد الملك ، وقد أكرمه فقال سديف :
لا يغرنك ما ترى من رجال إن تحت الضلوع داء دوياً
فضع السيف وارفع السوط حتى لا ترى فوق ظهرها أموياً
فقال سليمان : قتلتني يا شيخ ، ودخل السفاح وأخذ سليمان فقتل ) ومن قراءة ما ذكره ابن الأثير يمكن ترتيب سيناريو الأحداث على النحو التالي : السفاح يؤمن أحد كبار الأمويين ( نجل خليفة سابق ) – السفاح يبالغ في تأمينه وطمأنته بدعوته إلى الطعام ، وإكرامه – يدخل شاعر على السفاح ويبدو دخوله كأنه مفاجأة – ينطق الشاعر بأبيات تدعو للانتقام من الأمويين وتستنكر معاملتهم بالرفق واللين – يصرخ الأموي قائلاً : قتلتني يا شيخ – ينفعل الخليفة بقول الشاعر فيقتل الأموي – ينتهي المشهد . والآن إلى القرار أو الحادثة أو الفيلم الكامل لما فعله السفاح بعد ذلك وكرر فيه نفس ما حدث في البروفة ، مع إتقان أكثر ، وتفنن غير مسبوق في التمثيل ( بالأمويين ) ، ولنقرأ معا ما ذكره ابن الأثير : ( دخل شبل بن عبد الله مولى بني هاشم " وفي رواية أخرى سديف " على عبد الله بن علي " وفي رواية أخرى على السفاح " وعنده من بني أمية نحو تسعين رجلاً على الطعام فأقبل عليه شبل فقال :
أصبح الملك ثابت الأساس بالبهاليل من بني العباس
طلبوا وتر هاشم فشفوها بعد ميل من الزمان وباس
لا تقيلن عبد شمس عثارا واقطعن كل رقلة وغراس
ذلها أظهر التودد منها وبها منكم كحر المواسي
أنزلوها بحيث أنزلها الله بدار الهوان والإتعاس ( إلى آخر القصيدة .. )
فأمر بهم عبد الله ( وقيل أنه السفاح ) فضربوا بالعمد حتى قتلوا وبسط عليهم الأنطاع فأكل الطعام عليها وهو يسمع أنين بعضهم حتى ماتوا جميعا ) . والرواية السابقة تبدأ بتأمين السفاح للأمويين الذين زاد عددهم هذه المرة إلى تسعين ، والمأدبة هي نفسها ، وما دام المضيف هو الخليفة فالكرم وارد ، والطمأنينة لا حد لها ، وفجأة يدخل الشاعر ، ويستنكر اكرامهم ، ويدعو للثأر منهم ، فيتغير وجه الخليفة ، ويقوم إليهم ثائراً ، و...
وهنا نتوقف لأن هنا جديداً مفزعاً ، فقد أمر السفاح بضرب رؤوسهم بأعمدة حديدية ، بحيث تتلف بعض مراكز المخ ، ويبقى الجسد حياً ، مصطرعاً بين الحياة والموت ، وما أن يرى السفاح أمامه تسعين جسداً منتفضاً ، تقترب مسرعة من الموت ، وترتفع أصواتها بالأنين ، حتى يأمر بوضع مفارش المائدة فوقهم ، ثم يجلس فوق هذه المفارش ، ويأمر بالطعام فيوضع أمامه فوق الأجساد ، ويبدأ في تناول عشائه بينما البساط يهمد هنا ويهمد هناك ، وبين همود وهمود ، يزدرد هو لقمة من هذا الطبق ، ولقمة من ذاك ، حتى همد البساط كله ، ففرغ من طعامه ، وتوجه إلى الله بالحمد ، وإلى حراسه بالشكر ، وإلى خاصته بالتهنئة ، ولعله قال لنفسه ، أو لخاصته ، والله ما أكلت أهنأ ولا ألذ ولا أطيب من هذا الطعام قط ، فليس أقل من هذا الحديث ما يلائم سلوك السفاح ، ذلك الذي يزدرد اللقيمات على زفرات الأنين ، ويساعده على الهضم صعود الأرواح ، وقد نفهم أن يقتل الحاكم الجديد حكام الأمس ، أو أن يتخلص بالقتل من منافسيه على الحكم ، أو مناوئيه على السلطة ، فقد حدث هذا كثيراً ، وأقرب نماذجه مذبحة المماليك بالقلعة على يد محمد علي ، لكن ما لا نفهمه ، أن يجلس الخليفة فوق الضحايا ، وأن يهنأ له الطعام فوق بركة من الدماء ، وعلى بساط يترجرج مع اصطراع الأجساد ، وعلى أنغام من صراخ الضحايا حين يواجهون الموت ، بل ربما وهم يسعون إليه هرباً من الألم والعذاب ..
نحن هنا أمام تساؤل تطرحه هذه الحادثة، وأمثالها كثير، قبل السفاح وبعد السفاح ، ربما ليست بهذه الروعة في الإخراج ، أو الحنكة في التدبير ، أو السادية في العبير ، لكنها في النهاية تحمل نفس الدلالة وتنقل إلينا نفس الرسالة ، يتساوى في ذلك مقتل حجر بن عدي على يد معاوية أو الحسين على يد يزيد أو ابن الزبير على يد الحجاج أو ( زيد بن علي ) على يد هشام . والتساؤل عن كنه الخلافة التي يدعون أنها إسلامية وينادون بعودتها من جديد ، هل هي إسلامية حقاً فنزنها بمقياس الإسلام ، فتخرج منه ، وتنبوعنه ، وينتهي الحوار حولها إلى موجز مفيد ، فحواه أنهم ادعوا أنها إسلامية فأثبتنا أنها لم تكن ، وكفى الله المؤمنين شر ( الخلافة ) ، أم أنها كانت حكماً استبدادياً يتستر برداء الدين ، فنثبت عليهم الحجة ، ونلقمهم حجراً علمانياً حين نوضح لهم الفرق بين استبداد الحكم الديني في العصور الوسطى ، عصور الاستبداد والتعذيب والجبروت ، وعلمانية العصر الحديث ، عصر الديمقراطية وحقوق الإنسان واحترام الآدمية . أحسب أن الأمر لا يخرج عن ادعاء من الادعاءين ، وأحسب أيضاً أن الإجابة واضحة في الحالين ، غير أن ذلك كله يطرح سؤالاً أكثر وضوحاً ، وهو لوضوحه وبساطته لا يحتاج من القارئ إلى جهد أو اجتهاد لإجابته :
هل صحيح أن العلمانية هم غرب لا هم شرق ، وأنها مبررة في الغرب باستبداد الحكم بالدين أو باسم الدين ، بينما لم نعرف نحن في الشرق نظيراً لذلك ، أو مثالاً له ؟ ، أحسب أنه لو كان مبرر العلمانية في الغرب هو استبداد الحكم في الكنيسة ، لكان مبررها في الشرق هو استبداد الحكم في ظل ( الخليفة ) ، سلطان الله في أرضه ، القاتل لمن يشاء ، المانح للعطاء ، والمانح للبلاء . وإذا كان السفاح قد وصف نفسه على المنبر بأنه السفاح المبيح ، فأن رياح بن عثمان والي الخليفة المنصور على المدينة قد وصف نفسه على منبر الرسوم بما هو أنكى حيث قال
: ( يا أهل المدينة ، أنا الأفعى ابن الأفعى ) ( اليعقوبي – ج2ص251) . وإذا تباهى الخلفاء بأنهم سفاحون ، وتباهى الولاة بأنهم أولاد الأفاعي ، أيبقى من يدعي أن الاستبداد باسم الدين هم غرب ، وأن العلمانية كخلاص منه فكر غربي وافد لا علاقة له بواقع الشرق وهمومه ؟ أحسب أن البعض الآن يردد بينه وبين نفسه ، ها هو يصطاد في الماء العكر ، ويتوقف كثيراً عند السفاح حتى ينال مأربه في الطعن في الخلافة الإسلامية ، لكن ردنا عليه يسير ، فليست هناك علاقة بين السفاح وبين الإسلام أو الحكم به ، فليقل عنه ما يشاء ، وليطعن فيه كما يشاء ، وليحاور وليداور ، فليس في هذا كله غناء ، فالمسافة بين حكم السفاح والحكم بالإسلام كالمسافة بين الأرض ، سابع أرض ، والسماء ، سابع سماء .. ولحسن الحظ – حظي وحظ القارئ – أن الرد على ذلك من أيسر ما يكون ، فلولا الإسلام ، المظهر لا الجوهر ، والرداء لا المضمون ، ما فعل السفاح ما فعل ، لا هو ولا سابقوه ، ولا لاحقوه ، فأي ولاء كان يربط المصري مثلاً بالسفاح في الأنبار ، أليس هو الولاء لخليفة المسلمين ، وللحاكم باسم الإسلام ، وأي دافع لهذا الولاء ، أليس الدافع هو الارتباط بالإسلام ، وجيوش الأحاديث النبوية التي نسبها الوضاعون للرسول حول خلافة بني العباس ، واجتهادات الفقهاء عن طاعة الخليفة ولو كان غاشماً ، وفسق الخارج عن الطاعة ، وكفر المفارق للجماعة ، وأي مدخل ساقه السفاح في خطاب توليته وتناقله الرواة ، وردده الوعاظ ، أليس هو مدخل العدل والتقى والعقيدة ، أليس هو القائل على المنبر( تاريخ الأمم والملوك للطبري – ج16 ص82 – 84) :
( الحمد لله الذي اصطفى الإسلام وشرفه وعظمه واختاره لنا وأيده بنا وجعلنا أهله وكهفه وحصنه والقوام به والذابين عنه والناصرين له وألزمنا كلمة التقوى وجعلنا أحق بها وأهلها وخصنا برحم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابته – إني لأرجو أن لا يأتيكم الجور من حيث أتاكم الخير ولا الفساد من حيث جاءكم الصلاح وما توفيقنا أهل البيت إلا الله ) . ولأنه كان متوعكاً فقد أكمل داود بن علي الخطبة فقال :
( لكم ذمة الله تبارك وتعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وذمة العباس رحمه الله أن نحكم فيكم بما أنزل الله ونعمل فيكم بكتاب الله ونسير في العامة منكم والخاصة بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم – ألزموا طاعتنا ولا تخدعوا عن أنفسكم فإن الأمر أمركم ، فإن لكل أهل بيت مصراً وإنكم مصرنا ، إلا وأنه ما صعد منبركم هذا " يقصد منبر الكوفة " خليفة بعد رسول الله إلا أمير المؤمنين علي وأمير المؤمنين عبد الله بن محمد " وأشار بيده إلى أبي العباس " فاعملوا أن هذا الأمر فينا ليس بخارج منا حتى نسلمه إلى عيسى بن مريم ) الحكم بما أنزل الله إذن كان وسيلته إلى قلوب الناس وبيعتهم وولائهم .. السير في العامة والخاصة بسيرة رسول الله كان ما عاهد عليه الناس وما بايعه الناس عليه . الحديث المختلق عن خلافة العباسيين حتى يسلموها إلى عيسى بن مريم كان السبيل إلى استسلام الرعية لقدرها ، والانشغال عن ظلم الولاة ، بصدق النبوءة المدعاة ..
هكذا بدأ أمر العباسيين ، وهكذا يبدأ أي أمر للحكم الديني وتحت نفس الدعاوي البراقة ، التي نسمعها كما سمعها الكوفيون بالأمس .. الحكم بما أنزل الله .. السير بسيرة رسول الله .. تطبيق شرع الله .. العدل .. البركة .. وهكذا كان ينتهي الأمر دائماً .. كما رأينا في أول عهد السفاح ثم كما سنرى بعد عهد السفاح ، ذلك الذي لا ينتهي الحديث عنه ، إلا بذكر سنة استنها ، ثم أصبحت قاعدة لمن تلاه من خلفاء بني العباس ، ونقصد بها عدم احترام العهود والمواثيق ، والفتك بالأنصار قبل المناهضين . وقد فعل السفاح ذلك في واقعتين شهيرتين
الأولى حين أعطى ابن هبيرة قائد جيوش مروان بن محمد آخر الخلفاء الأمويين ، كتاباً يحمل إمضاءه ويتعهد له بالأمان ، ثم قتله بعد أيام من استسلامه ، والثانية حين قتل وزيره أبا سلمة الخلال أحد مؤسسي الدولة العباسية في الكوفة ، وتعمد أن يتم ذلك على يد أبي مسلم الخراساني ، المؤسس الأول للدولة ، حيث لا يعرف تاريخ الدولة العباسية في عهد السفاح فضلاً إلا لرجلين ، أولهما أبو مسلم الذي أسس الدولة في خراسان وسلم الخلافة إلى السفاح ، وثانيهما عبد الله بن علي عم السفاح وقائد جيوش العباسيين في موقعة الزاب التي انتصر فيها على الأمويين انتصاراً نهائياً ، ويقال أن السفاح كان يسعى لقتل الاثنين ، وهو ما لا نجد دليلاً عليه في كتب التاريخ . غير أن أبا جعفر المنصور ، ثاني الخلفاء العباسيين ، والمؤسس الحقيقي للدولة العباسية ، والذي يحتل فيها موقعاً مناظراً لموقع معاوية في دولة الأمويين ، قام بذلك الواجب خير قيام ، فسلط أولاً أبا مسلم الخراساني لقتل عبد الله بن علي ، ثم تولى هو بنفسه قتل أبي مسلم ، ولم يشفع له صياح أبي مسلم : استبقني يا أمير المؤمنين لعدوك ، بل رد عليه : وأي عدو لي أعدى منك ؟
وليس للقارئ أن يتعجب حين يعلم أن أبا مسلم لم يفعل للسفاح ثم للمنصور إلا ( كل الخير ) ، وأنه كان صاحب الفضل الأول عليهما وعلى دولتهما ، لكن ذلك بالتحديد كان سبب قتل المنصور له ، فقد دخل عليه ولي عهده ( عيسى بن موسى ) فوجد أبا مسلم قتيلاً ، ( فقال : قتلته ؟ قال : نعم ، قال : إنا لله وإنا إليه راجعون ، بعد بلائه وأمانته ؟ فقال المنصور : خلع الله قلبك ! والله ليس لك على وجه الأرض عدو أعدى منه ، وهل كان لكم ملك في حياته ؟ ) هذا نموذج مثالي لما عرف باسم الميكيافيلية ، نسبة إلى ( ميكيافيلي ) ، والتي نوجز في تبرير الوسيلة بالغاية ، وتفصل في تطبيق ذلك على شئون الحكم وسيرة الحكام ، وتبدو جلية على يد المنصور ، الذي وطأ بأقدامه أعناق الرجال ، وتفرد بأسلوبه المميز في الحكم ، فهو يبدأ أولاً بالتخلص من أصحاب الفضل عليه ثم يتحول إلى المعارضين وهو لا يعرف إلا القتل وسيلة للقضاء على معارضيه ، ولا يعرف للعواطف سبيلاً ، ولا تعرف العواطف إليه طريقاً . ولأنه قوي لم يحترم إلا القوة ، ولعل هذا ما يفسر إعجابه بهشام بن عبد الملك ، ووصفه له بأنه ( رجل بني أمية ) ، ثم إعجابه الشديد بعبد الرحمن بن معاوية بن هشام ، والخليفة الأموي في الأندلس ، وعلى الرغم من هزيمة جيشه على يديه في أشبيليه ، بل ربما يسبب هذه الهزيمة التي لم تردعه ، ولم تمنعه من محاولة استمالته بالهدايا ، ووصفه قائلاً : (.. اقتحم جزيرة شاسعة المحل ، نائية المطمع ، عصبية الجند ، ضرب بين جندها بخصوصيته ، وقمع ببعض قوة حيلته ، واستمال قلوب رعيتها .. إن ذلك لهو الفتى الذي لا يكذب مادحه ) . بل يقال أن المنصور هو الذي سمى عبد الرحمن بصقر قريش ، ولما فشل في استمالته بالتودد أظهر وجهاً آخر لأسلوبه السياسي ، وهو الوجه الذي أظهره تشرشل في الحرب العالمية الثانية عندما أعلن أنه مستعد للتحالف مع الشيطان لهزيمة النازية ، وهو نفس ما فعل أبو جعفر ، حين تحالف مع ( شارلمان ) ثم مع ( ببين ) ملكي الفرنجة ، ضد عبد الرحمن الخليفة الأموي المسلم ، وهو التحالف الذي فشل في هزيمة عبد الرحمن ، ونجح في ذات الوقت في اقرار القاعدة المنصورية : افعل أي شيء .. اسلك أي سبيل .. تحالف مع أعدى الأعداء .. المهم أن تصل إلى غايتك .. وتنتصر على عدوك ، وخلال ذلك كله انس الإسلام ، وتغافل عن أحكام القرآن ، وتجاهل السنة ، وابتعد بقدر ما تستطيع عن سيرة الراشدين ، وتذكر فقط أنك ( سلطان الله في أرضه ) ( وصف المنصور لنفسه في خطبة شهيرة بالمدينة ) ( وظل الله الممدود بينه وبين خلقه ) ( التعبير الأدبي الشائع عند وصف الخلفاء في العصر العباسي الأول ) ، واستند في حكمك إلى حق بني العباس في الخلافة ، وليس إلى حق الرعية في الإختيار .
ولعل هذا المنهج هو ما قاد العلويين إلى مناهضة المنصور ، فما دام النسب هو الفيصل ، فهم أقرب إلى الحكم ، وأحق بالخلافة ، وقد دار حوار طريف بين المنصور من ناحية ، ومحمد العلوي المشهور باسم ( النفس الزكية ) وأخيه إبراهيم من ناحية أخرى ، ومبعث الطرافة أن الحوار كله يدور حول إثبات أحقية الخلافة بالنسب ، مع تجاهل كامل لما يسمى بالشعب ، أو ما كان يطلق عليه وقتها اسم الرعية ، فمحمد ( النفس الزكية ) وأخوه إبراهيم ، يريان أنهما من نسل علي وفاطمة ، وأنهما حفيدا الرسول ، وأنهما بهذا ولهذا أحق ، والمنصور يرى أن العم أقرب من ابن العم ، وأنه بذاك ولذاك أحق ، وأنا – بعد استئذان القارئ – أرى أنها مأساة أن أبايع حاكماً لمجرد أنه من نسل علي ، أو أناصر حاكماً آخر لأنه من نسل العباس ، وأتجاوز فأقول : أنه لو عاش للرسول من نسله ذكور ، ما بايعت حفيداً من أحفاده لمجرد انتسابه إليه ، فالنبوة لا تورث ، والصلاح لا ينتقل بالضرورة للأبناء ، ولا مانع أن يكون ( نوح ) نبياً ، وأن يكون ابنه في ذات الوقت ( عمل غير صالح ) .
غير أن الطريف في حوار المنصور والنفس الزكية ، أنه انتقل إلى الغمز، فالنفس الزكية يرد على عرض المنصور بالأمان بغمزة موجعة حين يذكر ( أي الأمانات تعطيني ؟ أمان ابن هبيرة ؟ أم أمان عمك عبد الله بن علي ؟ أم أمان أبي مسلم ؟ ) ، فيرد عليه المنصور غامزاً في الحسن " جد النفس الزكية " قائلاً : ( ثم كان الحسن فباعها معاوية بخرق ودارهم ، ولحق بالحجاز وأسلم شيعته بيد معاوية ، ودفع الأمر إلى غير أهله ) . والمنصور يشير إلى مبايعة الحسن لمعاوية أو بمعنى أدق إلى الصلح بينهما ، ذلك الصلح الذي أثار مشكلة بسبب بطء ( وسائل الاتصال ) في تلك الأيام ، فقد أرسل الحسن إلى معاوية يصالحه على شروط مالية . وفي نفس الوقت كان معاوية قد ارسل إلى الحسن صحيفة بيضاء ختم أسفلها وترك للحسن أن يشترط فيها ما يشاء ، ووصلت الرسالتان في وقت واحد ، وطمع الحسن فكتب في صحيفة معاوية شروطاً جديدة طلب فيها أضعاف ما طلب في رسالته ، وعندما التقيا تمسك معاوية بخطاب الحسن وتمسك الحسن بخطاب معاوية ثم تصالحا على خمسة ملايين هي أموال بيت مال الكوفة ( تاريخ الأمم والملوك للطبري، ج4 – ص121 – 125 ) .
ولسنا في مجال تقييم فعل الحسن ، وحسبنا أن نذكر أنه استراح وأراح ، أراح المسلمين من القتال ، وأراح عبد الله بن عباس ( الذي ما أن علم بالذي يريد الحسن عليه السلام أن يأخذه لنفسه حتى كتب إلى معاوية يسأله الأمان ويشترط لنفسه على الأموال التي أصابها فشرط ذلك له معاوية ) . وسوف يهنأ ابن عباس بما حصل عليه من مال البصيرة حتى نهاية حياته ، فقد قتل علي وتنازل الحسن وسمح معاوية ، وسوف يهنأ أيضاً الحسن بمال الكوفة حتى حين ، فسوف يتخلص منه معاوية بدس السم له حين يرشح يزيداً لخلافته ، ونعود إلى المنصور ، الذي لم يتحمل محاورة محمد طويلاً ، فقبض على أبيه وعمومته وكثير من أهله وحبسهم معذبين حتى الموت ، وهاجم محمداً بالمدينة وقاتله حتى قتله ، ثم هاجم أخاه إبراهيم في البصرة وقاتله حتى قتله ولم يكن المنصور في ذلك كله مدافعاً إلا عن الملك ، فقد ( ذكر أن المنصور هيئت له عجة من مخ وسكر فاستطابها ، فقال : أراد إبراهيم أن يحرمني هذا وأشباهه ) ( مروج الذهب للمسعودي – ج3 ص309 ) .
والشاهد هنا أن أحد الطرفين كان يدافع عن ( النسب ) ، وأن الطرف الآخر كان يدافع عن ( العجة ) ، وإن المسلمين في الفريقين كانوا يعتقدون أنهم يدافعون عن صحيح الإسلام ، دليلنا على ذلك ما حفلت به خطب الفريقين من آيات وأحاديث ووعد بالجنان ووعيد بسقر ، ولم يكن الأمر عسيراً بالنسبة لمحمد وإبراهيم فآيات الحكم بما أنزل الله موجودة وما أيسر أن ينتقل منها إلى الحديث عن شمائل الرسول ، وفضائل علي ، ولم يكن الأمر عسيراً أيضا على المنصور ، فما أكثر الأحاديث عن شق عصا الطاعة ، ومفارقة الجماعة ، وما أيسر الاستشهاد بآيات الإفساد في الأرض ، فقد روي عن المنصور أنه عندما تسلم كتاب انتصار جيشه على إبراهيم ، تلا هذه الآية : ( والقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة ، كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فساداً ، والله لا يحب المفسدين ) . ثم صعد إلى المنبر وقال : السعيد من وعظ بغيره ، اللهم لا تكلنا إلى خلقك فنضيع ولا إلى أنفسنا فنعجز، فلا تكلنا إلا إليك .
وهكذا أقنع أفراد جيش المنصور أنفسهم بأن الله نصر الحق بهم ، وسيجزي الله الشاكرين ، وأقنع من تبقوا من جيش محمد وإبراهيم أنفسهم بأنه اختبار من الله ، وبلاء إلى حين ، وسيجزي الله الصابرين ، وانطلق كل فريق قانعاً بما اعتقد أنه جزاؤه من عند الله ، ولم تنقل لنا كتب التاريخ خلال ذلك كله موقفاً مشهوداً لفقيه ، أو دفاعاً طلياً عن الحق من إمام من أئمة المسلمين ، وما أكثرهم في عهد المنصور ، فقد عاصره أبو حنيفة ، ومالك ، والأوزاعي ، وعمرو بن عبيد ، وسفيان الثوري ، وعباد بن كثير ، وجعفر بن محمد الصادق ، وغيرهم ، وما كان تعذيب المنصور لأبي حنيفة وحبسه وجلده ودس السم له في النهاية إلا لرفضه ولاية القضاء ، وما كان جلد المنصور لمالك وهو عاري الجسد غير مستور العورة تشهيراً به إلا لذكره حديثاً عن الرسول لم يعجبه ، وكلا الموقفين لا يصلحان نموذجاً للجهاد ، أو مثالاً على مناوأة الحاكم إن حاد ، أو دليلاً على أن الحق يعرف بالرجال ، وينصر بالرجال ، وينبري للدفاع عنه الرجال .. ولا بأس أن ننهي حديث المنصور ، بحديث ابن المقفع الذي أرسل للمنصور كتاباً صغير الحجم ، عظيم القيمة أسماه (رسالة الصحابة ) نصح فيه الخليفة بحسن اختيار معاونيه ، وحسن سياسة الرعية ، وكان في نصحه رفيقاً كل الرفق ، رقيقاً غاية الرقة ، ولعله كان ينتظر من المنصور تقديراً أدبياً ومادياً يليق بجهده ، ولعله لم يتصور أن مجرد إسداء النصح للمنصور جريمة ، وأن غاية دور الأديب في رأي المنصور أن يمدح ، ومنتهى دور المفكر أن يؤيد ، وأن عقاب من يتجاوز دوره كما فعل ابن المقفع ، أن يفعل به كما فعل بابن المقفع ، الذي قطعت أطرافه قطعة قطعة ، وشويت على النار أمام عينيه ، وأطعم إياها مجبراً ، قطعة قطعة ، حتى أكرمه الله بالموت في النهاية ولعله تساءل وهو يمضغ جسده بأمر أمير المؤمنين ، أي أمير وأي مؤمنين ، ولعله أدرك ساعتها ما نتمنى أن يدركه من يتنادون بالخلافة ، ويتغنون بالشورى ، ويهاجمون الحكام ( العلمانيين ) ويتصورون في الدولة الدينية ملاذاً ، وفي الحكم باسم الإسلام موئلاً ورحمة ، وفي التطبيق الفوري للشريعة وحدها عدلاً واستقامة ، وفي الديموقراطية جوراً وحكماً بالهوى ، ولعلنا نذكرهم أن المنصور وإن دخل التاريخ من باب الجبروت إلا أنه تركه من باب رجال الدولة العظماء ، وهو إن جار فبفتوى البعض من الفقهاء ، وخوف البعض وصمت البعض الآخر ، وهو إن قسا فبهدف بناء هيبة الدولة ، وأركان الحكم بمقاييس عصره ، وهو إن أسال الدماء أنهاراً ، فقد بنى بغداد والرصافة وحمى ثغور الدولة الإسلامية ، وأعاد التماسك إلى بنيانها ، وكانت حكمته البليغة نصب عينيه : " إذا مد عدوك إليك يده فاقطعها إن أمكنك ، وإلا فقبلها " .
وقد كان الرجل من القوة بحيث لم يـُقبـِل يد أحد ، وأورث ولده المهدي رعية مطيعة ، وثغوراً منيعة ، وأورثها المهدي إلى ولديه الهادي ثم هارون الرشيد وأورثها هارون الرشيد لأولاده الثلاثة الأمين فالمأمون فالمعتصم وأورثها المعتصم لولده الواثق ، وبحكم الواثق انتهى ما يعرف بالعصر العباسي الأول ، أكثر عصور الدولة الإسلامية نهضة وحضارة ، وإذا توخينا الصدق لزدنا ( وفقها وطهارة ) وإذا أردنا استكمال الصورة لأضفنا وفسقاً ومجوناً ، وليس فيما ذكرناه مبالغة أو سعي وراء سجع الكلمات أو طنطنة الروي ، وإنما هي الحقيقة لا أقل ولا أكثر ، فقد اجتمع كل ذلك معاً ، ففي النهضة والحضارة يزهو عصر المأمون ويتألق فكر المعتزلة ، وتزدهر الترجمات ويكفي أن نذكر في العصر العباسي الأول من أسماء اللغويين : سيبويه والكسائي ومن أسماء الأدباء والمؤرخين والشعراء : حماد الراوية والخليل بن أحمد ، والعباس بن الاحنف ، وبشار بن برد ، وأبو نواس ، وأبو العتاهية ، وأبو تمام ، والواقدي والأصمعي ، والفراء وغيرهم . أما في الفقه والطهارة فهناك : أبو حنيفة ومالك ، والشافعي ، وابن حنبل ، والأوزاعي ، والليث بن سعد ، وسفيان الثوري ، وعمرو بن عبيد ، وأبو يوسف ( الحنفي ) وأسد الكوفي ( الحنفي ) ، والزهري ، وإبراهيم بن أدهم الزاهد ، ونافع القارئ ، وورش القارئ ، وأبو معاوية الضرير ، وسفيان بن عيينة ، ومعروف الكرخي الزاهد ، وعلي الرضي بن موسى الكاظم ، وأحمد بن نصر الخزاعي ، وغيرهم ، أما الفسق والمجون فأبوابهما كثيرة ، وفنونهما شتى ، وهناك في البداية ما يمكن أن نسميه بالمناخ العام ، وهو الإطار الذي يسمح بالفسق ، ولا يستنكف المجون أو ما هو أكثر ، فقد أمتلأت عاصمة الخلافة بالحانات ، وانتشر شرب الخمور والغناء في مجالس الرعية ، ووجد الجميع مخرجاً طريفاً لما يفعلون ، فقد اشتهر عن فقهاء الحجاز إباحة الغناء ، واشتهر عن فقهاء العراق من أتباع أبي حنيفة إباحة الشراب ، فجمعوا بين فتوى الفريقين ، ولخصوا مذهبهم في قول الشاعر :
رأيه في السماع رأي حجازي وفي الشراب رأي أهل العراق
أو في قول ابن الرومي :
أباح العراقي النبيذ وشربه وقال حرامان المدامة والسكر
وقال الحجازي:
الشرابان واحد فحل لنا من بين قوليهما الخمر
سآخذ من قوليهما طرفيهما وأشربها لا فارق الوازر الوزر
ولعل بعض القراء يندهشون ، وربما يسمعون للمرة الأولى أن أبا حنيفة قد أباح أنواعاً من الخمور ، بل ولعلي أصارحهم بأن فتوى أبي حنيفة قد أجابت على سؤال حائر كان يدور في داخلي وأنا أقرأ عن الشراب والمنادمة في مجالس الخلفاء : هل وصل بهم التحلل من قيود الدين ، والخروج على قواعد الإسلام ، أن يجاهروا بشرب الخمر في مجالسهم ، دون أدنى قدر من الحفاظ على المظاهر أمام الرعية ؟ ولعل فيما عرضه الأستاذ أحمد أمين في كتابه ضحى الإسلام عن خلاف الفقهاء حول الخمر ورأي أبي حنيفة فيها ما يوضح الأمر للقارئ :
( ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل إلى سد الباب بتاتاً ، ففسروا الخمر في الآية السابقة بما يشمل جميع الأنبذة المسكرة من نبيذ التمر والزبيب والشعير والذرة والعسل وغيرها وقالوا كلها تسمى خمراً وكلها محرمة ، أما الإمام أبو حنيفة ففسر الخمر في الآية بعصير العنب مستنداً إلى المعنى اللغوي لكلمة الخمر وأحاديث أخرى ، وأدى به اجتهاده إلى تحليل بعض أنواع من الأنبذة كنبيذ التمر والزبيب إن طبخ أدنى طبخ وشرب منه قدر لا يسكر ، وكنوع يسمى " الخليطين " وهو أن يأخذ قدراً من تمر ومثله من زبيب فيضعهما في إناء ثم يصب عليهما الماء ويتركهما زمناً ، وكذلك نبيذ العسل والتين ، والبر والعسل . ويظهر الإمام أبا حنيفة في هذا كان يتبع الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود ، فقد علمت من قبل أن ابن مسعود كان إمام مدرسة العراق ، وعلمت مقدار الارتباط بين فقه ابي حنيفة وابن مسعود ، ودليلنا على ذلك ما رواه صاحب العقد عن ابن مسعود من أنه : كان يرى حل النبيذ ، حتى كثرت الروايات عنه ، وشهرت وأذيعت واتبعه عامة التابعين من الكوفيين وجعلوه أعظم حججهم، وقال في ذلك شاعرهم : من ذا يحرم ماء المزن خالطه في جوف خابية ماء العناقيد ؟ إني لأكره تشديد الرواة لنافيه ، ويعجبني قول ابن مسعود )
كان ما سبق هو المناخ العام أو الأرضية الممهدة للغناء والشراب وما يرتبط بينهما من لهو وقيان وغلمان ، أما اللهو فسمة العصر ، وأما القيان ففارسهم المهدي وولده الرشيد ، وأما الغلمان ففتاهم الواثق ، وسوف يأتي حديث كل منهم في موضعه ، غير إنا نتوقف قليلاً أمام فتاوى الخمر السابقة متأملين ، متعجبين من تشدد المعاصرين .
فالبعض منهم يصر على أن عقوبة الخمر أحد الحدود ، وهو في ظني يتجاوز الحقيقة بحسن النية ، والأرجح في تقديرنا أنها عقوبة تعزيرية ، نشترك في هذا مع رأي الشيخ محمود شلتوت وغيره ، ومن الواضح في فتوى أبي حنيفة ، ومذهب ابن مسعود ، أن العقوبة قاصرة على السكر البين ، أما شرب القليل من أكثر أنواع الخمور فلا عقوبة عليه ، وهنا يبدو منطقياً أن تسقط عقوبة البائع والمشتري والناقل والصانع .... إلى غير ذلك مما اجتهد بشأنه المتشددون وساقوا عليه الأدلة والأحاديث ، ولا بأس ما دمنا نتحدث عن المتشددين أن نذكر إصرارهم على الأخذ بالحد الأقصى للعقوبة وهو الجلد ثمانين ، وهم في ذلك يستندون إلى قياس لعلي ابن أبي طالب حين سأله عمر المشورة فقال : من سكر فقد هذى ، ومن هذى فقد افترى وحده ثمانون ، ومعنى هذا أن علياً افترض أن من يسكر يفقد عقله وأن من يفقد عقله يسهل عليه قذف الآخرين ، ومن هنا يمكن أن يجلد حد القذف أي ثمانين جلدة ، والغريب أننا لم نناقش هذا القياس أو نراجعه ، وشاع التسليم به وكأنه تنزيل من التنزيل ، بينما هو في تقديرنا قياس أقل ما يوصف به أنه غير دقيق ، فما أيسر أن نسوق على منواله أكثر من قياس وأكثر من عقوبة ، دون أن يملك من سلموا بالقياس الأول أن يعترضوا علينا .
فمثلاً نقول : من سكر فقد صوابه ، ومن فقد صوابه زنى ، أو قتل ، أو سرق ، وحده الرجم ، أو القتل ، أو القطع ، بل نستطيع أن نقول : من سكر فقد صوابه ، ومن فقد صوابه فلا عقاب عليه فيما فعل ، ويسقط القياس والاستدلال من أساسه . ولعل أغرب ما لاحظناه ، على عكس ما كنا نتصور ، أن السابقين كانوا أكثر تسامحاً ، ربما لأن الحياة كانت معطاءة ، وكان اتساع أبواب الاجتهاد أحد عطاياها ، وقد سقنا في الأمور المشتبهات رخصة التنقل بين فقه الحجاز وفقه العراق ، ونسوق أيضاً ما كان منتشراً حتى عهد أجدادنا القريب ، وهو تعدد الزوجات ، الذي لم ييسره الدين فقط ، بل يسرته أيضاً سبل الحياة ، وتوسع البعض فيه مثل الحسن بن علي ، الذي ذكر أنه تزوج سبعين وقيل تسعين ، وأنه كان يتزوج أربعاً ويطلق أربعاً ، والذي خشي الإمام علي من أن يفسد عليه القبائل بطلاق بناتها ، فكان يبادرهم صائحاً : يا أهل الكوفة لا تزوجوا الحسن فأنه رجل مطلاق ( تاريخ الخلفاء للسيوطي 191) . ولم يسمع أحد كلامه ، فقد طمع الكل أو تطلع إلى نسل ينتسب للرسول ، وبجانب ذلك كان هناك بابان للتمتع بالحياة ، والحياة في المتع ، باب منهما لم يختلف أحد عليه ، وإن جهله بعض المعاصرين أو صعب عليهم تصوره ، وباب آخر أثار ولا يزال يثير كثيراً من الخلاف . أما الباب الأول فهو التسري بالجواري ، وهو جانب من جوانب نظام الرقيق ، الذي ظهر الإسلام وهو جزء من إطار الحياة ، فلم ينكره أو يدنه ، وإنما حث على العتق ، وهو باب من أبواب الخير عظيم ، وجانب ذو شأن جليل من جوانب روح الإسلام ، تلك التي نجدها اليوم متناسقة مع عالم المساواة بين الجميع ، ومتناغمة مع إلغاء الرقيق عالمياً ، بينما لو توقفنا عند ظاهر النص لأنكرنا المساواة ، ولاستنكرنا الإلغاء ، ولأننا من أنصار الروح والجوهر ، فإننا نفسر موقف الإسلام من الرق بما نكرره ونعيده دون أن نمل ، وهو أن الدين لم ينزل من أجل عصر واحد ، وأن القرآن لم يتنزل لكي يناسب زمناً معيناً، وإنما نزل الدين وتنزل القرآن لكل عصر ولكل زمان ، وهو وإن سمح بالرق فقد تسامح مشجعاً العتق ، ومال إلى الحرية ، ولم يكن له أن يضيق بعصر أو يتوقف عند زمن ، وهو في سماحه بالرق أباح للمالك أن يتمتع بالجارية الأنثى ، وأن يتسرى بها ( أي يعاشرها ) وراعى أن ينسب الأبناء لآبائهم في الفراش . وكان للجواري مصدران ، أولهما الشراء ، وثانيهما غنائم الفتح ، وقد اتسع المصدر الثاني في صدر الدولة الإسلامية ، وتعددت موارده ، فظهرت الجواري المولدات ، الحور ، الروميات والفارسيات والحبشيات ، وكثر ( العرض ) بلغة حياتنا المعاصرة ، وتجاوز ( الطلب ) كثيراً ، حتى أصبح معتاداً في كتب التاريخ الإسلامي أن نقرأ أن فلاناً أهدى لغلامه جارية أو جاريتين ، وحتى ذكر المؤرخون أن الإمام ( علي ) وهو أحد أكثر الخلفاء زهداً قد ( مات عن أربع نسوة وتسع عشرة سرية رضي الله عنه ) ( البداية والنهاية لابن كثير م4 ج7ص244 . تاريخ الخلفاء للسيوطي ص176 ) .
وقد زاد هذا الرقم حتى أصبح بالعشرات في عهد أوائل خلفاء بني أمية ، ثم بالمئات في عهد يزيج بن عبد الملك ، ثم بالآلاف في عهد الخلفاء العباسيين ، حتى وصل الرقم إلى أربعة آلاف سرية كما ذكرنا في حديث المتوكل ، الذي ( وطئ الجميع ) خلال خلافته التي دامت نحو ربع قرن ، وهو رقم قياسي فيما نعتقد ، ويستطيع القارئ أن يجد مزيداً من الحديث عن هذا الباب في ( الأغاني ) للأصفهاني وفي ( أخبار النساء ) لابن قيم الجوزية ، و ( طوق الحمامة ) لابن حزم و ( الإمتاع والمؤانسة ) لأبي حيان التوحيدي ، وفي أقوال كثير من الخلفاء التي نذكر منها قول عبد الملك بن مروان ( من أراد أن يتخذ جارية للتلذذ فليتخذها بربرية ، ومن أراد أن يتخذها للولد فليتخذها فارسية ، ومن أراد أن يتخذها للخدمة فليتخذه رومية ) ( تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 221 )
ولعل هذا القول كاف لإفحام من يتصورون أن منهج ( التخصص ) منهج غربي معاصر، ولعلنا به أيضاً ننهي حديث الباب الأول من البابين اللذين أشرنا إليهما ، وهو الباب الذي وصفناه بأنه متفق عليه بلا خوف ، ومباح بلا شبهة ، وإن كنا نلمح ظاهرة إيجابية تتمثل في عتق الخلفاء لأمهات الأولاد ، وهي خطوة في طريق طويل انتهى بإنهاء الرق واستنكاره دون حرج ديني ودون خروج على روح الدين وجوهره كما ذكرنا . أما الباب الثاني المختلف عليه ، فهو ما عرف بزواج المتعة ، ذلك الذي أباحه الرسول في غزوتين ، ثم حرمه في حجة الوداع ، وكانت إباحته لما يمكن أن يطلق عليه اسم ( الضرورة القصوى ) في ظروف الغزو ، وكان تحريمه لكونه إذا أبيح بإطلاق كان أقرب للزنا منه للزواج . وهنا نتوقف قليلاً حتى لا يحدث للقارئ لبس ، فإباحته للضرورة في واقعتين ( في زمن خيبر وفي عام الفتح ) أمر لم يختلف عليه أحد ، وتحريمه في حجة الوداع أيضاً لا خلاف عليه ، ووصفه باقترابه من الزنا أكثر من كونه زواجاً رأي ابن عمر حين ( قال ـ فيما أخرجه عنه ابن ماجة بإسناد صحيح - : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرمها ، والله لا أعلم أحداً تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة " ( فقه السنة – الشيخ سيد سابق ) . وفي قول علي : لولا تحريم المتعة ما زنى إلا شقي ، وفيما نقله البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال : هي الزنا بعينه ( فقه السنة – ص43 ) . أما الحل للضرورة فهو منهج شرعي مقبول شريطة أن يكون تقدير الضرورة صحيحاً ، وليس أكثر من الرسول قدرة على التقدير أو صواباً في الحكم فهو الذي لا ينطق عن الهوى . وزواج المتعة باختصار شديد هو أن يعقد الرجل على المرأة لزمن محدد يتمتع فيه بها ( يوماً أو أسبوعاً أو شهراً .. ) وذاك لقاء مبلغ معين من المال ، وبمجرد انتهاء الأجل ينتهي العقد تلقائياً ، وفقهاء السنة جميعاً يجمعون على تحريمه تحريماً قاطعاً مستندين إلى حديث الرسول في حجة الوداع : ( يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع ، ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة ) ( فقه السنة – ص42 ) . ويجمع أغلب فقهاء السنة ( رغم وصفهم لهذا الزواج بالزنا ) على استبعاد عقوبة الرجم لوجود شبهة ناتجة ـ ( عما روي عن بعض الصحابة وبعض التابعين أن زواج المتعة حلال ، واشتهر ذلك من ابن عباس رضي الله عنه ) غير أن الأمر قد اختلف بالنسبة لأغلب فقهاء الشيعة حين أباحوه ، وفسروا نصاً قرآنياً بما يفيد الإباحة ، ونفوا أن تكون السنة ناسخة للقرآن ، ورد عليهم فقهاء السنة برأي آخر في تفسير النص ، وبمناقشات مستفيضة عن جواز نسخ السنة لأحكام القرآن مستدلين بحكم الرسول بالرجم في الزنا بينما النص القرآني لا يتجاوز الجلد ولم يرد حكم الرجم في القرآن على الإطلاق ، وهي قضية خلافية أخرى لا نريد أن نشغل القارئ بها ، وإن كنا نناشده أن يحلق معنا في سماء التخيل لهذا المجتمع ، ونقصد به المجتمع الإسلامي في صدر الدعوة ولعدة مئات تالية من السنوات ، حيث تعدد الزوجات هو القاعدة ، والطلاق يسير والزواج الجديد أيسر ، والبعض يقنع بالزوجات الأربع ولا يطلق منهن إلا نادراً وللضرورة ، والبعض الآخر يطلق أربعاً ليتزوج أربعاً دون أن يكون ذلك مدعاة لنقد ، أو سبباً لانتقاد ، والجميع يتسرى ومنهم الزاهد القانع بتسعة عشر ، وزهد( علي ) وورعه ونزوعه عن الدنيا واستعلاؤه عن مغرياتها لا يحتاج إلى سند ولا يعوزه دليل . ومنهم من يصل بالرقم إلى خانات العشرات والمئات والآلاف ، وقطاع كبير من المسلمين هم الشيعة يضيفون إلى ذلك حل زواج المتعة ذلك الذي يبيح للمسلم إن أعجبته امرأة أن يتزوجها يوماً أو شهراً أو بعض شهر ، وينفحها مقابل ذلك مبلغاً من المال ثم يفارقها دون إحساس بذنب أو تأنيب لضمير، هذا كله في إطار الحلال إن جاوزنا زواج المتعة لدى السنة ، أو أوردناه لدى الشيعة .
بينما تمتلئ كتب التاريخ عن أواخر العصر الأموي وأغلب العصر العباسي بأحاديث المغنيات والقيان والغلمان ، وهو ما نطرحه جانباً مقتصرين على الحلال ، متسائلين في هدوء هل هناك ضرورة للزنا في مثل هذا المجتمع ؟ ، وهل يعقل أن يدعي أحد في مثل هذا المناخ أن العقاب بالرجم فيه قسوة ؟ لا شك أن القارئ سوف يتفق معي ، وسوف يؤيدني في أن من يأتي الزنا بعد هذا كله ، ورغم هذا كله وفي ظل هذا كله ، مختل العقل بلا شك ، شاذ الطبيعة بلا مراء ، وربما أنصفناه فتصورناه ساعياً للانتحار، غير أن اختلاله أو شذوذه أو انتحاره لن يصل به إلى حتفه بسهولة أو في يسر ، فدون ذلك من الشروط ما يكاد يصل بعقوبة الزنا إلى الوصف بالاستحالة ، فلابد من توافر أربعة شهود عدول من الرجال ( ولا تقبل شهادة النساء ولا شهادة الفسقة ) ، وأن يشاهد هؤلاء فعل الزنا بما لا يتيسر إلا لمشارك للزناة في الفراش ، بل إن شئت الدقة في الغطاء ، مع تحرز آخر بأن يكون( قصير النظر ) حتى يشاهد عملية الزنا نفسها ( كالميل في المكحلة والرشاء " الحبل " في البئر ) .
ولو شهد ثلاثة منهم وشهد الرابع بخلاف شهادتهم أو رجع أحدهم عن شهادته أقيم على الشهود حد القذف وهو الجلد ، ولعل هذا هو السبب في أننا نعثر في قراءتنا لكتب التاريخ على إشارة ولو من بعيد إلى تطبيق لحد الرجم ، بل إن المرة الوحيدة التي كاد يطبق فيها الحد في عهد عمر ، انتهت ، بجلد الشهود ، على الرغم من تيقن القارئ ، بل وربما تيقن عمر نفسه من الفعل ، بدليل عقاب الفاعل بنزعه عن الولاية ، والقصة تستحق أن تروى ، لطرافة أحداثها ، ولكونها في ذات الوقت نموذجاً يثبت أن البشر هم البشر في كل عصر ، وأن عهد عمر نفسه لم يخل مما لو حدث اليوم لوصفناه بالكارثة ، ولارتفعت الأصوات في كل واد باستنكاره ، لأن الواقعة مست أحد ولاة الأمصار ، وهو ما يمكن أن يقاس عليه في عالم اليوم أحد الوزراء أو على وجه الدقة أحد نواب رئيس الوزراء . فقد كان ( المغيرة بن شعبة ) والياً على البصرة في عهد عمر ( سنة 17 هجرية ) وحدث منه أو قيل عنه ما يروي الطبري في تاريخه على النحو التالي ( تاريخ الطبري – ج3ص168 – 170 ) : ( عن شعيب عن سيف عن محمد والمهلب وطلحة وعمرو بإسنادهم قالوا كان الذي حدث بين أبي بكرة والمغيرة ابن شعبة أن المغيرة كان يناغيه وكان أبي بكرة ينافره عند كل ما يكون منه وكانا بالبصرة وكانا متجاورين بينهما طريق وكانا في مشربتين متقابلتين لهما في داريهما ، في كل واحدة منهم كوة مقابلة الأخرى ، فاجتمع إلى أبي بكرة نفر يتحدثون في مشربته فهبت ريح ففتحت باب الكوة فقام أبو بكرة ليصفقه ، فبصر بالمغيرة وقد فتحت الريح باب كوة مشربته وهو بين رجلي امرأة ، فقال للنفر قوموا فانظروا ، فقاموا فنظروا ثم قال اشهدوا قالوا ومن هذه ، قال أم جميل ابنة الأفقم ، وكانت أم جميل إحدى بني عامر بن صعصعة ( كذا في الأصل والمقصود إحدى نساء بني عامر ) ، وكانت غاشية للمغيرة وتغشى الأمراء والأشراف ، وكان بعض النساء يفعلن ذلك في زمانها ، فقالوا إنما رأينا أعجازاً ولا ندري ما الوجه ، ثم أنهم صمموا حين قامت ، فلما خرج المغيرة إلى الصلاة حال أبو بكرة بينه وبين الصلاة ، وقال لا تـُصل بنا ، فكتبوا إلى عمر بذلك ، وتكاتبوا فبعث عمر إلى أبي موسى فقال يا أبا موسى إني مستعملك ، إني أبعثك إلى أرض قد باض بها الشيطان وفرخ ، فالزم ما تعرف ، ولا تستبدل فيستبدل الله بك ، … ، ثم خرج أبو موسى فيهم حتى أناخ بالمربد ، وبلغ المغيرة أن أبا موسى قد أناخ بالمربد فقال والله ما جاء أبو موسى زائراً ولا تاجراً ولكنه جاء أميراً ، فإنهم لفي ذلك إذ جاء أبو موسى حتى دخل عليهم فدفع إليه أبو موسى كتاباً من عمر ، وإنه لأوجز كتاب كتب به أحد من الناس ، أربع كلم عزل فيها وعاتب واستحث وأمر، " أما بعد فإنه بلغني نبأ عظيم فبعثت أبا موسى أميراً ، فسلم ما في يدك ، والعجل " . وكتب إلى أهل البصرة : " أما بعد فإني قد بعثت أبا موسى أميراً عليكم ، ليأخذ لضعيفكم من قويكم ، وليقاتل بكم عدوك ، وليدفع عن ذمتكم ، وليحصي لكم فيأكم ثم ليقسمه بينكم ، ولينقي لكم طرقكم " .
وأهدي له المغيرة وليدة من مولدات الطائف تدعي عقيلة وقال إني قد رضيتها لك وكانت فارهة ، وارتحل المغيرة وأبو بكرة ونافع بن كلدة وزياد وشبل بن معبد البجلي حتى قدموا على عمر ، فجمع بينهم وبين المغيرة ، فقال المغيرة " سل هؤلاء الأعبد كيف رأوني ، مستقبلهم أو مستدبرهم ، وكيف رأوا المرأة أو عرفوها ، فإن كانوا مستقبلي فكيف لم أستتر ، أو مستدبري فبأي شيء استحلوا النظر إلى في منزلي ، على امرأتي ، والله ما أتيت إلا امرأتي ، وكانت شبهها . " فبدأ بأبي بكرة فشهد عليه أنه رآه بين رجلي أم جميل وهو يدخله ويخرجه كالميل في المكحله ، قال كيف رأيتهما ، قال مستدبرهما ، قال فكيف استثبت رأسها ، قال تحاملت . ثم دعا بشبل بن معبد فشهد بمثل ذلك ، فقال استدبرهما أو استقبلتهما ( ينفرد الطبري بذكر هذا الاختلاف ) ، وشهد نافع بمثل شهادة أبي بكرة ، ولم يشهد زياد بمثل شهادتهم ، قال رأيته جالساً بين رجلي امرأة ، فرأيت قدمين مخضوبتين تخفقان ، وإستين مكشوفتين ، وسمعت حفزاناً شديداً ، قال هل رأيت كالميل في المكحله قال لا ، قال فهل تعرف المرأة قال لا ، ولكن أشبهها ، قال فتـَنـَح . وأمر بالثلاثة فجلدوا الحد ، فقال المغيرة اشفني من الأعبد ، فقال : اسكت ، اسكت الله نأمتك ، أما والله تمت الشهادة لرجمتك بأحجارك ) ( في رواية أخرى بأحجار أحد ) . والرواية السابقة تقدم نموذجاً رائعاً ودقيقاً لمذكرة اتهام تفصيلية ، يبدو فيها سبب توافر الشهود مقنعاً ، وهو سبب فرضته ظروف البناء في عصر عمر، ويبدو فيه موقف المغيرة ضعيفاً ، ويبدو فيه وصف واقعة الزنا مثيراً ، ويبدو فيه أيضاً أن ظاهرة ( أم جميل ) كانت شائعة لدى علية القوم ، ويبدو فيه أيضاً أن الحد كان على وشك أن يقام لولا أن زياداً في اللحظة الأخيرة تلجلج في جزئية أو رثت شبهة حين قال أنه لم يتحقق من وجهها وإن كانت تشبهها .
ولنا أن نذكر للقارئ هنا معلومة طريفة وهي أن المغيرة بعد ذلك كان أحد قادة معاوية ، وأن زياداً بعد ذلك كان أحد قادة علي ، وأنه لما توطد الأمر لمعاوية ، تذكر المغيرة فضل زياد عليه حين تلجلج في الشهادة ، فتوسط له لدى معاوية ، الذي قبل الوساطة فنسبه إلى أبي سفيان وولاه البصرة ، ثم أضاف إليه الكوفة ، وذكر عنه التاريخ بعد ذلك ما ذكر ، من قسوة وبطش وإرهاب ، ونعود إلى حديث المغيرة أو حادثته ، ونتساءل ، ماذا يقول المتطرفون لو حدث من أحد نواب رئيس الوزراء أو الوزراء أو المحافظين ما حدث من المغيرة ، ألم يملأوا الأرجاء صراخاً عندما انتحرت إحدى الفتيات في منزل ملحن مشهور وتنادوا بأن مصر كلها قد تحولت إلى ماخور ، وأن العلاج كامن في تطبيق حد الزنا ، حتى تعود ( مصر الحانة ) إلى ( مصر الإسلام ) . وإذا كان أسلوب بناء المساكن في عهد عمر هو السبب في فضيحة المغيرة ، فماذا يكون الحال بالنسبة لمبانينا الحديثة ، التي لا يستطيع فيها الهواء أن يرفع شيش النافذة أو زجاجها ، ناهيك عن أبوابها ومغاليقها وأقفالها ؟
وإذا كان تلجلج أحد الشهود هو مبرر نجاة المغيرة ، فماذا يكون الحال في مواجهة شهود مهنتهم الشهادة ، ولو زادهم المغيرة خمساً لأقسموا أنه كان مستقبلهم وأنها كانت زوجته ، ولو أنقصهم خمساً لأقسموا أنه كان مستدبرهم وأنها كانت أم جميل . ونعود إلى تساؤلاتنا قبل أن يفاجئنا – أو يمتعنا – المغيرة بقصته ، ونضيف إليها جديداً ، راجين من القارئ أن يكون منصفاً في إجابته : هل بوسعنا أن نساوي في العقوبة بين من أتاحت له ظروف الحياة تعدد الزوجات وأتاحت له ظروف الفتح وانتشار الرق تعدد الجواري المستمتع بهن حتى بلغت العشرات ، وأتاح له اجتهاد ابن عباس أو مذهب التشيع زواج المتعة ، وبين شبابنا المعاصر الذي لا يستطيع أن يتزوج بواحدة لعجز ذات اليد عن دفع المهر ، وعجز إمكانيات المجتمع عن توفير مسكن الزوجية ؟ هل يعامل هذا على قدم المساواة مع ذاك ؟ ، ألا تشفع ظروف الحياة المعاصرة وقد ذكرنا طرفاً منها لشبابنا المعاصر ، كما شفعت ظروف المجاعة للسارقين في عهد عمر ؟ نحن هنا لا تدعو للزنا أو نبرر إباحته كما يحلو للبعض ممن لا يرى الحياة إلا من خلال رجل وامرأة والشيطان ثالثهما أن يتقول وأن يغمز عن جهل أو يلمز عن شبق ، ولا نفعل ما يفعله البعض ممن يؤثرون السلامة فيطالبون بإقامة حد الزنا وأن يكون الرجم للمحصن أو المحصنة عن ثقة كاملة منهم أنه حد مستحيل التطبيق ، ولأن الجريمة التي تعاقب عليها الشريعة أقرب إلى إتيان الفعل العلني الفاضح في الطريق ، بدأنا نواجه الأمر بالمنطق والعقل ، تماماً كما واجهه عمر في حد السرقة حين تجاوز ظاهر النص والعقوبة إلى العلاقة بين الأسباب والنتائج ، بل وأكثر من ذلك نفتح ملف حادثة مازالت ملء السمع والبصر ، وهي حادثة اغتصاب ستة من الشبان لفتاة كانت تجلس مع خطيبها في إحدى السيارات في منطقة نائية في ضاحية المعادي ، وقد أثبت تقرير الطبيب الشرعي أنها عذراء ، وقد قامت الدنيا ولم تقعد بسبب هذه الحادثة ، وانطلقت الأصوات مطالبة بتطبيق الشريعة وكأنها الحل ، وظلت الصفحات الدينية تردد على مسامعنا وأمام أبصارنا دون ملل أو كلالة مقولة واحدة متكررة : " طبقوا حد الزنا " ، " طبقوا حد الزنا " ، بينما تقرير الطبيب الشرعي ينفي واقعة الزنا من أساسها لأن البكارة شبهة تنفي تطبيق الحد بإجماع الفقهاء ، وقد حكم القضاة بإعدام خمسة من الشبان ، وعدل الحكم في الاستئناف إلى إعدام اثنين ، وأدلى المفتي السابق بحديث عن أن الحكم مطابق للشريعة واصفاً التهمة بأنها إفساد في الأرض ، ويعلم الله أنها ليست كذلك . فعقوبة الإفساد في الأرض تختص بالأموال وليس الفروج ، وهي عقوبة محددة في كل جزئية فيها ولها من الشروط ما لا ينطبق على هذه القضية بحال ، والنتيجة ببساطة أن القانون الحالي يعاقب على جرائم يعسر على الشريعة أن تعاقب عليها ، وبعكس احتياج المجتمع المعاصر بأقدر مما تفعل الشريعة ، ليس لعجز فيها ، معاذ الله ، بل لقصور من يتناولنها من هواة وصف القوانين الوضعية بالمخالفة لروح الإسلام ، والإصرار على التوقف أمام ظاهر النص لا جوهره ، هؤلاء الذين ترتعد فرائصهم حين نطالبهم بالتأسي بعمر ، وبالاجتهاد كما اجتهد ، وبتعطيل ظاهر النص إن كان تطبيقه مستحيلاً أو كان من الممكن بالقوانين السائدة مواجهة الجريمة والعقاب عليها واستئصالها إن أمكن ، وهو الهدف النهائي للإسلام ، والجوهر الحقيقي لروحه بل إني أتحداهم في هدوء ، وأعلن لهم أنني لن أكتب حرفاً بعد ذلك إن خسرت التحدي ، والحكم بيني وبينهم للقراء . أقول لهم : أمامكم في سجلات القضاء قضايا للزنا وملفات للآداب تعود إلى نصف قرن ، ادرسوها جميعاً وابحثوها جميعاً ، واعطوني مثالاً واحد لقضية واحدة يمكن أن يطبق فيها حد الزنا ، وبالطبع فلا عبرة هنا بالاعتراف ، لأن الاعتراف مقترن بالعقوبة المحدودة في القوانين السارية ، ولو تقررت عقوبة الرجم لما اعترف رجل أو امرأة بالزنا وهذه بديهية لا يختلف حولها أحد ، والعبرة كل العبرة ، بتوافر الشروط والحد ...
أعطوني قضية واحدة شهد فيها أربعة .. ورأى فيها الأربعة الميل في المكحلة ، أو الرشاء في البئر... ولا ضير في مزيد من التحدي الهادئ ... أجيبوني بعد الدرس والمراجعة والبحث عن سؤال أكثر بساطة وهو : ألا تعاقب القوانين الوضيعة على ما لا تطوله الشريعة في هذا المجال في ظل شروطها القاسية بل والمستحيلة ؟. أجيبوني من أين أتيتم بمقولة أن المجتمع يبيح الزنا ويدعو إليه ويحث عليه ويعفو عنه ؟ بينما المجتمع يطول بقوانينه المتجددة ما لا يطوله اجتهادهم القاصر ، إن كان ثمة اجتهاداً أصلاً ، ويحفظ للمجتمع حقوقه وهو عين ما يسعى الإسلام إليه ، ويصل بعقوبة هتك العرض ، وهي ليست الزنا بالضرورة ، إلى الحكم بالإعدام ؟ . وماذا يضيركم إذا أثبت المشرع واقعة الزنا في القوانين الحالية( بالمكاتيب ) أو ( بوجود غريب في المكان المخصص لنوم الحريم في البيوت المسلمة ) ، أليس هذا أقرب إلى إمكانية إثبات الواقعة من شهود الميل ( المرود ) والرشاء ( الحبل ( بفتح الحاء وسكون الباء ) ؟ وماذا يفزعكم في إعطاء القوانين الحالية للزوج حق إقامة الدعوى أو عدم إقامتها ، أليس في هذا حفظ لسمعة البيوت وأسرار الأسر وستر للعورات ، ودرء للحدود بالستر ؟ ، وهب أن زوجاً علم ثم عفا ، قبولاً منه لنوبة الزوجة ، أو حفاظاً منه على سمعة أولاده وبناته في مدارسهم أو مجتمعاتهم ، أليس هذا أقرب إلى روح الإسلام من فضح الزوجة وتدمير سمعة الأولاد وإنهاء مستقبل البنات وسمعتهن إلى الأبد ؟ أم أن الإسلام لا يكون إسلاماً في عرفكم إلا إذا جلد وفضح ورجم ودمر ، وتنكرونه إذا عفا وتسامح وستر ، ثم لماذا لا تتفقون على كلمة سواء كان قبل أن تواجهونا بالعموميات ، والشعارات ، الاتهامات ، فالأسئلة عديدة وليس هذا مجالها ، لأننا لسنا بصدد بحث فقهي ، ومثالها التساؤل حول علاقة السنة بالقرآن ، وإمكانية نسخ السنة لنص قرآني ثابت في أحد الحدود ، وهذا كله يفتح باباً واسعاً للاجتهاد ، وللنقاش ، وهو على كل الأحوال لا يفتح نافذة واحدة للتشكيك في الإيمان أو الحكم بالكفر أو الاتهام في العقيدة ، وما كان أغناني عن هذا الحديث . لولا أنني مؤمن بأن الإسلام على مفترق طرق ، وأنه لابد سائر إلى حيث يريد الله الرحمة لعباده ، والانتصار لإسلامه والاستمرار لعقيدته ، وأن الإسلام لن يضار بالمتعصبين إلا إلى حين ، ولن يختلف بالجامدين إلا إلى حين ، ولن يشارك في الحياة أبداً بالمرتعدين عن قصور في الفهم أو عجز في الاجتهاد أو جمود في التفكير، وأننا في حاجة إلى أن نقبل على الحياة بالإسلام ، لا أن نهوى عليها بالإسلام ، وأننا في حاجة إلى أن نحافظ على الإسلام العقيدة ، لا أن نكتفي بحفظ الإسلام النصوص ، وأننا في حاجة إلى أن نخترق الحياة بالإسلام ، لا أن نخترق الحياة بالإسلام ، والإسلام بحمد الله أقرب إلى الحياة من يبتعدون عنها بالقول ، وينهلون منها بالفعل ، ويحلمون بها طوع بنانهم بالحكم ، ويفزعونها ويفزعون إليها بخلط أوراق الدين بالسياسة ، والسياسة بالدين ، والعنف بالموعظة ، والموعظة بالطمع ، والطمع بالمزايدة ، والمزايدة بشراء الذمم ، وأبواب شراء الذمم في حياتنا شتى ، فقد عرفنا في السنوات الأخيرة مناصب المستشارين للبنوك ( الإسلامية ) ، والشركات ( الإسلامية ) ، ورحلات الشتاء والصيف للدول ( الإسلامية ) ، للتعرف على مسار التجربة ( الإسلامية ) ، وللحصول على بعض الأموال الزكاة لتوزيعها على ( المسلمين ) في مصر ، أو إنفاقها على أمور الدعوة ( الإسلامية ) .
ونحن في هذا لا نتحدث من فراغ ، أو عن هين من المال أو يسير، ودليلنا نأخذه من ألسنتهم ، فقد صرح حافظ سلامة للصحف بأنه جمع لبناء مسجد النور مليون ونصف مليون جنيه من تبرعات ( المسلمين ) في الخليج في رحلة له إلى هناك لمدة أسبوع ، واستنكر أحد كبار رجال الدعوة ما نشره الأهرام الاقتصادي عن أنه حصل على عشرين ألف دولار سنوياً كمكافأة استشارية وطالب بتصحيح ما نشر لأن المبلغ ثلاثون ، وإذا أمطرت سماء ( الدعوة ) ألوفاً بالعشرات في الداخل ، وبالمئات في الخارج ، فلا جناح عليهم إن هاجمونا ، ولا تـثريب عليهم إن كفرونا ، ولا بأس عليهم إن قاتلونا ، ولا غرابة إن خرج علينا بعض الساسة بالنقد تملقاً ومزايدة ، ولو شئنا الاستطراد في هذا الباب لأفضنا ، لكنا نشعر أننا أرهقنا القارئ وربما أصبناه بالملالة ، فقد أطلنا في قراءتنا الجديدة للأوراق القديمة ، ووجدنا أنها وثيقة الصلة بما نراه في أيامنا المعاصرة . ولعلنا نمسك عن الاستطراد على وعد بكتابات قادمة ، نتحدث فيها عن الرشيد وما أدراك ما الرشيد ، وعن المأمون وما أدراك ما المأمون ، وعن المعتصم وما أدراك ما المعتصم ، أما الواثق ، وهو آخر خلفاء العصر العباسي الأول ، فلا أحسب أنني أستطيع مع سيرته صبراً ، ولا أحسب أن القارئ سوف ينسى بسهولة ما سأذكره عنه ، فقد فتح باباً جديداً من أبواب الخلافة ( الإسلامية ) ، وسلك مسلكاً فريداً من مسالك الخلفاء أو أمراء المؤمنين ، وخلد سيرته نثراً وشعراً ، وحكم قرابة الست سنوات منتقلاً من غلام إلى غلام ، ونعيدها حتى لا يشك القارئ في صحة ما ذكرناه أو يتصوره خطأ مطبعياً نقول : من غلام إلى غلام ، فقد كان عاشقاً صباً للغلمان ، ملكوا وجدانه ، وأذابوا مشاعره تولهاً وصبابة ، وكان منهم غلام ( مصري للأسف ) ، اسمه ( مُـهَج ) ، لعب بعواطف الواثق كما شاء ، وتملك مشاعره وتلاعب بوجدانه كما يريد ، إن رضى عنه استقامت أحوال الدولة واستقر شأن الحكم ، وإن تدلل عليه أو صده فالويل كل الويل للمسلمين ، والثبور وعظائم الأمور لمن يشاء حظه العاثر أن يلقي الواثق أو يقف أمامه أو يحتكم إليه . ولعل من يرددون دون وعي أو ملل، أن حضارة الغرب قد أباحت الشذوذ الجنسي ، يتيهون الآن بأن دورنا لم يقتصر أبداً على النقل من الغرب ، لأنه لو صح ما يدعون ، وهو غير صحيح ، لانعقدت لنا الريادة ، وكان لنا قصب السبق دون شك ، وهل لدى الغرب حاكم مثل الواثق ، وهل في تاريخهم كله خادم مثل مهج ، يخلب لب الخليفة ، فيصرفه عن شئون الدنيا ، ناهيك عن شئون الدين ، فينصرف إليه ، وتجود قريحته بالشعر عليه ، فيردد على إيقاع أيدينا وهي تضرب كفاً بكف :
مهج يملك المهج بسجي اللحظ والدعج
حسن القد مخطف ذو دلال وذو غنج
ليس للعين إن بدا عنه بالحظ منعرج ( تاريخ الخلفاء للسيوطي. ص342 )
ويعرف مهج قدر نفسه عند الخليفة الواثق ، فيبتدره يوماً في الصباح ، وهو جالس بين حاشيته ، ويمضي إليه متـثـنياً ، منكسر النظرة ، مترنح الخطوة ، مترجرج الأعطاف ، ويناوله ورداً ونرجساً ، وتصور أنت أيها القارئ حال الواثق أمام كل هذا الهول ، واعذره إن استخف به الطرب فنسى الحاشية والمجلس ، وأنشد وعيناه ترنوان إلى مهج :
حياك بالنرجس والورد معتدل القامة والقد
فألهبت عيناه نار الهوى وزاد في اللوعة والوجد
أملت بالملك له قربه فصار ملكي سبب البعد
ورنحته سكرات الهوى فمال بالوصل إلى الصد
إن سئل البذل ثنى عطفه وأسبل الدمع على الخد
غر بما تجنيه ألحاظه لا يعرف الإنجاز للوعد
مولى تشكي الظلم من عبده فأنصفوا المولى من العبد
ويا سبحان الله ؛ ما أشعر الواثق وما أرق ألفاظه وما أدق وصفه للحظة العشق العظيم ، حين يسيل دمع مهج علي خده ، فلا يدري الواثق أهو دمع الهوى أم دمع الصد ، وماله لا يفعل ذلك ، وهو صاحب القد المعتدل ، المترنح في خطوة بسكرات الهوى ، ذلك الذي يعرف وصله من صده ، الظالم لعبده ( خليفة المسلمين ) ذلك الذي يستنجد بالرعية أن تنصفه من مولاه ( مهج ) ، المغرور بسهام ألحاظه ، المنكر للوعد دائماً ، أما الوعد فيسير إدراكه على خيال القارئ ، وعسير إدراكه على الأتقياء المصدقين للمتنادين بعودة الخلافة ، الخالطين بين حلم رائع في خيالهم ، بثـته عقيدة عظيمة ، وبين حقيقة مفزعة تكشفها لهم صفحات التاريخ ، وألحاظ مهج ، وخلاعة الواثق ، وفقه معاصريه من الجبناء وجبن معاصريه من الفقهاء . هذا عن مهج حين يرضى ، فماذا عنه إن غضب .. يا ألطاف الله ، حدث ذلك يوماً ، حين فقد الواثق عقله فأغضب مهج ، وفي اليوم التالي طار لب الواثق ، وتعطلت مصالح الدولة ، وخشي كبار الدولة أن يدخلوا على الواثق في حالته تلك ، ولم يكن لأحد أن يتوقع خيراً إن لاقاه أو حاكاه ، وأدرك الجميع أن السر لدى مهج ، فدسوا عليه بعض الخدم ليسألوه فأجابهم ( والله إنه – يقصد الواثق – ليروم أن أكلمه من أمس ، فما أفعل ) . يا للكارثة ، ويا لصعوبة ما أعانيه بحثاً عن ألفاظ تليق بجلال الموقف ورهبته ، وعذاب الواثق وغضبته ، وقد نقل إليه حديث مهج فأنشد من جديد قائلاً :
يا ذا الذي بعذابي ظل مفتخرا ما أنت إلا مليك جار إذ قدر
ا لولا الهوى لتجارينا على قدر وإن أفق منه يوما ما فسوف ترى
ولحسن حظ مهج ، وسوء حظ الطالبين بعودة الخلافة لم يفق الواثق أبداً ، بيد أن البعض قد يتصور أن عمر خلافة الواثق قد ضاع على مهج وأمثاله ، لكن ذلك لم يكن صحيحاً ، فقد كان للواثق وجه آخر ، يحلو له أن يخرج به على الرعية ، ويبدو فيه حامياً لذمار العقيدة ، ومناضلاً من أجل صحيح الدين ، فقد انتصر للمعتزلة كما فعل والده المعتصم ، الذي عذب ابن حنبل لقوله بأن القرآن ليس بمخلوق ، ويروي عن الواثق أنه أحضر أحمد بن نصر الخزاعي أحد كبار رجال الحديث في التاريخ الإسلامي ، من بغداد إلى سامرا ، مقيداً في الأغلال ، وسأله عن القرآن فقال : ليس بمخلوق ، وعن الرؤية في القيامة فقال : كذا جاءت الرواية ( فثار الواثق ودعا بالسيف ، وقال : إذا قمت فلا يقومن أحد معي ، فإني أحتسب خطاي إلى هذا الكافر الذي يعبد رباً لا نعبده ، ولا نعرفه بالصفة التي وصفه بها ، ثم أمر بالنطع فأجلس عليه وهو مقيد ، فمشى إليه ، فضرب عنقه ، وأمر بحمل رأسه إلى بغداد ، فصلب بها وصلبت جثته في ( سر من رأى ) ، واستمر ذلك ست سنين إلى أن ولي المتوكل ، فأنزله ودفنه ولما صلب كتبت ورقة علقت في أذنه ، فيها : هذا رأس أحمد بن نصر بن مالك ، دعاه عبد الله الإمام هارون إلى القول بخلق القرآن ونفي التشبيه ، فأبى إلا المعاندة ، فعجله الله إلى ناره ) . وتأملوا معي التناقض بين حديث مهج وحديث الخزاعي ، وفاضلوا بين مصير مهج ومصير الخزاعي ، وقارنوا بين الواثق وبين كثيرين ممن نعرفهم ونسمع منهم ، ونرى لهم كما رأينا للواثق وجهين لا صلة بينهما ولا رابطة ، فهم يقضون ليلهم بين الكأس والندماء ، وما أن يسفر الصبح حتى ينطلقوا إلى صفحات الصحف ومنتديات السياسة ، ينادون بالتطبيق الفوري للشريعة ، فإذا سألتهم ابتسموا ، وأنكروا عليك جهلك بالسياسة وفعال الساسة ، وكتموا في أنفسهم رأيهم فيك ، وهو أنك غر حديث التجربة ، لن تتعلم بعد كيف تتعامل مع الشارع المصري ، فتقول شيئاً وتعني شيئاً ثانياً وتفعل شيئاً ثالثاً .. وإذا كان الواثق قد تألق في صولاته بين الغلمان ، وإذا كان يستحق بجدارة أن يوصف في جولاته بأنه فارس الميدان ، فإنه – إنصافاً له لم يكن فارس الميدان الوحيد ، فقد ذكرنا طرفاً عن التلوط في عهد الوليد بن يزيد ، ولم نذكر شيئاً عن عهد الأمين( ابن الرشيد ) الذي ( ابتاع الخصيان وغالى بهم وصيرهم لخلوته ورفض النساء والجواري ) ( تاريخ الخلفاء للسيوطي – ص301 ) ، وكما تعلق قلب الواثق بمهج تعلق قلب الأمين بكوثر ، وقال بعض الشعراء عن عصره :
أضاع الخلافة غش الوزير وفسق الأمير وجهل المشير
لواط الخليفة أعجوبة وأعجب منه خلاق الوزير
فهذا يدوس وهذا يداس كذاك لعمري خلاف الأمور
ولما هاجم المأمون الأمين ، ( خرج كوثر خادم الأمين ليرى الحرب ، فأصابته رجمة في وجهه ، فجعل الأمين يمسح الدم عن وجهه ثم قال : ضربوا قرة عيني ومن أجلي ضربوه أخذ الله لقلبي من إناس حرقوه ولم يقدر على زيادة فأحضر عبد الله التيمي الشاعر فقال له : قل عليهما ، فقال : ما لمن أهوى شبيه فبه الدنيا تتيه وصله حلو ، ولكن هجره مر كريه من رأى الناس له الفضل عليهم حسدوه مثل ما قد حسد القائم بالملك أخوه فأوقر له ثلاثة بغال دراهم . وهكذا انشغل الأمين عن الحرب ، وعن سقوط حكمه ، بجرح حبيبه وخليله كوثر ، ذي الوصل الحلو ، والصد المر ، والهجر الكريه ، وماله لا يفعل ذلك وهو قائل في وصف كوثر : ما يريد الناس من صب بما يهوى كثيبكوثر ديني ودنياي وسقمي وطبيبي أعجز الناس الذي يلحي محبا في حبيب يا حبيبي !! يا أمير المؤمنين ، ما أرقك وما أطيب وصلك ، لولا أنها خلة تشين في أي عرف ، ناهيك عن أي دين ، ولولا أن عشق الغلمان ، يقود إلى بنت الحان ، وإلى الطرب بالألحان ، وإلى القول بما نمسك عنه ، ونفزع منه ، غير أن رحمة الله قد وسعت الأمين في دنياه من باب آخر فلم تذكر لنا صفحات التاريخ أن فقيها أفتى بحل قتله ، أو حرمة ما أتاه ، أو إفك ما فعله ، غاية ما في الأمر أنهم قالوا عنه شعراً بعد وفاته ، ربما بعد تيقنهم من سيرة المأمون المختلفة ، وإتيانه للأمور من قبل ، واهتمامه بشئون الحكم وعمارة البلدان ، وليس بالخمر والغناء والغلمان ، فقالوا في الأمين غداة وفاته : لم نبكيك ؟ لماذا ؟ للطرب يا أبا موسى وترويج اللعب ولترك الخمس في أوقاتها حرصا منك على ماء العنب وشنيف أنا لا أبكي له وعلى كوثر لا أخشى العطب لم تكن تصلح للملك ولم تعطك الطاعة بالملك العرب وهكذا ، أدرك الشعراء فقط بعد موت الأمين ، أنه لم يكن يصلح ، وتنادوا بأنه لم يبايع بالطاعة من العرب ، على خلاف الحقيقة ، وتذكروا أنه كان يترك الصلوات الخمس ، وكان متفرغاً للطرب ولماء العنب ، وليس هذا بغريب علينا ، فحتى في عصرنا هذا لا يتذكر البعض مثالب الحكام إلا بعد وفاتهم ، واستقرار الحكم لمن يليهم ، ولعل القارئ يشاركني في أن حكامنا أرحم ، فليس بين مستشاريهم كوثر أو شنيف ، أو مهج أو وصيف ، وليس في أقوالهم وصل للغلمان ، أو وصف لبنت الحان ، وليس في علاقتهم بوزرائهم والمشيرين عليهم ما شاب علاقة الخلفاء العباسيين بوزرائهم ومستشاريهم ، ومعذرة لهذا القاموس الكريه ، فإناء الخلافة ينضح على أوراقنا بما فيه ، بل إن شئنا الدقة إناء العصر ، ويكفينا أن نذكر أن الأمين كان متبعاً ولم يكن مبتدعاً . " فأبو حيان التوحيدي يحدثنا أنه كان في بغداد خمسة وتسعون غلاماً جميلاً يغنون للناس ، وأنه كان صاحب صبي موصلي مغن ، ملأ الدنيا عيارة وخسارة ، وافتضح أصحاب النسك والوقار ، وأصناف الناس من الصغار والكبار ، بوجهه الحسن ، وثغره المبتسم ، وحديثه الساحر ، وطرفه الفاتر ، وقده المديد ، ولفظه الحلو ، ودله الخلوب .. يسرقك منك ، ويردك عليك .. فله حالات ، وهدايته ضلالات ، وهو فتنة الحاضر والبادي " . كما يحدثنا عن علوان غلام ابن عرس ، فإنه إذا حضر وألقى إزاره ، وحل أزراره ، وقال لأهل المجلس : اقترحوا واستفتحوا فإني ولدكم ، بل عبدكم لأخدمكم بغنائي ، وأتقرب إليكم بولائي ،... لا يبقى أحد من الجماعة إلا وينبض عرقه ، ويهش فؤاده ، ويذكو طبعه ، ويفكه قلبه ، ويتحرك ساكنه ، ويتدغدغ روحه الخ "
وتفننوا في أسماء الغلمان بما يدل على مقصدهم، فسموا بـ " فاتن " و" رائق " و " نسيم " و " وصيف " و " ريحان " و " جميلة " ، ( هكذا بأداة التأنيث ) ، و " بشرى " ( ظهر الإسلام – أحمد أمين الجزء الأول – ص132 نقلاً عن الامتناع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي ) :